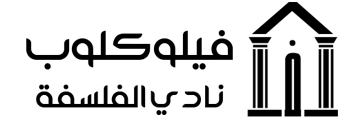شلايرماخر : الدين كتجربة حدسية ذاتية – ابراهيم ماين
شكل التاريخ الفكري للبشرية حمأة الصراع التي تناحرت فيها الفلسفة مع الدين ، ففي الأزمنة البعيدة انفرد الدين بالكشف عن نواميس هذا الكون الفسيح ، تلك النواميس التي كانت تشعل ضرمة الخوف و الفزع في نفس الإنسان نتيجة الجهل بالقوانين التي تحكمها و بسبب عجزه و ضعفه أمام هول العالم حوله و ما يحيق به من ظواهر ، فكان الدين و الحالة هذه بمثابة القبس الذي أضاء على الإنسان أرجاء هذا الكون العاتم ، و قدم له تفسيرات استطاع بفضلها أن يتحرر من قيد الخوف ، هذه التفسيرات قد انتشلته من الضلال و التيه و انتزعته من براثن الشقاء و المقاساة ، هذا الدين الذي أومض من قرارة الإنسان ، من صميم مشاعره و صلب انفعالاته ، كيف له ألا يكون متنفس يروح عنه في عالم لا متنفس فيه ، كيف له ألا يضفي معنى على حياته . و الحقيقة أن الدين ككيان ذو جذور عميقة قد ارتبط – من منطلق تفسير الظواهر الغريبة عن العقل الفتي و إظهار ما تخفى من الوجود – بوضع الإنسان في العالم ، و لم تكن له أبعاد أخرى غير هذه ، و لهذا السبب ، سرعان ما تعرت حقيقة الدين ببزوغ فكر جديد حشر نفسه في وغى فهم العالم ، هو الفكر الفلسفي الذي ظهر بمبادئ و أسس فريدة تؤطر العقل و توجهه الى مناطق الصواب و المنطق و تنحيه عن مناطق الخطأ و الزلل . إلا أن هذا الفكر لم يلق استحسانا كبيرا من لدن العامة من الناس الذين لا يزالون متشبثين بالحبل الضامن للراحة و الاطمئنان ، الى أن أصبحت الفلسفة تجود بتفسيرات عقلية تجابه بها الدين و تغير نظرة الإنسان الى العالم ، نظرة تخلو من المشاعر الفياضة التي تتضرع دوما لاستعطاف الطبيعة القاسية المجهولة قوانينها ، إن الفلسفة بهذا المعنى لم يكن حضورها في الساحة إلا من أجل التملص من مشاعر تمزق الإنسان تمزيقا يكاد معها أن ينسج في عقله تبصرا يسوقه الى الشك و الدهشة ، بالتالي الى الدأب وراء الحقيقة التي كانت تتحجب بستار الخوف و الهلع ، إذن ، فما دامت الفلسفة قد أدلت بدلوها و أنتجت و صنعت و أبدعت و نفعت ، باعتمادها على فكر عقلي حر ينضب بالحياة و الوجود ، و ما دام الدين ملاذ الخرافات و الأساطير باحتكامه للعاطفة دون العقل ، و اليقين المطلق الكابح لملكة التفكير دون البحث عن الحقيقة ، فلماذا لم تقدر الفلسفة على أن تعتلي سدة الحكم في هذا العالم ؟ لماذا لا تعتبر مرجعا لتوليد المعنى ؟ ألا يمكن أن نقول أن الدين قد انحسر دوره و انكمشت قوته ؟ ألا يمكن أن نقول أن الإنسان لم يعد بحاجة للدين في العصر الراهن ؟
يسود الحياة في العالم المعاصر نضوب المعنى و تفشي العدمية و استفحال العبث و شيوع التشاؤم و انطفاء التفاؤل و خمود الأمل ، حياة لا يسعنا إلا أن نصفها باللاحياة ، تفتقد لذاتها ، و تذبل فيها أوراق المعنى ، بعد أن أخفقت المتع الحسية عن أن تملأ الفراغ الروحي الذي أحدث فجوة عميقة بين الإنسان و الحياة ، شرخت فتوقا بجانبها تدعو الى التأهب لسقوط البنيان ، و أي بنيان ، بنيان الإنسان بما هو ” داخل ” أو بما هو نفسه في داخله ، ذاك الشيء الذي يجعله يتوشح بالدفء و السكينة ، فأين نجد هذا الشيء ؟ و ما السبيل لسد الفجوة و رتق الفتق ؟
يضمد الدين الجراح التي يتسبب بها الوجود للإنسان ، و يصد سيل الحيرة الفياض التي ما فتئت تداهمه في كل لحظة سكون و تأمل ، بما تثنيه هذه اللحظة من انزواء على الذات و اختلاء بها ، لذلك يجب أن نفهم من الدين جانبين أساسيين ، الأول أن الدين ينتج المعتقدات و الطقوس والعبادات … هذا دين مرتبط بالجماعة ولا يمكن تصوره في سياق فردي ، و البحث فيه يقودنا الى مباحث علمية لا صلة للفلسفة بها . الثاني هو الدين الذي تتخصب به الذات و تغتني به الروح جوانيا ، فالذات كي يتحقق وجودها تشرع في اكتساء تجاربها الخاصة التي تصاحبها في جل لحظات الوحدة و التفرد ، حين ينتابها القلق و الاغتراب، حين يساورها التأفف و التأوه ، حين يخامرها السأم و الغثيان ، و في الأخير تفقد المعنى . إذ أن الحياة الانسانية لا تبدأ إلا عندما توجد الذات الشخصية ، و هذه الذات لا تتحقق من دون الفعل ، فالوجود الإنساني لا يصل الى الامتلاء إلا بالفعل وحده[1] . و لأن الأمر كذلك ، فإن الدين وحده الكفيل بأن يتسلل الى جوانية الذات ليبدد كل ما ينتابها من مشاعر السوء ، لكونه منبعثا من قعر الذات نفسها . بناء على هذا ، فإن مثار الحديث سيكون حول الدين باعتباره تجربة ، و التجربة باعتبارها حاصلة في داخل الذات لا تربطها سوى علاقة اغتراب عن الواقع ، و الواقع بطبيعته مشترك بين جميع الناس ، و لكن التجربة الدينية يختص بها كل فرد على حدة ولا يمكن لأي شخص أن يطلع على خبايا تجربة شخص آخر . و قد استلهمت فلسفة الدين هذه التجربة الدينية و حاولت أن تسبر أغوارها و تفهم مغزاها ، لذلك نجد أحد الفلاسفة اللاهوتيين الألمان فريديريك شلايرماخر يتعرض بالمناولة موضوع التجربة الدينية ، و أصبغ الدين بطابع جديد ينضوي تحت مفهوم الذاتية و اقتلعه بالتالي من أرضية النقاش الحاد التي جعلته محط انتقاد و هجوم من قبل المثقفين المعادين لكل نزعة دينية ، فالدين عنده ليس منظومة من الخرافات و التقاليد و المعتقدات اليقينية ، و إنما هو ما يختلج النفس و يهمد فيها . فكيف إذن يمكن أن نفهم الدين داخل الذات ؟ و ما التفرقة التي يعقدها شلايرماخر بين الدين و الفلسفة ؟ و كيف يمكننا أن نتبنى موقف شلايماخر لعيش حياة يتغلغل فيها الدين داخل شرايين الإنسان دون أن يسفر ذلك عن تطاحنات و اقتتالات باسمه ؟ و انطلاقا من الإجابة عن هذه الأسئلة ، سنحاول أن نحصي نتائج الأخذ بالدين كتجربة ، و نتائج الأخذ بالدين كعقيدة .
جرى في الفلسفة الحديثة تغليب العقل على حساب الدين ، و سيادة الذات المفكرة على كافة الأنماط العقدية و الدينية ، بداية مع ديكارت الذي وضع جميع معتقداته موضع شك و تساؤل ، وصولا الى اسبينزا الذي اعتبر الدين منفلتا من قبضة العقل و سابحا في أوهام الخرافة المنتعشة في ظل الخوف ، هذا كله أدى الى تهشيم الدين و إقصاءه من الساحة الأوروبية ، فغدى بذلك ضمن اللامفكر فيه بلغة هايدجر ، حتى نبغ من جديد مع شلايرماخر ، و دخل منعطفا مهما يبدأ ببداية الحدس و الإحساس و نهاية العقل و المنطق ، لذلك نجد الفيلسوف الألماني يتوجه لمثقفي عصره بالنقد من جهة و بالاحتقار من جهة ثانية ، لأنهم يتهمون الدين بالزيغ عن طريق الحق و يقذفونه بشتى أشكال التشنيع و التعيير ، لا لشيء إلا لكونه ينبني على الخرافة ، غير مبالين بالأثر الوديع الذي يتركه في نفوس معتنقيه ، حين يتحول هذا الدين الى تجربة شخصية تتلين بها الذات و تنفطر لها المشاعر و تجيش بها الأحاسيس ، يقول شلايرماخر : ” أنا على يقين أنكم أيها المثقفون لستم على علم بكيفية التعامل مع اللحظة العفوية المباغتة القاضية بتمجيد الإله في حضرة صمت مقدس سيواجهكم حتما إذا زرتم معبدا مهجورا ” . [2] إن كل مثقف يزدري من الدين و يستخف به من باب أنه قد تفطن الى وهمه هو مثقف مزيف ، أما المثقف الحقيقي أو المتزن بتعبير فيلسوفنا فهو الذي يلج أسرار ما ينخرط في النظام الكوني الآخروي ، و يكشف بعينه المتقدة المنفردة لحظة انبلاج المعنى في لب الدين ، فيدرك ماهية ذاته و الذات الواقعة على النقيض منها [3]. إن هذا الجانب المشرق للدين يفتحنا على أفق جديد يقع فيه موقع الرفض للغطرسة الجامحة التي يحملها المثقف المزيف ، صاحب التوجهات المادية و القوانين الأبدية المتميزة بشيء من الإطلاقية و الإذعان لكل نزعة علمية فلسفية مثالية محضة ، و الامتعاض من كل توجه مخالف يتنافر و المعرفة الموضوعية .
و بالرغم من انكماش الدين و تراخيه في أصقاع القارة الأوروبية ، إلا أنه اصطك ناره و أضرمت جذوته في النفس المتعطشة للحياة و الميالة للوجود الداخلي ، و هذا مكمن قوته ، إذ ليس الدين وسيلة لكشف الغموض و إزالة اللبوس عن هذا الكون ، إنه لا يفسر ما لا يفسر ، ولا ينتج معرفة عن ما لا معرفة فيه ، إنه لا يجوب عالم الما وراء بحثا عن الحقيقة المطلقة كما تفعل الميتافيزيقا ، و ليس أيضا أداة سحرية يمكن بواسطتها استتباب الصلاح في العالم ، بحسب قوانين أخلاقية معينة ، أو قواعد و ضوابط إلزامية ، ولا هو قائم على الترغيب و الترهيب ، ولا على الحلال و الحرام ، أو بالأحرى الدين حسب فيلسوفنا لا يتعلق بإطلاق بالعقيدة و الشريعة ، بقدر أنه يتصل في جوهره بالتأمل الحدسي و الشعور ، بما معناه أن الدين ينفلت من مجال الفكر و الفعل الى مجال إدراك الذات في ماهيتها و وجودها ، و هاذان الأمران ينطبقان على دواخل النفس و ما يختلجها من مشاعر أنطولوجية ، و بما أن الحدس من هذا المنطلق يتم في باطن الذات لا خارجها ، فإن إدراكها لذاتها يبلغ من البساطة و السهولة حده ، لذلك اعتبر برغسون الحدس من المواضيع البسيطة جدا ، لدرجة أن الفيلسوف لم ينجح أبدا في صوغه ، و يمكننا أن نفهم من هذا الكلام ، أن العملية الحدسية إذا حصلت فإنه تتدفق منها العديد من الإدراكات التي تعجز اللغة عن الإمساك بها و حصرها ، إن اللغة لا تستطيع أن تقول عنها شيئا ، لذلك لم يخض شلايرماخر غمار إبراز منافع الدين و تبرير وجوده ، و إنما انشغل أكثر بتفنيد من ينكرون وجوده بذريعة أنه مؤسس على وهم و خرافة ، مكتفيا بالارتكاز على المجال الخاص للدين الذي يكمن في روح الإنسان ، الروح التي تتماهى مع اللامتناهي و تتوق له ، و تنطوي على معنى يحيل الى علاقة الكائن المتناهي مع اللامتناهي هذه شبيهة بعلاقة الينبوع الأول مع وديانه و جداوله في فلسفة أفلوطين . كما و قد حذا شلايرماخر حذو كانط حين تسامى بالدين فوق المعرفة الموضوعية و عزله عن كل نسق منتظم يقوم على منهج صارم لبلوغ قوانين مضبوطة ، فضلا على تعلية الدين الى مستوى يصعب تقديره ينأى به عن تشويهات الممارسة و يبعده عن مرتع الفكر التأملي ، لذلك كان يقر الفيلسوف الألماني بأن إيمانه و تشبثه للدين لا ينبعث من قرارات عقلانية ، و لا ينبع من شعور بالأمل أو الخوف كما ذهب الى ذلك كل من فرويد و اسبينزا ، و إنما يصدر من ضرورة داخلية تقتضيها طبيعته ، و تمادى في جرده هذا لأسباب وجود الدين ليعده تسخيرا إلهيا يخول للإنسان أن يحدد مكانه في هذا الكون ، و يجعله كما هو في ذاته دون أي انفصام أو اختلال و تنافر في هذا الاتزان و الاتساق المتكون من قرارة الذات نواميس الكون بوساطة الحدس [4].
و يعد شلايرماخر أب التأويلية و المدشن الأول لها ، فقد نادى بضرورة تحويل النصوص الدينية من نصوص مقدسة و لاهوتية مغلقة لا تقبل النظر ، الى نصوص تتضمن خطابا بما هو عنصر أساسي في عملية التأويل ، خصوصا التأويل النفسي كما يسميه الذي ينصب الخطاب وسيطا لغويا ينقل فكر الكاتب الى القارئ ، لأن النص له قوانينه كما للعالم قوانينه . هنا يتبين أن شلايرماخر يمارس نوعا من الإسقاط ، حيث أسقط التأويل في النصوص على التأويل في العالم ، معنى ذلك أن الإنسان أثناء التجربة الدينية يكون مرآة أو انعكاسا للعالم و هو مغمور بالإحساس بعظمة المطلق . إن المفاهيم الدينية و المعتقدات الموروثة ثانوية بالمقارنة مع التجربة الدينية العفوية و المباشرة .
و على نفس خطى كانط استقى شلايرماخر نموذج الدين العالمي أو الكوني من فكرة أن سائر الاختلافات الدوغمائية المتحنطة تبدو غير ذات موضوع في ظل وجود مشاعر دينية حية و حقيقية ، فالدين الحق يقوم على المحبة ، و لكن هذه المحبة لا تتجه الى هذا أو ذاك او الى موضوع متناه أو خاص ، إنه يتجه الى العالم ، الى اللاتناهي ، المحبة هي انجذاب المتناهي الى اللامتناهي بتعبير هيجل ، دون أن تكون هذه المحبة متلحفة بزي إلهي ، لأنه يمكن لدين بدون إله أن يكون أفضل من دين بإله تسود فيه الصراعات و النزاعات الطائفية ، و المقصود من ذلك أن إدخال الله الى العالم أفضل من وضعه في مكان ما خارجه . و بالتالي فمهمة الدين هي مساعدة الإنسان أثناء سيره في الكون . على نفس المنوال قد مشت الأديان الخالية من الإله كالبوذية و الطاوية و الكونفوشيوسية ، و التي يمكن وصفها بالأديان الهادئة التي لا تثير شرارة البغضاء و الحق بين الناس بقدر ما تنثر بذور المحبة بينهم و تشيع أواصر المودة و الرحمة بين جميع الكائنات الحية ، إنها بذلك تقحم الله في دائرة المعيش ، إنها تحييه في النفوس ، و تقوض بهذا المعنى مقولة موت الإله ، و منه يمكن أن نقول أن خلق الإله من جديد من طرف الإنسان هو خلق يتوارى خلفه حاجة الذات له لكي تروي ضمأها الوجودي و تسد رمق جوعها الأنطولوجي . فالدين إذن و بعبارة لوك فيري هو الضامن و الحافظ للمعنى و لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال ، فإذا سلمنا بمقولة موت الإله فإن ذلك يجرد الإنسان من أي سند يدعمه و يتمسك به ، و يفقد الموجه كما سماه هايدجر الذي يرشده و يقوده . أما الإيغال في عالم المادة و العقل لوحده يبقي الإنسان تائها وسط عالم جاف و جامد و خال من أي دلالة أو قيمة ، ليغدو بلا إحساس و لا معنى ، و تظل الحاجة للدين ملحة قارة ، لكن الحاجة اللدين هي حاجة روحية ، و بما أنها كذلك فهي حاجة خاصة للدين كتجربة ، و ليس الدين كعقيدة ، فالدين كتجربة تظل حبيسة الذات و لا تنفذ الى الواقع ، أما الدين كعقيدة فإنه المجال العام الذي تتضارب فيه الآراء و النزعات و تتناحر فيه الطوائف و المذاهب . الدين كتجربة تنتج المعنى ، أما الدين كمعقد ينتج الفوضى .
عبد الجبار الرفاعي ، تمهيد لدراسة فلسفة الدين ، مركز دراسات فلسفة الدين ، بغداد ، 2014 ، ص 14[1]