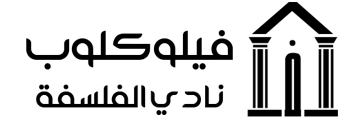الفيلسوف في غير مُقَامه – عبد الوهاب البراهمي
- الفيلسوف في غير مُقَامه
- عبد الوهاب البراهمــــي
لقد ظلّ الإنسان العادي دوما مصدر حرج للفلسفة، وإن أنكرت هذه الأخيرة ذلك وتجاهلته بكبرياء مزعومة. إذ هي لا تقدر أن تبرّر مشروعية وجودها بالنسبة إليه، تبريرا يستند إلى منطقه هو لا لمنطقها الخاص، ومشروعيتها الداخلية. من هنا كانت العلاقة بينهما صعبة دوما بل ربّما “مأساوية”. ذلك أن رهان القول الفلسفي كان دوما تقويض لا مبالاة هذا الإنسان لا تجاه ما تصنعه الفلسفة فحسب، بل تجاه ما يحدث حوله، وكان جهدها يتجّه ضمنيا إلى ” إقناعه” بجدواها، بمشروعيتها، بالإلحاح على خطورة القضايا التي تطرحها والتي بزعمها تمسّه في صميم وجوده. غير أنّ المسافة تظل قائمة بل لعلّها تتّسع كلما زاد إصرار الفيلسوف على دعواه وزادت لامبالاة الإنسان العادي وتعمّق إعراضه عنه؛ متّهما إياه، في حال الانتباه إلى وجوده، بالجنون والعقم والعبث.، وفي أحسن الحالات ربما بالغموض والتعقيد..وكلّما أصرّ الفيلسوف على النظر إلى الإنسان العادي من عليائه، بوصفه إنسانا يحكمه الجهل والوهم والمألوف وأنّ لا مجال لتحرره منها إلاّ بالارتقاء بنفسه فلسفيا، وسلوك مسلك أقوم وأرفع شأنا هو ” التفلسف”، زاد تمسّك الإنسان العادي “بالأرض” بسطحها، وبالحياة وبساطتها، وتعمّقت والهوة واتسعت بينهما. من هنا ظلت العلاقة على حالها منذ أن وجدت الفلسفة، لم تهدأ يوما، علاقة قد تحملنا على التساؤل هل تقدمت الفلسفة حقّا؟ ألا تدور معاركها على أرض واحدة، جامعة هي ” الإنساني “، وأن مقصدها الكلي وغاية غاياتها هو هذا الإنسان لاغير، هذا الذي لا يأبه مع ذلك لوجودها ولا يحسّ لها أثرا في حياته أو هكذا يعتقد؟ ولم تفلح الفلسفة يوما رغم تاريخها الطويل في أن ” تقنع ” بوجودها، بنفعها هذا الإنسان اليومي، متراوحة بين إصرارها حينا على التعالي والترفّع في موقف ارستقراطي يحقّر ” اليومي” ويبتذله، وبين محاولة مغازلته حينا آخر بالتفات إليه والتظاهر بالاهتمام به ومحاولة التقرّب أو الاقتراب منه في حركة “غريبة” أحيانا سرعان ما يُرْتد عنها ليعود الفيلسوف إلى “طبعه” “صورته” الغالبة بوصفه “مفكّرا ” غير عادي أرفع منزلة وأجدر “بالحقيقة ” من غيره ، من سائر البشر. ولأنّ الفيلسوف في عليائه لا يسمع لغيره، وخاصة لأولئك الذين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، ظلّ عاجزا عن الوصول إلى عقول عموم الناس وأسماعهم. كيف وهو الذي يصرّ على أن “يصعد ” الناس إلى القمّة حيث يقيم ويأبى أن ينزل من عليائه؟ !! ولكن ماذا لو ارتحل الفيلسوف إلى هذا “الآخر المنسي” واللامفكّر فيه فلسفيا؟ ماذا لو انحاز الفيلسوف مُكْرِها نفسه يوما إلى هذا الإنسان العادي، إلى اليومي واحتلّ موقعا غير موقعه، ” وتقمّص” دورا غير دوره، ليتساءل منتقدا نفسه بلسان غيره وبحجج خصومه، وهو العارف مع ذلك بأحواله، أفلا يجول بخاطره أن يقول ما قد يقوله الناس عنه في مقام غير مقامه:
” لماذا يقول الفيلسوف فلا يُسمع لقوله؟ ربّما لأنّه يقول ما لا يُسمع، حين يقول ما لا يودّ الناّس سماعه، أي ما اعتادوا قوله، وقول الفيلسوف “غريب” لا يُقال، إذ يُقال، حتى يُسمع، وإذا استُمع إليه فغالبا لا يُفهم. كلامه قدّ من “صخر”، يُنحت نحتا بالغ الدقّة ، ويُنسج نسجا بالغ “الرقّة”، ومع ذلك لا يأبه لصانعه، كأنما هو بيت ” العنكبوت” يفنى في صنعه، ثمّ يذهب مثلا في الوهن.. يزعم الفيلسوف أنّه يقصد بقوله الإنسان ولا شيء غيره ولكن الناس لا يكترثون لقوله. لم لا يُصدَّق إذ يقول بصدق ” المحبّ” لغيره:” أنّ الحقيقة خارج “الكهف” ومن وراء القيود”؟. لماذا لا يأبه لكلامه الهادئ الرصين ؟ ألأنّه لا يكترث بما يقوله الناس وما يفعلونه؟. كيف وهو الذي يزعم أنّه يتّجه بخطابه إلى الإنسان، إلى “الإنسانية”، إلى الجميع، إلى” مستمع كوني”؟ ولكن أين هو هذا “الإنسان ” الكلّي، أليس مجرّد ” فكرة ” أو ربّما كان وهما من أوهام كثيرة؟ أليس الإنسان ما نرى ونسمع! لماذا لا يتحدّث الفيلسوف إلى من حوله بدل أن يناجي نفسه زاعما أنّه يتأمل في “الإنسان”، يُجهد العقل في فهمه، فيزيده لبسا على لبسه، فلا يفهم من فَهْمِه إلاّ أنه لم يَفهم، فينغلق الفَهْمُ على الفَهِمِ؟ ما شأن الفلسفة والعادي واليومي؟ لماذا هذه العلاقة الصعبة؟ لماذا هذا النزوع “الغريب” لجعل المألوف “عجيبا” ؟ ألا يكفي الوجود”غرابة” حتّى نزيده ” غربة” ووحشة؟ لماذا لا تكون الفلسفة شأنا عاديا بدل أن تكون ” ترفا” فكريا وضربا من ” التلاعب بالأفكار”؟ يزعم الفلاسفة أن ” الفلسفة تفكير صعب” (هيجل)، ولكن كيف له أن يبرّر صعوبته لمن يجد أو يأمل أن يكون الوجود سهلا؟ ! ثمّ ما لهذا الفيلسوف يزعم أنّه صاحب مهمّة كأنما هو ” نبيّ ” يتحدّث بلسان ” الآلهة”، زاهدا في اللذات يكره الاختلاط بالناس وازدحام الأسواق”؟ كيف يسمع لقوله وهو ” مترفّع” عن بني جنسه، حتى لكأنّه ” أخفّ من الملائكة” يقيم في برجه العاجي ينظر إلى “الخلق من علياءه” يناجي السماء يطلب المطلق والمفهوم والمعنى المجرّد والحقّ والخير والفضيلة…لا يأبه لأنين وآلام المحرومين وزفرات المظلومين …كيف يقبل الناس على من أعرض عنهم وزعم نفسه ” أرفع شأنا، وأقوم عقلا..؟ !! ألم يزعم ديكارت وهو أحد سدنة “المعبد” الفلسفي، بأنّه “كان يتجوّل في المدينة لا يأبه لمن حوله من الناس كأنما يتجول في الحديقة بين الأشجار”؟ ! ألم يزعم “ديوجان” وهو يحمل مصباحا في الظهيرة أنّه يبحث عن الإنسان في وضح النهار ويضيء الطريق لغيره من “العميان”، ولم يأبه طاليس لسخرية خادمته وهو يقع متعثرا، بل استصغرها وقال غاضبا:” إنّ الضحك من شيم الخدم”، بينما كان الأولى به أن ينتبه إلى نفسه، إلى ما بين قديمه. وهذا سقراط، “كبيرهم الذي علمهم السحر” وقد نزل نفسه منزلة ” نبيّ ” ، كلفته الآلهة بنشر الحكمة بين الناس أو بالأحرى حبّها فلا أحبّه أهل مدينته و لا أحبّوا ما يحبّ، بل “اتهموه ” بالجنون” و بأنّه ” ينير عقول الشباب” ولم ينفعه موته منتحرا في تصديق الناس “لحبّه”. كيف يصدّقونه وقد كان يدعو إلى حبّ “الحكمة”، “حكمة” يدّعيها أو يدّعي ” الميل إليها” ولا يجد الناس إليها سبيلا، إلى حبّ الحقيقة لذاتها، دونما حاجة أو نفع؟ فكان يزعم البحث عنها ويحاور الناس في شأنها ويسأل ويجيب ويحاجج بمكر” الحاذق ” فلا يَنال منه محاوروه شيئا، سوى اعترافه بالجهل و” أنه لا يعرف” أو أنّه ” يعرف أنه لا يعرف”. وهذا أفلاطون تلميذه، قد أفناه ” الحلم” بمدينة فاضلة نسجها خياله ونصّب فيها ” الفيلسوف ” أو بالأحرى نفسه حاكما ومات وفي نفسه شيء من الغبن. وهذا ماركس قد ثار وغضب وانتصر للكادحين ووعدهم “بجنّة الأرض” فأخلف وعده. وهذا نيتشه قد جنّ جنونه وزعم أنّه “أصدق الكاذبين” قولا، يبشّر بالإنسان “إله” فوق الأرض، ليُهلكه “جنونه” ويموت بقلّة حيلته أمام مصابه..وهذا الفيلسوف، وهذا غيره وهم كثير شغلوا أنفسهم بما لا يشغل الناس، فانشغل عنهم الناس، وهلك منهم من هلك وظلّ منهم من ظلّ على “يقينه هو” أو “ضلاله” لا يأبه لسخرية من حوله ولا يأبه للامبالاتهم، في مراء ظاهر وإصرار صلب لا يلينه الاستهزاء و العقاب ولا حتى الموت.
تسخر الحياة ببساطتها وعفويتها من “تعقيدات” ومن” إشكاليات”، و”تساؤلات” و” أجوبة” الفيلسوف “التائهة” في ثنايا ” العقل ” و” العقلانية” و”المعقولية” و”العقلنة ” والمعقول واللامعقول…عمّا يعيشه الناس حقّا وفعلا من بؤس وفقر وألم وغبطة وغنى وراحة…كأنّما شأن الفيلسوف دوما “إزعاج” ومضايقة الناس ” بالسؤال عن العلة وعلة العلة، والمعلوم والمجهول، عن الشيء واللاشيء، عن الموجود واللاموجود والممكن أن يوجد وضروري الوجود وعارضه …عن المعقول واللامعقول ؟ !!… يتيه منه السؤال في ثنايا ومطباّت وتضاريس ونتوءات الفكرة وطيّات المعنى ظاهره وباطنه ويضيع في مذاهب القول حتّى لا يكاد يفهم ما يقول..ثمّ يعود من حافة “العصاب”، ومن “حلم يقظته” بشيء من قبيل ” القول” ، يزعم أنّه “حقيقة”، يوضع بين دفتي كتاب، ليدخل في سبات وينام كما ينام ” الموتى” بين الأحياء. لماذا يكتب الفيلسوف فلا يَقرأ له إلاّ من كان على نحلته؟ وهو الذي يقصد بما يكتب كل قارئ أيّ كان؟ ما قيمة مكتوب لا يُقرأ؟ أوْ لا تقرأه إلاّ فئة قليلة جدّا من القرّاء ؟ ألا يكتمل فعل الكتابة بفعل قراءةٍ يتّسع مجالها ليشمل أكثر ما يمكن من القرّاء؟ ولكن كيف للناس قراءة مُبْهمٍ مُلْغَزٍ تعسر قراءته وفهمه؟ يتحدّث الفيلسوف بلكنة غير مألوفة و”بلغة” خاصّة صنعها بنفسه لنفسه ألفاظها غريبة لا يفهمها مجرّد سامع. هل من معنى إذن لما يُقال فلا يُسمع أو لما يُكتب فلا يُقرأ؟ هل مصير ما يقوله الفيلسوف أن يظلّ على صعيد القول لا يتعدّاه إلى الفعل؟ ولكن هل يملك الفيلسوف غير ذلك قرارا؟ كيف سيقنع الناس إذن بشرعية ما يقول إذا لم يجدوا فيه نفعا ظاهرا على أرض الواقع، في معيشهم ومعاشهم وأيامهم و أحوالها المتقلبة ؟
“يسخر السياسيّ من الفيلسوف” من حيث أنّه لا يملك إلا قرار القول، حيث يقول السياسي فينجز. وقد يسخر ” رجل الدين” من الفيلسوف، حيث يقول فيُتّبع قوله. والمربّي حيث يأمر فيطاع، والعالم يقول فيصّدقه الجميع وحتّى الفنان يأنس له الجميع برغم “جنونه” وغرابته… ليس للفيلسوف مريدون ولا أتباع، إلاّ من بعض الذين آمنوا بالجنون ” ضربا من” العقل”؛ “هامشا” يزعم أصحابه أنه جوهريّ. ولكن لماذا يصرّ الفيلسوف مع ذلك على خوض “معركة” لا يعلم مآلها، بل قد تكون خاسرة من جهة أثرها على الناس عموما؟ يزعم أنه يحارب الوهم بحقيقة قد تكون بذاتها وهما. ويزعم أنّه يحارب الجهل بـ”معرفة” هي من قبيل الآراء لا غير. ويزعم أنّه يحارب التعصّب والوثوق وهو الذي كثيرا ما تتحوّل آراءه إلى ما يشبه “العقيدة” حولها “مؤمنون” و متعصّبون. ألم يتبرّأ ماركس نفسه من “أتباعه” وهم يقوّلونه ما لم يقله؟ ! ما الذي آل إليه الموقف الفلسفي ؟ هل أمكن له أن يغيّر بعمق ” ما نحن عليه” أو بالأحرى ” ما بأنفسنا” من الطبائع الفاسدة ؟ يزعم الفيلسوف أنّه يطلب ” إصلاح الذهن” أو ” توجيهه” توجيها سليما، بقواعد ومقتضيات يستنبطها فلا “يصلح” بذلك ربّما سوى ذهنه أو بالكاد. ويظل الناس على ” اعوجاجهم” أو على ” ما قُسّم لهم من عقل ” يقودهم ” الحسّ المشترك” وبه يسلكون حياتهم و قد يغنمون منه شيئا من ” السعادة” وينعمون ببعض الطمأنينة ولو كانت عارضة و” زائفة”. فمن يملك حقّا ” حقيقة السعادة”؟ يقدّم الفيلسوف نفسه عارفا بالطريق إليها. ولكن كيف يضلّ هو عنها ؟ من يشهد بأنّ الفيلسوف ” سعيد” بالضرورة من حيث هو “عارف”؟ ألا تنبأ حياة كثير من الفلاسفة بمعاناة وبؤس ويأس دفعت ببعضهم إلى “الموت ” ؟ لماذا التفلسف إذن إن لم يكن من أجل السعادة؟ مزيدا من التفلسف مزيدا من الألم: أي معنى لفعل لا نجني منه سوى ألم القلق والحيرة والتردّد وضائقة الوجود؟ ….”
يتضاعف السؤال هكذا ويتولّد وقد يصيب الفيلسوف الدّوار وهو على أرض غير أرضه وفي مقام غير مقامه. وسيدرك بسؤاله هكذا أنّه قد تاه زمنا طويلا عن ” الأساسي” ربّما، وهو الذي زعم أنّه قد عثر عليه من زمن بعيد. هل من ” أساسي” غير الإنسان على “قارعة الطريق”، هذا الذي يَعْمر العالم ويدين له بالأنس والسكن والحضور والغياب والثبات والتحوّل.الخ..؛ هذا الإنسان الذي اعتبر مع ذلك “هامشيا” قرين السذاجة والابتذال.. وسيدرك الفيلسوف ربما أن كبريائه المزعوم وأوهامه البائسة صرفته عن الإقبال على الحياة ببساطتها وعفويتها كما تعاش دون زخرف “القول” ولا زينة. وسيكون للفيلسوف ربّما، لو استيقظ من “حلم يقظته” وفتح عينيه على العالم حوله، على الإنسان “هكذا”، شأنا آخر مع نفسه ومع ما يصنع. ولكن أنّى له ذلك وقد استفحل داء ” الصّلف” وداء ” الحمق” وصارا عضالا؟ !!!