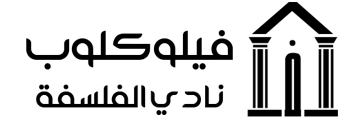نقاش مع بول ريكور حول غربة الذات عن ذاتها – ترجمة د زهير الخويلدي
- نقاش مع بول ريكور حول غربة الذات عن ذاتها
- ترجمة د زهير الخويلدي
“ترتبط الانجرافات المحتملة على وجه التحديد بالشعور بالغرابة، ولن نعالجها إلا بالضيافة”
الترجمة:
“أشكر بحرارة جان بواسونات على دعوتي مرة أخرى إلى الأسابيع الاجتماعية بفرنسا، وأهنئ المنظمين على كسرهم لكلمة مهاجر واقترح على الجميع استبدال العداء بين الهجرة والهجرة بمصطلح شامل للهجرة، مساهمتي سيكون له علاقة بهذه الطفرة التي لا ينبغي أن تبقى في الكلمات، بل تمر عبر الأفكار والقلوب.
أود أن أقدم مساهمتي في شكل رحلة ومسار. سأرحل وأنا مؤكد أنني في ذاتي، في جهل الغريب. بعد ذلك، سأمر بلحظة الصدمة المرتبطة بالشعور الحميم بالغرابة، وسأنهي بإعادة اكتشاف واجب – وكذلك حق – الضيافة. لقد تم تحديد مسار الرحلة هذا في كلا الطرفين بنصين مرجعيين من الكتاب المقدس. الأول يحيي ذكرى وقت الاعتقال والخلاص، والثاني يتنبأ بوقت الدينونة الذي سيظهر فيه ما فعلناه في حياتنا وتاريخنا.
يتم اختيار الأول من سلسلة نصوص تنتمي إلى العديد من تقاليد إسرائيل التوراتية، والتي يتردد فيها نفس التذكير لتذكر “لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. يتذكر جميع اليهود هذا النص، ونصوص أخرى مثله، في ظروف طقسية أو عائلية أو خاصة. يمكن قراءة هذه النصوص في سفر الخروج والتثنية واللاويين. اخترت نص لاويين 19، 34 لأنه يدمج حب الجار ويقحمه بين الإرشاد للضيافة وتذكر الغريب. إليكم هذا النص: قرأته في إنجيل القدس، الذي أفضّله بشكل خاص: “الأجنبي الذي يسكن معك سيكون مثل مواطن لك، وستحبه على طبيعتك، لأنك كنت غرباء في ارض مصر. ” وإليك النصيحة: الذكرى تبرر حسن الضيافة؛ “لأن” وكذلك “الإعجاب” (مثل مواطن، مثلك) يربطان الضيافة بوصية الحب. سأقول القليل، في البداية، عن الموضوع الثاني الذي ينتمي إلى التسلسل المسمى “الدينونة الأخيرة” في متى 25 ؛ يشير المتخصصون إلى هذا النص على أنه “القليل من الأمور الأخيرة” لأنه يثير حُكمًا نهائيًا ، وهو حكم مزدوج: “كنت غريبًا ورحبت بي” ، “كنت غريبًا ولم ترحب بي. لبدء مسار الرحلة هذه، أود أولاً أن أذكر ظروف النص الأول. مشكلتي ليست التفسير على الإطلاق. لكن من الجيد أن نتذكر أنه في دستور هوية إسرائيل، إسرائيل التوراتية، يلعب التجوال والنفي دورًا مركزيًا. تجول الشخصية البطريركية لإبراهيم، “والدي كان آراميًا”، النص الشهير الذي كان يُعتبر في الماضي معروفًا تقريبًا بأنه عقيدة إسرائيل – يبقى مجبراً في الخارج، أربعين عامًا يتجول في الصحراء، ولا سيما المنفى البابلي. كتبت فرانسواز سميث مؤخرًا: “في البداية، المنفى”. يعتبر العديد من المفسرين اليوم أن المنفى هو التجربة التأسيسية، وأن مصر لعبت دور الذاكرة الرائعة، والأصل المؤسسي، فيما يتعلق بالذاكرة التاريخية للمنفى. سؤالي، كما قلت، ليس تأويلاً إطلاقاً. هو معرفة ما يعنيه لنا اليوم “أن نتذكر أننا كنا غرباء”. ليس من الضروري، أو حتى بشكل أساسي، تذكر أحداث حقيقية. علاوة على ذلك، فإن الهجرات العظيمة في الألفية الأولى التي أتينا منها (كلنا برابرة سابقون) ليست راسخة في ذاكرتنا الجماعية، حتى أقل شخصية. ومن بيننا هنا في هذه القاعة قليلون فقط لديهم ذاكرة حقيقية عن المنفى. لذلك فهي في الغالب ذاكرة رمزية نستوعب بها الحالة الفعالة للأجنبي؛ ومن هنا جاء العنوان المقترح: “شخص غريب. هذه هي الذاكرة الرمزية التي سأحاول إحياءها فينا اليوم. أقترح أن نمر خلال الفترة الفاصلة بين نصي: الخروج ومَتّى. بروح تعليمية، سأحدد بقوة المراحل المتتالية من مسار الرحلة هذه.
- في البداية – المرحلة الأولى – سنبدأ مما أسميته في البداية الشعور وكأننا في المنزل. هذا الشعور المؤكد هو شعور من أسميهم “المواطنين المستقرين”، وهو شعور معظمنا. إنها حالتنا المعتادة الهادئة؛ وأود أن أبين الحقائق التي تختلط هنا والتي تحجب مصادر الضيافة – اليقين بأن الذاكرة الرمزية لكونك أجنبيًا سوف تزعجك أولاً. لكن من هو الأجنبي؟ ومن هم الاجانب؟
قبل الأخذ بعين الاعتبار الحالة غير المتمايزة للأجنبي – الكائن الأجنبي، إذا جاز لي القول – دعونا نعيد نشر الشخصيات المتعددة للأجنبي. في أحد طرفي الطيف، نجد الغريب كزائر، شخصية مسالمة بامتياز: من السائح الذي يتنقل بحرية في أراضي البلد المضيف إلى المقيم الذي استقر في مكان – معنا – ويقيم هناك. يوجد في منتصف الجدول المهاجرون، أي بالنسبة للجزء الأكبر من العمال الأجانب، أولئك الذين يطلق عليهم في مكان آخر جاستاربيتر أو العمال الضيوف؛ إنهم زوار مجبرين، مجبرين على توظيف قوة عملهم بيننا؛ يتم تتبع حياتهم من قبل مؤلفين اجتماعيين غير أنفسهم، من قبل نحن المواطنين. بالطبع، يسكنون المنطقة المحمية للدولة المضيفة؛ يتنقلون بحرية وهم مستهلكون مثلنا مواطنون؛ جزء من حريتهم يعود إلى مشاركتهم، مثلنا، في اقتصاد السوق؛ جزء آخر ناتج عن وصولهم، ضمن حدود معينة، إلى حماية دولة الرفاهية؛ لديهم حقوق نقابية ويتمتعون من حيث المبدأ بنفس حقوق السكن التي يتمتع بها المواطنون؛ لكنهم ليسوا مواطنين ويحكمون دون موافقتهم. إن محنتهم تسلط الضوء على التناقض بين تنقل العمالة على نطاق عالمي وانغلاق الحيز السياسي للمواطنة الذي سنناقشه بعد قليل. في أساس كل شيء، لم يساهموا في التاريخ الصامت للرغبة في العيش معًا في ظل الميثاق الوطني. في الطرف الآخر من الطيف، لدينا رقم الأجنبي كلاجئ، وهو رقم يسلط الضوء على الاختيار السيادي للدول فيما يتعلق بتكوين سكانها والوصول إلى أراضيها – وهي المفاهيم التي سنفكر فيها. في لحظة. دعنا نقول على الفور أن هذا الاختيار السيادي للدول يقف في طريق حق ناشئ عن مصدر آخر غير الرغبة في الإقامة في مكان آخر، أي الحق في حماية السكان المضطهدين، والذي يتوافق مع واجب اللجوء من جانب البلدان المضيفة.
لا أقول المزيد عن تنوع شخصيات الأجنبي، بل على الوضع الأساسي العالمي للأجنبي الذي أود التركيز عليه، للتأكيد على غرابته الأساسية. لكن كان من المهم أن نبدأ بمكافحة الانخفاض السريع جدًا في الخيال العام لحالة الأجنبي إلى حالة المهاجر، كما اعتدنا أن نقول، ثم حالة المهاجر إلى الحالة السرية، وهذا هو الوضع. هامشي. أود أن أصعد هذا المنحدر الهابط، من الهامشي إلى غير الشرعي، من الأخير إلى المهاجر الذي يضع نفسه في وسط صورة حالة الأجنبي. هذا هو ما أود أن أعتبره بنفسه.
بالنسبة لنا، الذين أسميتهم “مواطنين مستقرين”، فإن الأجنبي هو أولاً وقبل كل شيء غريب آخر. قرأت تعريف الأجنبي في روبرت: “أجنبي، من أمة أخرى، والحديث عن فرد: كونه جزءًا من أمة أخرى”. دعنا نقول بكل بساطة: الأجنبي هو شخص ليس من بلدنا، وليس منا. لكن لا شيء يقال عما يعنيه الغريب لنفسه – في المنزل. ومن المزاح أن تقول: “أحب الأجانب.. في ذواتنا “؛ لأننا، على وجه التحديد، لا نعرف شيئًا عنهم من التعريف البسيط للوطنية. في البداية، لدينا فقط هذه السمة الحاسمة للحق والعدالة، ولكن أيضًا لضميرنا، أي المعارضة الثنائية الضخمة، نَحْنُ وهُمْ. لكن هذه المعارضة البسيطة قريبة بشكل خطير من انقسام ثنائي آخر: بين الصديق والعدو. إنه بالنسبة لعلماء السياسة بنية أساسية للسياسة. هذا القرب بين المعارضة نَحْنُ-هُمْ وصديق – عدو المعارضة هو الذي يشكل الخطر الروحي الأكبر. ومن هنا يأتي السؤال الحاسم: على أي يقين يتم بناء هذه المعارضة الثنائية والحفاظ عليها: وطني-أجنبي، نَحْنُ-هُمْ؟
هذا هو الرد العفوي؛ إذا كنا لا نعرف من نحن، فمن المفترض أن نعرف ما ننتمي إليه، أي مجتمع نحن أعضاء فيه. إن فكرة الانتماء، وكوننا أعضاء في … قوية للغاية لدرجة أنها تقودنا إلى التعامل مع الأمة التي ننتمي إليها كشخص، وتعيينها باسم مناسب. نقول فرنسا، إنجلترا، ألمانيا، إلخ. في المقابل، يُعرَّف الغريب سلبًا على أنه شخص لا ينتمي إلى دائرة هويتنا، إلى مجال انتمائنا. حسنًا، هذا الشعور بالانتماء إلى الهوية هو الذي سيتغير، والذي سيتم تقويضه بطريقة ما، وتقويضه من الأسفل، من خلال الانعكاس التالي، المتمحور حول الذاكرة الرمزية لكونك أجنبيًا. لكن دعنا نبقى لحظة في هذه المرحلة الأمنية بجوانبها القانونية القوية: هذا اليقين وهذا الوعي وهذه الثقة بالانتماء إلى هيئة سياسية حازمة هو في الواقع ضمانة ومحمية ومقرها مبدأ قانوني أساسي، مبدأ السيادة، الذي يوضح الحق الداخلي الخاص بالقانون الدولي، وهو ما يعني أنه من اختصاص الدولة تعيين حدود أراضيها، وتحديد قواعد العضوية في المجتمع الوطني، وبالتالي إنشاء تعارض ثنائي بين الوطني والأجنبي. على الجانب السلبي، هذا يعني أنه لا يمكنك اختيار أن تصبح بريطانيًا، على سبيل المثال، إذا كنت تريد ذلك. كما يقول أحد المنظرين، الجنسية خير تمنحه دولتنا بشكل سيادي لمن تريد، في نهاية المطاف كما تفعل جميع الدول الأخرى أو، كما يقول المؤلف: إنها خير نوزعها على الآخرين، لكننا لا نوزعها أبدًا على أنفسنا: بالنسبة لمعظمنا، لدينا بالفعل. وهذه السلطة التقديرية هي المطمئنة لنا والتي تعزز اليقين بمعرفة ما ننتمي إليه، وعدم معرفة من نحن، لأنها أحد الأصول التي نمتلكها بالفعل. بالبقاء على هذا المستوى القانوني للحظة، سأتذكر ثلاث تطبيقات، ثلاث نتائج طبيعية لهذه السيادة. النتيجة الأولى: الصلة بين الدولة وأراضيها وسكانها علاقة فورية. الأمة منطقة مأهولة بالسكان وتحمل اسم علم: فرنسا؛ ترتبط الصفة به، والتي أصبحت هي نفسها موضوعية: الفرنسيون، أي أولئك الذين يشكلون سكان الدولة. لذلك، ببناء نفسها، تبني الدولة أراضيها، ومنطقة اختصاصها وحدودها؛ لأن هناك حدودًا مادية وقانونية وسياسية تجعل الأمة كيانًا محدودًا: إنها دولة.
التطبيق الثاني: الصلة بين الجنسية والمواطنة. في تقليد اليعاقبة الذي هو تقليدنا، يتداخل الاثنان كليًا إلى حد ما مع استثناءات قليلة: الأطفال والسجناء والمختلون عقليًا؛ ولكن في الغالب يمكننا قول ذلك تداخل الجنسية والمواطنة. الآن ما هي المواطنة؟ إنها القدرة على المساهمة والمشاركة في السلطة السياسية، لا سيما من خلال الانتخابات، التي تمنح كل مواطن ذرة من السيادة. نرى على الفور الجانب السلبي: ما يميز الأجنبي من وجهة النظر هذه هو، وفقًا للمعيار الأول، أنه خارج فضاءنا الوطني، خارج حدودنا؛ وهي حسب المعيار الثاني لا تتمتع بأهلية سياسية. هذا العجز السياسي للأجانب هو ما نحاول في بعض البلدان التغلب عليه جزئيًا، على سبيل المثال من خلال منح الأجانب الإذن بالمشاركة في الانتخابات البلدية. لكن بالنسبة لدستور السلطة المركزية والتنفيذية والتشريعية، لا يوجد مثال حالي على وصول الأجانب إلى صفة المواطن. كان هناك البعض في الماضي، في ظل الثورة الفرنسية. تم معاملة الأجانب الفخريين كمواطنين فاعلين.
المعنى الثالث لهذه السيادة – مع قاعدة الاستبعاد السلبية التي تتوافق معها – يجد تعبيره فيما نسميه بطاقة هويتنا. عضويتنا في الدولة الوطنية، بأراضيها وجنسيتها، هي جزء من هويتنا الشخصية. وهذا ما يسمى “الأحوال الشخصية”: تتضمن بطاقة هويتك اسمك الأول واسم عائلتك ومكانك وتاريخ ميلادك وجنسيتك. لذا فإن الجنسية هي من مكونات هويتنا الشخصية، والتي تشكل جزءًا من هويتنا الانتماء. هذه هي نقطة البداية لمسار رحلتنا. لقد أصررت، ربما لفترة طويلة جدًا، على جدية هذا الثقل، هذه الجاذبية، الشعور الآمن بالانتماء. أكرر: إذا كنا لا نعرف من نحن، فنحن على الأقل نعرف أين ننتمي. هذا هو الوضع الآمن والمستقر للمواطنين الراسخين الذي سننتقل إليه الآن.
- أستمر في الطريق من خلال المرحلة الثانية التي أسميها زعزعة استقرار الهوية. هذا هو الأمان بمعرفة ما ننتمي إليه، حيث ستهتز الذاكرة الرمزية أو الفعالة لكوننا غريبًا. غالبًا ما تتزعزع أفعال الذاكرة الرمزية، تذكر عميق للغياب النهائي للجذور المطلقة في أساس وجودنا. يصبح أسر مصر هناك رمزًا قويًا للقدرة على الوجود في مكان آخر غير بيئتنا المألوفة.انالحركة بأكملها التي أشرحها هنا هي الانتقال من اليقين في هوية الانتماء إلى نوع من عدم اليقين الراديكالي فيما يتعلق بالسؤال إما “إلى ماذا ننتمي؟” لكن “من نحن بعد كل شيء؟ من أنا؟ “وهذا هو السؤال: من أنا؟ وهو بطريقة ما المفتاح المخفي بكل الأدلة التي قلتها للتو والإجابات على ماذا وإلى أي هيئة سياسية ننتمي. بعبارة أخرى، يجب أن تبدأ بطاقة هويتنا في إثارة الأسئلة.
هنا يبدأ طريق زعزعة الاستقرار، اكتشاف غرابتنا. دعونا نبدأ من حقيقة أننا لسنا واضحين على الإطلاق وأنه ليس لدينا أسباب شفافة بشأن هذه العضوية على وجه التحديد. لا نستطيع الإجابة على السؤال: “لكن لماذا أنت فرنسي؟ هذا ليس سؤال طبيعي وعفوي. نحن، وعلى الأكثر يمكننا أن نسأل أنفسنا بالخيال: “ماذا يمكن أن يعني أن تكون فرنسيًا؟” هذا سؤال نعتقد أننا نتقنه بشكل أفضل من السؤال “كيف يبدو أن تكون ألمانيًا، أن تكون بريطانيًا؟” حسنًا، بالضبط، اللحظة الأولى لزعزعة الاستقرار هي المقارنة. مقارنة لا مفر منها. أقارن: ما هي الفرنسية وما هي الألمانية أو الإنجليزية؟ ومع ذلك، في هذه المقارنة، يمكن أن يتغير كل شيء لأننا أولًا نتخيل الآخر. بينما نطمئن أنفسنا بأننا لسنا هذا الآخر. بمجرد أن نبدأ في تخيل الآخر، نكتشف هذه الغرابة المثيرة للقلق والجاذبية والرائعة. يمكننا القول إن المقارنة تبدأ نوعًا من الصدمة والتهديد. ولماذا؟ لأن الهوية العميقة، التي تتوافق مع السؤال “من أنا؟”، والتي تخفيها هوية الانتماء، تكشف فجأة عن نفسها هشة للغاية.
لماذا الهش؟ لعدة اسباب. يكمن المصدر الأول للهشاشة في صعوبة ضمان تناسقنا واتساقنا مع مرور الوقت: كيف نحافظ على ذلك من خلال جميع التغييرات في الموقف والتجربة والعمل والمعاناة نشعر دائمًا بالتهديد من خلال “التدمير من الداخل بالتغيير”.
المصدر الثاني للهشاشة: نسعى دائمًا إلى أن نكون مثل أنفسنا، وأن نلتزم دون مسافة بيننا وبين أنفسنا. يتضح أن هذا الخيال من السياج على الذات هو حلم مستحيل. نحن نصب الماء من جميع الجوانب في هذه المحاولة اليائسة للدوران مع أنفسنا.
المصدر الثالث للهشاشة: الشعور بأن أساس هويتنا الجماعية، وربما الشخصية، يوجد عنف: هناك القليل من الدول والثقافات التي لا ترتبط بالعنف المؤسس. جذور هذا العنف هي العلاقة بالموت، غير القابلة للاختزال إلى اليقين من الاضطرار إلى الموت؛ إنه اكتشاف العلاقة بالموت المعروف الذي يلحقه الإنسان بالرجل الآخر؛ هذه العلاقة بالموت لا يمكن اختزالها لموت بسيط ؛ إنه التهديد بالقتل في أساس الثقافة. لقد نجت دول وثقافات قليلة من هذا العنف التأسيسي. هذا هو السبب في أن غزو الحضارة على البربرية الأصلية يظل دائمًا غير مستقر. لكل هذه الأسباب يُنظر إلى الآخر على أنه تهديد أساسي. التهديد المرتبط بالاتساق مع مرور الوقت؛ التهديد المرتبط بفشل الالتزام الذاتي؛ التهديد المرتبط بقمع صندوق العنف الأصلي، والعلاقة بين الحياة والقتل. من السهل للغاية أن تصبح بربريًا مرة أخرى. بدونها، لن نفهم ما حدث في هذا القرن العشرين الرهيب. كل هذا يدل على أن كره الأجانب أمر طبيعي وعفوي. أعترف بذلك. عواطف الهوية متجذرة بعمق فينا. لا يوجد شخص يتأثر أكثر من غيره. المهم في هذا الصدد ليس قمع هذا الشعور السيئ، ولكن لإبرازه على ضوء اللغة. السؤال الحقيقي هو: ماذا نفعل به هذا الإحساس؛ قارة نحاربها؟ هذا هو المكان الذي يبدأ فيه عمل ذكرى المنفى.
- المرحلة الأولى من عمل هذه الذكرى، ذاكرة المنفى، هي إنهاء جميع مخاطر المقارنة، وجميع التهديدات الناشئة عن خيال الغريب – حتى شعرنا بالاختلاف بين الآخرين. إنها تجربة يمكننا القيام بها بكل بساطة مع اللغة. الاكتشاف الأول الذي يمكن أن يقوم به تلميذ هو أن الآخرين يتحدثون لغات نسميها لغات أجنبية. يجب أن نكتشف أن تنوع اللغات هو حقيقة أساسية للواقع البشري. علاوة على ذلك، حقيقة مذهلة، لأن كل البشر يتحدثون. حتى من خلال هذا نعترف جزئيًا بالإنسانية. لكن لا يوجد شيء اسمه لغة عالمية. يشكل تنوع اللغات تجزئة بدائية. هناك شيء يجب أن يفاجئنا ويجعلنا نتحرك إلى الأمام، لأن العمل الذي يمكننا القيام به على لغتنا يجعلنا نفهم أنها لغة واحدة من بين جميع اللغات الأخرى. عندها نكتشف ربما لأول مرة معجزة الضيافة في شكل ترجمة. من خلال الترجمة نبدأ في فهم أن ما يقال بلغتنا يمكن أن يقال أيضًا، وربما لا يمكن قوله بلغتي. بالحديث عن الترجمة، فأنا لا أعطي مثالاً فحسب، بل بالفعل نموذج للضيافة. الترجمة تعني العيش في لغة أخرى: اللغة الأخرى مع لغتنا. يجب أن نتقدم أكثر على طريق الغريب، ونكتشف مناطق أخرى مخفية من الغرابة داخل أنفسنا. هكذا نكتشف في قلب أنفسنا دوافع مفاجئة أننا مندهشون من الاحتماء. بمناسبة هذه الدوافع والأوهام التي تتوافق معها، ندخل منطقة الغرابة المزعجة. إذا اتبعنا هذا المسار، فإننا نتخيل أنفسنا كما تخيلنا في السابق بشأن الآخرين. نحن نتخيل فرصة ولادتنا. بين الحين والآخر نقول لبعضنا البعض إنها مصادفة أن التقى والداي؛ إنها صدفة أنني ولدت. كان بإمكاني أن أكون آخر. هذا الحلم هو أكثر إثارة للقلق لأنه في نفس الوقت لا يمكنني العودة إلى ما هو أبعد من حقيقة أنني ما أنا عليه. عندما قيل لي: إذا ولدت في الصين، فلن تكون مسيحياً. لا يقولون لي أي شيء عاقل. سيكون بالفعل شخصًا آخر غير نفسي. بالتأكيد، لدي إمكانية تخيل أنه كان بإمكاني أن أكون شخصًا آخر؛ وهو خيال مزعج يجعلك تفكر. لكن هذا خيال. من هناك ننتقل بالصدفة إلى المكان والزمان. تم اقتطاع “المنزل” من منطقة كان من الممكن تقاسمها بطريقة أخرى. فعل السكن هو فعل تقاسم الأرض وهو أمر محفوف بالمصادفة. ليست هناك حاجة لأن تكون “هنا”. هناك رابط عرضي بين ما نحن عليه وبين هذه الزاوية من المكان أو الزمان. لقد شعر باسكال بهذا بنوع من العنف الروحي، عندما تحدث عن الإنسان “الضائع في كانتون الكون”. أشير إلى أنه في النهاية موضوع كتابي قوي، مرتبط بما يبدو أنه العكس، ألا وهو الاختيار. الاختيار، لشعورنا بالانتماء، يعادل التبني لشعورنا بالبنوة. نحن في طريق هذه الجنسية بتبني رمزي. اعتمده أسلافنا الأول. الانتخاب، كما يفهم، هو الشعور بأنه لا يحق لنا أن نكون هنا وليس هناك، وأن نكون مالكين لهذه الأرض دون غيرها. يجب ألا يُنظر إلى الانتخاب على أنه امتياز ولكن يُعرف باسم الدعوة إلى إدارة البضائع الموكلة إلينا والتي لسنا مالكين لها في النهاية. إذن هذه فكرة الهدية القابلة للإلغاء. هذا هو الأساس اللاهوتي لعلم البيئة. الشخص الذي أسميته سابقًا “الوطني المُثبت” منزعج من هذه التخيلات التي تبعث على التفكير. وهكذا نصل إلى مرحلة أكثر تقدمًا من هذا الشعور بالغرابة، أي عدم وجود حق أصلي في أن نكون هنا وليس في أي مكان آخر. أود في هذا الصدد أن أقتبس من نص كتبه كانط، مأخوذ من مشروع السلام الدائم، يستحضر “حق الحيازة المشتركة لسطح الأرض الذي لا يستطيع” البشر “تشتيت أنفسهم عليه، كشكل كروي؛ لذلك يجب أن يدعموا بعضهم البعض، فلا يحق لأحد أصلاً أن يكون في مكان ما على الأرض دون مكان آخر “. يتم تجاوز العتبة الأكثر دراماتيكية لهذا الاضطراب عندما تمس أعمق معتقداتنا. أتوصل إلى الشعور بأنه، في أعماق إيماني في صميم أكثر ما لدي، هناك شيء لم يتم قوله، مرتبط بالعلاقة التي لا تنضب مع المؤسسة – لم يقل ذلك مما يجعل فقط ما لا يقال في المنزل، في اعتقادي، في مجتمعي، يقال بالتأكيد في مكان آخر، وإلا. لكني لا أعرف كيف. هذا هو أساس العلاقة مع الأديان الأخرى. لا يسعني إلا أن أقول إيماني، إنها فرصة تتحول إلى مصير من خلال الاختيار المستمر، لكن ليس لدي السيطرة الكاملة على هذا الاختيار. من المؤكد أن احتمال الضياع في هذا الطريق أمر رائع. ترتبط الانجرافات المحتملة على وجه التحديد بالشعور بالغرابة، ولن نعالجها إلا بالضيافة. لقد تطورت رومانسية شعبية مهمة جدًا حول ما سأسميه عبادة الشرود، حيث يفخر المرء بنفسه عندما يتحدث من لا مكان، ويأتى من لا مكان، ولا يذهب إلى أي مكان، ويظل دائمًا في مكان آخر. إنه النقيض المطلق للشعور بالانتماء. يذهب إلى حد فقدان الهوية الشخصية للذات. أرى في العديد من الزملاء الشباب، فيما يسمى ما بعد الحداثة، أيديولوجية كاملة للاختلاف والتي تبدو لي على العكس تمامًا من هستيريا الهوية. حسنًا، ما يجب أن يكون قادرًا على تحقيق التوازن بين الشعور بالاختلاف هو الشعور بالتماثل البشري، والشعور الآخر بالمثل. أنه الشهيرة “مثل” سفر اللاويين. “ستحب قريبك كنفسك. هناك خطر فقدان “الإعجاب” في أيديولوجية الاختلاف، وهناك نقطة متطرفة حيث تصبح الاختلافات غير مبالية. لا يوجد سوى الآخر – إلى أجل غير مسمى … إنه منفى بدون عودة، كما لو أن يوليسيس لم يعد أبدًا إلى إيثاكا ، كما لو أن إبراهيم كان ذاهبًا لكنه لم يذهب إلى أي مكان.
- في هذه المرحلة أود أن أوجز الخطوط العريضة لمرحلة العودة إلى الضيافة. الهدف من كل التأمل الذي تم تناوله هنا هو إعادة اختراع الضيافة من خلال الذاكرة الوهمية أو الحقيقية لكونك أجنبيًا. لذلك فهي المرحلة الأخيرة من مسار رحلتنا، في الفترة الفاصلة بين نصي الكتاب المقدس، اللاّويين ومتّى. إذا كان علينا أن نتذكر أننا كنا، لكي نكون دائمًا غريبًا، فإن الغرض الوحيد هو إيجاد الطريق إلى الضيافة. لذلك هذا هو المعنى العميق للاويين: “أحب الآخر كما أحب نفسي. ” يمكن تعريف الضيافة على أنها مشاركة “المنزل” وتجميع الفعل وفن العيش. أنا أصر على كلمة سكن: إنها الطريقة البشرية لاحتلال سطح الأرض. إنها العيش معًا. في هذا الصدد أود أن أشير إلى أن كلمة المسكونية تأتي من الكلمة اليونانية التي تعني “الأرض المأهولة”.
حسنًا ، الضيافة هي السبب الأخلاقي لفعل العيش معًا. لكن هذا الفعل نفسه يلخص مسارًا مكثفًا تتعقبه مفرداتنا. يلخص تعريف كلمة حسن الضيافة في روبرت رحلة كاملة. نبدأ من معنى القرون الوسطى ، وهو الكرم المجاني ، وليس الإجباري ، والقليل من التنازل ، والذي يتوافق مع المعنى القديم لكلمة خيرية (يشير روبرت: الاستخدام القديم: “الصدقة التي تتكون من جمع وإسكان وإطعام المحتاجين ، المسافرين مجانًا في مؤسسة مخصصة لهذا الغرض “). أذكرك أن كلمة مستشفى تأتي من هناك.
يأتي بعد ذلك اقتباس من عام 1548 – هذا هو الوقت الذي تتم فيه إعادة قراءة القدماء. ومع ذلك، تحتل الضيافة القديمة مكانة رئيسية في هوميروس، حيث بدأت حرب طروادة باختطاف هيلين، أي انتهاك الضيافة. ومع ذلك، فقد بنى الإغريق فكرة الحق المتبادل في العثور على سكن وحماية من بعضهم البعض، على سبيل المثال بين مدينتين. هذا هو الحق المتبادل الذي انتهكته باريس. كانت بداية حرب طروادة. فقط منذ القرن السادس عشر، من خلال مزيج من اليونانية والعبرية والمسيحية، تم تأسيس المعنى الإيجابي للضيافة، والذي يعرفه روبرت بأنه “حقيقة الاستلام في المنزل، من خلال استيعابها في النهاية، من خلال إطعامها مجانًا من المسؤول، المضيف “. لذلك صادفنا كلمة مضيف ولم نعد مستشفى. يسمح لنا هذا التاريخ المكثف للكلمة أن نشهد انخفاضًا تدريجيًا في روح تفوق المتبرع، والتنازل في الكرم، الذي يلوث فعل الاستلام في المنزل، والمشاركة في المنزل. النقطة الأخيرة من هذا التطور هي فكرة أن واجب الضيافة يتوافق مع الحق في الضيافة. أجد هذا الحق معبرًا عنه في مشروع كانط للسلام الدائم، والذي سبق ذكره سابقًا: “إنها ليست مسألة عمل خيري بل قانون هنا. وبالتالي، فإن الضيافة تعني هنا الحق الذي يتمتع به الأجنبي، عند وصوله إلى أراضي شخص آخر، ألا يعامل على أنه عدو هناك … ومن حق كل رجل أن يقترح نفسه كعضو في المجتمع. هذا يعني أن أي مضيف هو مرشح افتراضي للمواطنة. في هذا تكمن قوة فكرة الحق في الضيافة، والتي لا تعتبر بالتالي نتيجة للكرم الباذخ المتنازل، بل هي حق فعال. لكن ما هو الحق؟ نحن نتطرق هنا إلى عمق القانون الدولي، حول صندوق القانون هذا الذي لم يتم الاستيلاء عليه من قبل القانون الوطني، ولكنه لم يجد بعد مؤسساته المناسبة، حيث أن حتى الأمم المتحدة هي تعبير فقط عن حسن نية أعضائها؛ إنه تحالف. بهذا المعنى، فهي ليست مؤسسة بالمعنى القوي لهيئة ذات سيادة أعلى. كان يُنظر إلى هذا القانون الدولي بقوة في القرنين السابع عشر والثامن عشر على أنه تجاوز القانون الداخلي للدول القومية. إن التعبير الوحيد الذي لدينا حاليا على المستوى القانوني موجود في الرسوم التخطيطية لحق التدخل، في إنشاء المحاكم الدولية وبشكل أكثر جوهرية في مفهوم الجريمة غير القابلة للتقادم ضد الإنسانية والتي تشكل الإبادة الجماعية جوهرها. ولكن، إذا كان هناك معنى يجب إعطاؤه لفكرة جريمة غير قابلة للتقادم ضد الإنسانية، فإن فكرة الإنسانية نفسها يجب أن يكون لها معنى. ومع ذلك، إذا كان للإنسانية معنى من منظور حق الأمم، فلا يمكن أن يكون ذلك إلا على أساس الحق المتبادل في الضيافة، وهو ما يسميه كانط الحق الكوزموبوليتي. صحيح أن المواطنة اليوم لا يمكن التعبير عنها إلا ضمن الإطار الوطني. هذا عمل؛ وربما لا يمكن لمفهوم الكوزموبوليتي أن يشكل فكرة سياسية. تتم حاليًا مناقشة هذه النقطة كثيرًا في الفلسفة السياسية. هل يمكننا التفكير في جنسية بلا حدود؟ بمعنى آخر، هل يمكننا الخروج من التقرير الثنائي الوطني-الأجنبي؟ لقد وصلنا هنا إلى نهاية رحلتنا الأكثر تقدمًا في الفترة الفاصلة بين سفر الخروج ومتّى. لكن هذه النقطة ليست نقطة عالية. هذا ليس لا راحة، لأن هنا تبدأ كل الصعوبات. أين المشكلة الأساسية؟ هذا لأننا لا نعرف، ولا أحد يعرف، كيف نجمع بطريقة ذكية وإنسانية بين حقوق الأمم، وأساسها للحق المتبادل في الضيافة، مع البنية الثنائية للسياسة: الوطنية الأجنبية. نحن لا نعرف ذلك. لدينا فقط مبادئ الحكمة العملية. لقد رأيتها معبر عنها مؤخرًا في كتاب زميل بريطاني، بالنسبة له، فإن الشرط الأول لمجتمع متحضر هو: “لا قسوة”، بما في ذلك على الحيوانات؛ والثاني: “لا ذل”. وصية الحكمة الثالثة: ” تشريف الكرامة “. يجب أن نعيد اكتشاف المعنى العميق لكلمة شرف: نحيي باستحسان كرامة الآخر. الآخر المعترف به كنظيري. والنظير في الآخر.
- أود أن أقول بضع كلمات عن نص الدينونة الأخيرة في متى. كثيرًا ما يتم التعامل مع هذا النص بطريقة أخلاقية تُعرف باسم تحذير “تأكد من أنك لا تجد نفسك في الجانب الخطأ في اليوم الأخير”. إذا توقفنا عند هذا الحد، فإن النص لا يضيف شيئًا إلى ما قلناه بشأن واجب الضيافة، ولا يضيف حتى على صعوبات منحها مع كل القيود المرتبطة بعلاقة المواطن بالأجنبي. إن ثراء هذا النص ناتج عن تنظيم الدينونة، والتي تهدف إلى الكشف عن كل ما أخفينا، وكشفه، ومعنى ما فعلناه؛ إنها حقيقة أفعالنا التي تم إبرازها. أعتقد أن فكرة الانكشاف هذه مهمة للغاية. علاوة على ذلك، يمكننا تفسير هذا الحكم ليس فقط على أنه مشاركة بين مجموعتين من الناس، الخير من جهة والسيئة من جهة أخرى، ولكن كمشاركة داخل كل واحد منا. ثم يطرح السؤال: أي جزء مني سيتطهر بنار الله وما هو الآخر، الذي يستهكله، يعدمه …؟
أود أن أختم بملاحظة مدهشة للنص، وهي المفاجأة التي لا تقل في جانب واحد عن الأخرى: “متى، يا رب، هل رأيناك جائعًا، عطشانًا، غريبًا، مريضًا؟ أو سجينًا؟ المعسكران هما من يقول ذلك. الكل مندهش. هناك، بالطبع، إجابة في النص: “في الحقيقة، أقولها لك، بقدر ما لم تفعل ذلك مع أحد هؤلاء الصغار، ولم تفعل ذلك بالنسبة لي. لكن كان من الضروري متابعة السؤال حتى تظل الإجابة مفاجئة. أفكر إذن في هذا المثل الكتابي الآخر: “دع يدك اليمنى تتجاهل ما تعطيه يدك اليسرى. يتعلق الأمر بيدي نفس الشخص، يجب على المرء أن يتجاهل ما يمنحه الآخر أو يحجبه. الجهل المجيد باليد السخية والجهل المظلم لليد البخل. بينما تحتاج إلى أن تكون واضحًا بشأن الاستلام والحجب، لا تحاول أن تكون واضحًا جدًا بشأن العطاء والاستلام. لا نعرف. “متى يا رب رأيناك جائعًا أو عطشانًا أو عريًا أو غريبًا أو مريضًا أو سجينًا؟ ومن هم “هؤلاء الصغار” الذين يظهر الرب نفسه فيهم ويختبئ؟ السؤال لا يزال مفتوحا. الأمر متروك لنا لمنحها استجابة شخصية، استجابة اجتماعية، استجابة سياسية، استجابة إنسانية.
النقاش
سؤال: متسائلاً عن ظاهرة الرفض من الخارج، قال أحد الأشخاص: حسناً في واجب الضيافة وحق الضيافة؛ ولكن ألا يوجد في المقابل واجبات لمن يتم استلامه وليس هذا أيضًا، لأن لدى المرء انطباعًا بأن هذه الواجبات غالبًا ما يتم تجاهلها، وهو أحد أسباب الرفض؟ “
بول ريكور: بالتأكيد. صحيح أن من يتم قبوله على أراضينا يجب أن يقبل قواعد العيش معًا؛ إنها شرعية. من المؤكد أن هناك تعليمًا ضروريًا أيضًا من الخارج في هذا الصدد. كان هذا جزءًا من قواعد ديكارت الأخلاقية المؤقتة: تعلم العيش وفقًا لعادات البلد الذي تستقبل فيه. في هذه المجموعة الواسعة من الشخصيات من الخارج التي سافرت بسرعة، فإن هذا يهم الجميع، من السائح إلى طالب اللجوء. نعم، من حقنا أن نتوقع من الآخر أن يتصرف وفقًا لقوانيننا. لكن في وقت سابق، أدهشني كثيرًا التمييز الذي قدمه السيد ديلارو بين ما يتعلق بالشرعية وما يتعلق بالحساسية، وأعتقد أنه من وجهة النظر هذه، من الضروري العودة إلى الشرعية للاحتراس من حدود قدرة استقبالنا وحساسيتنا.
سؤال: ألا يوجد أحيانًا تناقض محرج في تعليم الترحيب بالأجانب؟ هل الغريب هو نفسه، فإننا نصر على أن كل الرجال متشابهون. هل الأجنبي هو الآخر، فنحن نصر على احترام حق الاختلاف. كيف يوضح هذا الكلام؟
بول ريكور: لا توجد قاعدة. لقد أصررت، في عملي الفلسفي، كثيرًا على مستوى الحياة الأخلاقية الذي أسميه “الحكمة العملية”. هذا ما أطلق عليه اللاتين والعصور الوسطى وغيرهم “الحكمة”، ليس بمعنى الاحتياطات، ولكن بمعنى صحة الاختيارات. النسبة لي ، هو تفاوض لا نهاية له بين سحرين: الانبهار بالهوية ، وما لا يتحرك ، وما هو صلب ، والافتتان بالاختلاف. وحاولت تحديدًا أن أقترح أن “الإعجاب” للمشابه كان خطًا متوسطًا، ولكنه خط منقط، يجب تحويله إلى خط ثابت، بين الهوية والاختلاف. والهوية والاختلاف مفاهيم ضخمة للغاية، بل وحتى تخمينية للغاية. فيما يتعلق بالواحد والمتعدد، قال أفلاطون: “يجب أن نتعلم كيفية إدارة الدرجات المتوسطة. هنا أيضًا، علينا إدارة الدرجات المتوسطة بين الهوية والاختلاف. الفكرة القيمة إذن هي، في رأيي، فكرة “التشابه البشري”. وأنا أدرك أنه لا يوجد الكثير من العمل من قبل الأخلاقيين حول التشابه البشري. لأننا نميل دائمًا إلى أحد الطرفين المتطرفين: الهوية والاختلاف. تقاسم الإسكان، وإدارة المدارس، والتعامل مع قضايا متشابهة، هي فكرة العدالة. لكنه يأخذ الصواب في ممارسة العدالة. وهناك حكمة فقط. كان لدى الإغريق هذه الكلمة فرونيموس، والتي تُرجمت على أنها “الانسان الحكيم”. نواجه دائمًا مواقف فريدة ونموذجية. في إدارة التفرد، من الضروري أن تسود بالضبط قوة التشابه بين الإغراء المزدوج للهوية والاختلاف.
سؤال: سؤال طرحه مهاجر شاب: ما الذي تعتمد عليه في فرنسا للعيش؟ فتشت ولم أجد، وعدت إلى انتمائي الأجنبي.
بول ريكور: السؤال يتماشى مع أفكاري. نحن لا نعرف ما الذي يشكل عضويتنا ويحددها. بالمناسبة، أشرت، دون تسمية ذلك، إلى عمل مايكل والزر، مجالات العدالة. يبدأ بفصل كبير “العضوية”. لا أعرف كيف تتم ترجمته، أعتقد أنه من خلال “الانتماء”. ومنه اقترضت هذه الفكرة التي لم نوزعها فيما بيننا. مفهوم التوزيع ليس مجرد مفهوم اقتصادي، لكنه يشير إلى توزيع الأدوار في المجتمع. نحن لا نوزع البضائع التجارية فقط. لدينا رواتب وممتلكات ومزايا ومناصب في السلطة ومناصب مسؤولية. لذلك يمكننا النظر في البنية الاجتماعية، وهي أيضًا كل عمل جون راولز، من نموذج التوزيع. ومع ذلك، فإن الانتماء هو بالضبط ما يبدو أنه يفلت من عملية التوزيع. أكثر ما أدهشني في كتاب والثر هو أنه يقول، “لكننا نعطيها للآخرين. هناك أناس يطلبون الحصول على جنسيتنا، وهي جنسية واحدة. لكننا، على أي حال، بالنسبة لأولئك الذين ولدوا كما نقول، للأسف، “من الأسهم” -، لدينا ذلك. هناك حالات حدودية، تأسيس الولايات المتحدة في مدينة القرن العاشر، حيث قام المهاجرون، بأخذ أجزاء من الانتماء، بإعادة ترتيبهم في نوع من اللغز لتشكيل دولة فيدرالية للغاية. لكنهم لم يختاروا عضويتهم. ظل المعمدان قابلاً للقدرة، وظل الكاثوليكيًا كاثوليكيًا، وظل اليهودي يهوديًا. كما احتفظوا بخصائصهم الثقافية. أعتقد أن هناك شيئًا لا ينفصم ولا يسبر غوره في هذا. حاولت أن أقول إنه لا يمكنك التحرك إلا بالخيال، والخيال الخطير، والتخيل أن تكون آخر. “إذا لم أكن أنا، إذا …” هل ترى؟ لذا فهي هاوية. نحن عالقون بين الشخصية التي لا جدال فيها أننا ما نحن عليه ومن ثم الاحتمال المجنون لتخيل شيء آخر.
سؤال: كيف ترى الأجنبي في عملية بناء الاتحاد الأوروبي؟ ماذا عن الهوية الأوروبية الجديدة؟ هل يمكننا التحدث عن هوية أوروبية جديدة؟ هل يمكننا، في النهاية، أن نتخيل أنني أمنح نفسي عدة هويات متكاملة أم أنه محكوم على أن أمتلك واحدة فقط؟
بول ريكور: أود أن أطرح السؤال على النحو التالي. يبدو أن الدولة القومية لا يمكن تجاوزها كما هي. مناطق الاختصاص مغلقة، وبالتالي هناك ظاهرة الإغلاق السياسي. يمكننا أن نفتح، ولكن ذلك دائمًا عن طريق الموافقة المتبادلة وتكافؤ الشظايا، والتنازل عن السيادة. لكن التنازل السيادي عن السيادة. ولا أعتقد أنه يمكننا حاليًا تجاوز تلك المرحلة. يمكننا أن نحاول إقامة دولة ما بعد القومية. ومع ذلك، فأنا أعتقد أن التمييز بين القومي والأجنبي مكون من العوامل السياسية. لكن هناك شيء آخر، هو الحياة الثقافية والجمالية والدينية التي تتخطى الحدود. من وجهة النظر هذه، يجب أن نفكر في أوروبا ليس كنظام للحدود يجب عبوره وجعله أكثر أو أقل قابلية للاختراق، ولكن من حيث النقاط المحورية للإشعاع التي تتداخل مع بعضها البعض. أسافر كثيرًا في أوروبا الشرقية. لقد صُدمت تمامًا لرؤية أننا في صوفيا، على سبيل المثال، نتحدث عن نفس الأشياء كما هو الحال هنا. لم أعد أرى أوروبا كنظام شبكي للحدود، ولكن كنظام متقاطع لإشعاع البؤر. السؤال هو كيف يمكن التفاوض بين نظام سياج حدودي ونظام إشعاع بؤري في المستقبل القريب؟ على سبيل المثال، يتعلق الأمر بوضع الحدود بين بولندا واستبعاد روسيا. ربما يكون من المشروع القول إن روسيا شيء آخر غير أوروبا. لكن هذا لا يمنع من العثور في مشروع القانون في موسكو على أسماء جميع الموسيقيين الكبار، شوبرت بجانب تشايكوفسكي … إنها أوروبا الثقافية، ولا شك في أن “أوروبا موجودة”. لكن ربما لا ينبغي أن تكون جزءًا – على الأقل ضمن مشروع إنساني معقول – من أوروبا السياسية. هذان نظامان فكريان سيتعين علينا التعامل معه في وقت واحد.
سؤال: أحب الغريب مثلك. لكي نحب الآخر، ألا يجب أن نحب أنفسنا أولاً؟ ما لا نحبه في ذاتنا، ألا نعرضه على الآخر؟ من المحتمل أن يكون واجب التذكر هذا مؤلمًا وهذا ما سيسمح لنا بقبول أنفسنا بشكل أفضل من أجل أن نحب الآخر مثلنا. هل الفرنسيون يحبون أنفسهم؟
بول ريكور: الحب والكراهية قريبان جدًا. وكراهية الذات ليست غريبة عن المبالغة في تقدير الذات. أفكر في هذا النص الجميل للغاية لبرنانوس. إنها، في اعتقادي، الجملة الأخيرة من يوميات كاهن بلد: “أسهل مما يعتقد المرء أن يكره نفسه. لكن نعمة النعمة هي أن تحب نفسك كأي من أعضاء يسوع المسيح المتألمين. ” ربما يكون الطريق إلى حب نفسك صعبًا مثل الطريق إلى حب الآخر، حيث يجب أن تحب الآخر مثل حبك لنفسك.
سؤال: ألا تصدق أن الغريب الأسمى هو الله نفسه. بهذا المعنى، ألا يكون للمسيحيين دور معين في المجتمع في الترحيب بالآخرين؟
بول ريكور: هذا السؤال ذو العمومية الكبيرة هو أيضًا أساس لقائنا. إنه يطرح مشكلة التعبير الدقيق عن التزاماتنا المشتركة بالمواطنة، وعناصر الأخلاق الأساسية المشتركة، ومن ثم الخصوصية المسيحية. لكن الخصوصية المسيحية هي في الأساس نموذج يسوع المسيح، أي محبة للآخر دفعت إلى حد التضحية. هذه هي شهادة الإيمان الشهيرة في فيلبي 2، 8-11. هذا ما نأتي به. إنه من خلال التمسك العميق بشيء آخر غير العموميات القوية والضرورية على الأخلاق المشتركة، لنموذج له نفسه صعوباته الداخلية التي تتمثل في التغلب على عنصر الذبيحة من خلال العنصر الطافي. “لا أحد يأخذ حياتي بعيدًا عني. أعطيها. “
سؤال: هل يمكن أن يكون التبادل جزءًا من الاعتراف بالآخر كأجنبي؟ التبادل الثقافي والحضاري، التبادل هو تبادل المعرفة والمعرفة والمهارات الشخصية والمعرفة.
بول ريكور: التبادل هو العلاقة بين العطاء والتلقي. والمثل الأعلى للتبادل هو المعاملة بالمثل. أسمح لنفسي بالتحديد، بما أنك تقترحه عليّ، بالتفكير في فكرة التبرع القريبة من فكرة التبادل. قد يكون من الضروري تجاوز فكرة معينة عن الهدية التي لن تكون سوى نصف عملية تبادل. أعني أن فكرتنا في العطاء هي التخلي عن شيء دون توقع المعاملة بالمثل. إذا تركناه هناك، فسنحصل فقط على النصف المبتور من العطاء والأخذ. الفكرة النهائية للهدية هي التبادل، أي الانتقال من التبادل التجاري حيث تكون المعاملة بالمثل في المال إلى تبادل المنحة، والتي تشمل كل من معرفة كيفية تلقي ومعرفة كيفية العطاء. خذ حالة حب الأعداء. سنقول: هذا مثال على الهبة دون المعاملة بالمثل. نعم، لكن لماذا أحب عدوه إذا لم أتوقع منه أن يصبح صديقي يومًا ما؟ وهذا يعني أنه من جهته، كما من جهتي، عكس علاقة العداء. لذلك سأقول إن التبادل هو سبب التبرع، وليس العكس. والتبادل هو معاملة الكرم بالمثل. “. انتهى الحوار
جملة القول يمكن الاحتفاظ بهذا التمييز بين حقوق الضيافة والزيارة والإقامة:” ” يمكن تعريف الضيافة على أنها مشاركة “في المنزل” تجمع بين الفعل وفن العيش. أنا أصر على مصطلح “اقامة ”: إنها الطريقة البشرية لاحتلال سطح الأرض. إنها العيش معًا. في هذا الصدد أود أن أشير إلى أن كلمة المسكونية تأتي من الكلمة اليونانية التي تعني الأرض المأهولة. حسنًا، الضيافة هي الجذر الأخلاقي لفعل العيش معًا “.
ترجمة الدكتور زهير الخويلدي / كاتب فلسفي – تونس
Paul Ricoeur, Etranger, moi-même, Conférence donnée au cours de la session 1997 des Semaines sociales de France, « L’immigration, défis et richesses », 72 semaine, 21-22-23 septembre, 1997.
الرابط:
https://www.ssf-fr.org/articles/54123-etranger-moi-meme
كاتب فلسفي