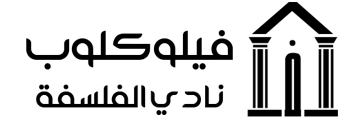موجات الحداثة الثلاث بحسب ليو شتراوس ترجمة د زهير الخويلدي
الترجمة

“قرب نهاية الحرب العالمية الأولى ظهر كتاب يحمل عنوانًا ينذر بالخطر، “تراجع الغرب”. عن طريق مصطلح “الغرب” لم يقصد سبنجلر ما نسميه الحضارة الغربية، الحضارة التي ولدت في اليونان، ولكن الثقافة التي ظهرت في حوالي عام 1000 في شمال أوروبا والتي تشمل، بشكل أساسي، الثقافة الغربية الحديثة. كان هذا الكتاب بطريقة ما رسمًا تخطيطيًا حيًا للحداثة. [1] إن وجود مثل هذه الأزمة أمر واضح الآن حتى للعقول الأقل وضوحًا. لفهم أزمة الحداثة، علينا أولاً أن نفهم ما يميزها: إن أزمة الحداثة تنكشف أو تتكون في حقيقة أن الإنسان الغربي الحديث لم يعد يعرف ما يريد، وأنه لم يعد يعتقد أنه من الممكن معرفة الخير والشر، الجيد والسيء. حتى الأجيال الأخيرة كان من المقبول عمومًا أن الإنسان يمكنه أن يعرف ما هو الخير أو الشر، ونوع المجتمع الذي هو عادل، أو جيد، أو أفضل من الآخرين؛ باختصار، تم الاعتراف بأن الفلسفة السياسية ممكنة وضرورية. لقد فقد هذا الإيمان في عصرنا كل قوته. وفقًا للرأي الأكثر انتشارًا، فإن الفلسفة السياسية مستحيلة: لقد كانت مجرد حلم، ربما مليء بالنبلاء، لكنها كانت حلماً في النهاية. في حين أن هناك اتفاقًا واسعًا على هذه النقطة، تختلف الآراء حول السؤال عن سبب استناد الفلسفة السياسية إلى خطأ جوهري. وفقًا للرأي السائد، فإن كل المعارف التي تستحق الاسم علمية. لكن المعرفة العلمية لا تستطيع إثبات صحة الأحكام القيمية، فهي تقتصر على أحكام الحقيقة. ومع ذلك، تفترض الفلسفة السياسية أنه يمكن التحقق من صحة الأحكام القيمية بشكل عقلاني. وفقًا لوجهة نظر أقل شيوعًا ولكنها أكثر تعقيدًا، فإن التمييز السائد بين الحقائق والقيم لا يمكن الدفاع عنه: مقولات الفهم تفترض، بطريقة معينة، مبادئ التقييم. ومع ذلك، فإن مبادئ التقييم هذه، بالإضافة إلى مقولات الفهم هذه، متغيرة تاريخيًا: فهي تتغير من عصر إلى آخر، ومن ثم استحالة الإجابة على سؤال الخير أو الشر، أو على السؤال المتعلق بأفضل نظام اجتماعي، في طريقة صالحة كونيًا، لجميع العصور التاريخية، كما تطالب الفلسفة السياسية. إذن، فإن أزمة الحداثة هي في الأساس أزمة الفلسفة السياسية الحديثة. قد يبدو هذا غريباً: لماذا يجب أن تكون أزمة الثقافة في الأساس أزمة نظام أكاديمي واحد من بين العديد من المجالات الأخرى؟ ومع ذلك، فإن الفلسفة السياسية ليست في الأساس تخصصًا أكاديميًا: فغالبية الفلاسفة السياسيين العظماء لم يكونوا أساتذة جامعيين. وكما هو معترف به بشكل عام، فإن الثقافة الحديثة فوق كل شيء عقلانية تمامًا. إنها تؤمن بقوة العقل. ليس هناك شك في أنه إذا فقدت مثل هذه الثقافة كل الإيمان بقدرة العقل على التحقق من صحة أهدافها العليا، فإنها يمكن أن تكون في أزمة فقط. إذن ما هي خصوصية الحداثة؟ وفقًا لمفهوم شائع جدًا، فإن الحداثة هي إيمان كتابي علماني، وهو إيمان كتابي في الحياة الآخرة أصبح جوهريًا بشكل جذري. أكثر بساطة: بدلاً من أن يأمل في الحياة السماوية، فإنه يدعو إلى إنشاء الجنة على الأرض بوسائل بشرية بحتة. لكن، هذا هو بالضبط مشروع أفلاطون في جمهوريته: القضاء على كل الشرور على الأرض بوسائل بشرية بحتة. ومع ذلك، لا يمكن القول بالتأكيد أن أفلاطون لديه إيمان كتابي علماني. إذا أردنا التحدث عن علمنة الإيمان الكتابي، فيجب أن نكون أكثر دقة إلى حد ما. على سبيل المثال، يُزعم أن روح الرأسمالية الحديثة من أصل تزمتي. أو لنأخذ مثالًا آخر، يمثل هوبز الإنسان وفقًا لقطبية أساسية، معارضة الكبرياء الخبيث للخوف القديم من الموت العنيف؛ يمكن للجميع أن يرى في هذا التمثيل نسخة علمانية من القطبية الكتابية، تعارض خطيئة الكبرياء إلى الخوف المخلص من الرب. العلمنة تعني إذن الحفاظ على الأفكار أو المشاعر أو العادات ذات الأصل الكتابي بعد ضياع أو ضمور الإيمان الكتابي. لكن هذا التعريف لا يخبرنا بأي حال عن المكونات المحفوظة في العلمنة. وفوق كل شيء، لا تخبرنا ما هي العلمنة إلا بطريقة سلبية: ضياع أو ضمور الإيمان الكتابي. ومع ذلك، كان الإنسان المعاصر يسترشد في الأصل بمشروع وضعي. من الممكن ألا يكون هذا المشروع الإيجابي قد تم تصوره دون مساعدة مكونات الإيمان الكتابي الباقية؛ لكن لا يمكن للمرء أن يقرر ما إذا كان هذا هو الحال بالفعل دون فهم المشروع نفسه أولاً. ومع ذلك، هل يمكننا التحدث عن مشروع واحد؟
ليس هناك ما يميز الحداثة أكثر من التنوع الهائل وتكرار التغييرات الجذرية التي تتضمنها. تنوع كبير لدرجة أنه يمكن للمرء أن يشك في إمكانية الحديث عن الحداثة كشيء يشكل الكل. لا يؤسس التسلسل الزمني البسيط أي وحدة ذات معنى: قد يكون هناك مفكرون في العصر الحديث لا يفكرون بطريقة حديثة. فكيف إذن الهروب من التعسف والذاتية؟ نعني بالحداثة تعديلاً جذريًا للفلسفة السياسية ما قبل الحدثية. تعديل ظهر لأول مرة كرفض للفلسفة السياسية ما قبل الحديثة. إذا كان للفلسفة السياسية ما قبل الحديثة وحدة أساسية، فسيولوجيا خاصة بها، فإن الفلسفة السياسية الحديثة التي تعارضها سيتم تمييزها بنفس الطريقة، ولو من خلال تأثير المرآة فقط. يقودنا إلى ملاحظة أن هذا هو الحال بالفعل، بعد أن حددنا بداية الحداثة بمعيار غير تعسفي. إذا خرجت الحداثة من قطيعة مع فكر ما قبل الحداثة، فلا بد أن العقول العظيمة التي أنجزت هذا الانقطاع كانت على دراية بما كانوا يحققونه. إذن، من هو أول فيلسوف سياسي رفض صراحةً كل الفلسفة السياسية السابقة باعتبارها غير كافية في الأساس، بل وحتى خاطئة؟ ليس من الصعب الإجابة: إنها تتعلق بهوبز. ومع ذلك، يُظهر الفحص الدقيق أنه على الرغم من كونه أصليًا للغاية، فإن قطع هوبز الجذري عن تقاليد الفلسفة السياسية يوسع فقط العمل الذي قام به مكيافيلي في البداية. في الواقع، شكك مكيافيلي في قيمة الفلسفة السياسية التقليدية بشكل جذري لا يقل عن هوبز. لقد ادعى بشكل لا يقل وضوحًا أن هوبز كان أصل الفلسفة السياسية الحقيقية، حتى لو عبر عن هذا الادعاء بتكتم أكثر مما كان هوبز على وشك القيام به. هناك قولان لمكيافيلي يشيران إلى نيته العامة بأكبر قدر من الوضوح. يمكن تلخيص الأول على النحو التالي: ميكافيللي على خلاف عميق مع الآخرين حول السلوك الذي يجب أن يتخذه الأمير تجاه رعاياه أو أصدقائه، لأنه مهتم، من جانبه، بالحقيقة الواقعية والعملية، وليس بالوهم. تخيل العديد من المؤلفين جمهوريات وإمارات لم تظهر إلى الوجود أبدًا، وذلك لأنهم درسوا الطريقة التي يجب أن يعيش بها البشر بدلاً من الطريقة التي يعيشون بها بالفعل. يقارن مكيافيلي بين مثالية الفلسفة السياسية التقليدية ومقاربة واقعية للأمور السياسية. لكن هذا نصف الحقيقة فقط (بمعنى آخر، الواقعية من نوع خاص). النصف الآخر، يعبر عنه مكيافيلي بهذه المصطلحات: الثروة [2] امرأة لا يمكن السيطرة عليها بالقوة. لفهم نطاق هاتين الملاحظتين، يجب أن نتذكر أن الفلسفة السياسية الكلاسيكية كانت بحثًا عن أفضل نظام سياسي أو أفضل نظام، يُفهم على أنه الأكثر ملاءمة لممارسة الفضيلة أو أسلوب الحياة الذي يجب أن يمارسه البشر. علاوة على ذلك، ووفقًا للفلسفة السياسية الكلاسيكية، فإن إنشاء أفضل نظام يعتمد بالضرورة على الظروف العرضية أو على ثروة تفلت من كل السيطرة والاستيلاء. وفقًا لجمهورية أفلاطون، على سبيل المثال، لكي يظهر أفضل نظام يجب أن يكون هناك مصادفة، تقارب غير محتمل بين الفلسفة والسلطة السياسية. مع الواقعية المفترضة، يتفق أرسطو مع أفلاطون على هذين الجانبين المهمين: أفضل نظام غذائي هو الترتيب الأكثر ملاءمة لممارسة الفضيلة، وتحقيق أفضل نظام غذائي يعتمد على الظروف العرضية. لأنه، بالنسبة لأرسطو، لا يمكن إنشاء أفضل نظام إذا لم يكن لدى المرء الركيزة المناسبة، أي إذا كانت طبيعة الإقليم والشعب لا تتناسب مع النظام الأفضل؛ لا يعتمد توافر أو عدم توفر هذه الركيزة على المؤسس، ولكن على الظروف العرضية. يبدو أن مكيافيلي يتفق مع أرسطو عندما يقول إنه لا يمكن للمرء أن يؤسس النظام السياسي المرغوب إذا كانت الطبقة التحتية فاسدة، أي إذا كان الناس فاسدين. لكن ما يعتبره أرسطو استحالة بالنسبة لمكيافيلي هو مجرد صعوبة كبيرة جدًا: صعوبة يمكن لرجل فوق العادي التغلب عليها باستخدام وسائل غير عادية لتحسين ركيزة فاسدة. يمكن التغلب على هذه العقبة أمام إنشاء أفضل نظام، والذي يشكل الإنسان كركيزة، لأن هذه الركيزة قابلة للتحويل. ما يسميه مكيافيلي الجمهوريات الخيالية للمؤلفين الذين سبقوه، يقوم على مفهوم محدد للطبيعة يرفضه ضمنيًا إلى حد ما. وفقًا لهذا المفهوم، تتجه جميع الكائنات الطبيعية، على الأقل جميع الكائنات الحية، نحو غاية، نحو الكمال الذي يطمحون إليه. هناك كمال محدد ينتمي إلى كل طبيعة محددة؛ على وجه الخصوص، هناك كمال للإنسان تحدده طبيعة الإنسان كحيوان عقلاني واجتماعي. ووفقًا لهذا المفهوم أيضًا، توفر الطبيعة القاعدة، وهي قاعدة مستقلة تمامًا عن إرادة الإنسان، مما يعني أن الطبيعة جيدة. سيحتل الإنسان مكانًا معينًا في الكل، مكانًا مرموقًا جدًا. يمكن للمرء أن يقول إن الإنسان سيكون مقياس كل الأشياء أو أن الإنسان سيكون العالم المصغر، لكن بطبيعته سيشغل هذا المكان: سيحتل الإنسان مكانه بترتيب لم يخلقه. “الإنسان هو مقياس كل شيء” هو عكس “الإنسان سيد كل شيء”. يحتل الإنسان مكانًا في الكل: قوة الإنسان محدودة، ولا يستطيع الإنسان التغلب على حدود طبيعته. طبيعتنا مستعبدة من نواحٍ عديدة (أرسطو) حيث نحن ألعوبة الآلهة (أفلاطون). يمكن رؤية هذه الشخصية المحدودة، على وجه الخصوص، في قوة الصدفة التي لا مفر منها: العيش بشكل جيد هو العيش وفقًا للطبيعة، مما يعني عدم تجاوز حدود معينة. الطبيعة هي في الأساس اعتدال. لا يوجد فرق في هذا الصدد بين الفلسفة السياسية الكلاسيكية ومذهب المتعة الكلاسيكي اللاسياسي: إنه ليس الحد الأقصى من الملذات المرغوبة، بل هو أنقى الملذات. تعتمد السعادة، بشكل حاسم، على حدود رغباتنا. لتقدير عقيدة مكيافيلي بشكل صحيح، يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه في نقطة حاسمة تتفق الفلسفة السياسية مع الكتاب المقدس، أن أثينا تتفق مع المقدسي، على الرغم من الاختلاف الكبير، وحتى العداء، بين أثينا والقدس. وفقًا للكتاب المقدس، الإنسان مخلوق على صورة الله، وهو مؤتمن على حكومة جميع المخلوقات على الأرض. إنه ليس مؤتمنًا على إدارة كل شيء، فقد وضع في حديقة لزراعتها وحراستها: تم تخصيص مكان له، والخير هو احترام النظام الذي أنشأه الله. كما هو الحال في الفكر الكلاسيكي، فإن العدالة هي التطابق مع النظام الطبيعي. إلى الاعتراف بثروة مراوغة يتوافق مع الاعتراف بالعناية التي لا يمكن اختراقها. يرفض مكيافيلي التقليد الفلسفي واللاهوتي بأكمله. يمكننا تقديم منطقه على النحو التالي. يؤدي الموقف التقليدي إما إلى عدم أخذ الأمور السياسية على محمل الجد (الأبيقورية) أو إلى فهمها من منظور الكمال الخيالي، وبعبارة أخرى للجمهوريات والإمارات الخيالية، وأشهرها مملكة الله. [لكن، وفقًا لمكيافيللي] يجب أن نبدأ من الطريقة الحقيقية لحياة البشر؛ يجب خفض نقطة الهدف. النتيجة الطبيعية المباشرة لهذا الطرح هي إعادة تفسير الفضيلة: لا ينبغي فهم الفضيلة على أنها ما توجد من أجله الجمهورية، بل إن الفضيلة موجودة حصريًا من أجل الجمهورية. الحياة السياسية، بالمعنى الدقيق للكلمة، لا تخضع للأخلاق، والأخلاق غير ممكنة خارج المجتمع السياسي. لا يمكن تأسيس المجتمع السياسي والحفاظ عليه بالبقاء ضمن حدود الأخلاق، لسبب بسيط هو أن التأثير أو الشرط لا يمكن أن يسبق السبب أو الشرط. علاوة على ذلك، فإن إنشاء حتى أكثر المجتمعات السياسية المرغوبة لا يعتمد على الصدفة، لأنه يمكن غزوها، أو لأن الركيزة الفاسدة يمكن أن تتحول إلى ركيزة خالية من الفساد. يمكن ضمان حل المشكلة السياسية، (أ) لأن الهدف المنشود أقل سامية، أي أنه متوافق مع ما يرغب فيه معظم الرجال بالفعل، و (ب) لأنه يمكن التغلب على المصادفة. تصبح المشكلة السياسية مشكلة فنية. لنضعها على طريقة هوبز، “عندما تنحل الجمهوريات تحت تأثير الخلاف الداخلي، لا يُنسب الخطأ إلى الرجال لأنهم الركيزة، ولكن لأنهم بناتها. الركيزة ليست تالفة ولا تالفة. لا يوجد شر في الإنسان لا يمكن السيطرة عليه. هذا لا يتطلب نعمة إلهية، وأخلاق، وتكوين شخصية، ولكن مؤسسات قوية. أو، على حد تعبير كانط، لا يتطلب إنشاء نظام اجتماعي جيد، كما يقال عادة، شعبًا من الملائكة: “مشكلة مؤسسة الدولة [الدولة جيدة التنظيم]، مهما كان من الصعب سماعها ، مع ذلك ، ليست غير قابلة للذوبان ، حتى بالنسبة لشعب الشياطين ، بشرط أن يكون لديهم بعض الذكاء “، بعبارة أخرى ، بشرط أن تكون أنانيتهم مستنيرة. إن المشكلة السياسية الأساسية هي ببساطة مشكلة “التنظيم الجيد للدولة، التي يتمتع الإنسان بقدراتها المؤكدة”. لإنصاف التغيير الذي أجراه مكيافيلي ، يجب أن نأخذ في الاعتبار تغييرين كبيرين ، على الرغم من أنهما بعده ، يشتركان في نفس الروح. الأول هو الثورة التي تؤثر على العلوم الطبيعية، أي ظهور العلوم الطبيعية الحديثة. دمر رفض الأسباب النهائية (وبالتالي أيضًا مفهوم الثروة) الأساس النظري للفلسفة السياسية الكلاسيكية. يختلف علم الطبيعة الجديد عن الأشكال المختلفة التي يفترضها القديم، ليس فقط من خلال مفهوم جديد للطبيعة ولكن أيضًا وقبل كل شيء من خلال مفهوم جديد للعلم: لم يعد يُنظر إلى المعرفة على أنها متقبلة بشكل أساسي، ومبادرة الفهم قيد التشغيل جانب الإنسان، وليس جانب النظام الكوني. في سعيه وراء المعرفة، يستدعي الإنسان الطبيعة إلى محكمة عقله، “يضع الطبيعة موضع تساؤل” (بيكون): المعرفة نوع من الفعل، والفهم البشري يفرض قوانينها على الطبيعة. إن قوة الإنسان أعظم بلا حدود مما كان يعتقد سابقًا: لا يستطيع الإنسان فقط تحويل طبقة بشرية فاسدة إلى طبقة أساسية بشرية خالية من الفساد، أو قهر العارض، ولكن كل الحقيقة والمعنى ينشئان في الإنسان، فهي ليست متأصلة في نظام كوني مستقل عن النشاط البشري. نسبيًا، لم يعد يُفهم الشعر على أنه تقليد أو استنساخ ملهم ليصبح إبداعًا. يتم إعادة تفسير هدف العلم: القوة [على الطبيعة]، والتخفيف من حالة الإنسان، وغزو الطبيعة، والسيطرة القصوى، والسيطرة المنهجية على الظروف الطبيعية لحياة الإنسان. يعني غزو الطبيعة أن الطبيعة هي العدو، وأن الفوضى هي التي يجب اختزالها في النظام. كل ما هو جيد يرجع إلى العمل البشري بدلاً من هبة الطبيعة، فالطبيعة توفر فقط المواد التي لا قيمة لها تقريبًا. وبالتالي، فإن المجتمع السياسي بالتأكيد ليس طبيعيًا: فالدولة ليست سوى قطعة أثرية، بسبب الاتفاقيات؛ إن كمال الإنسان ليس النهاية الطبيعية للإنسان، بل هو المثل الأعلى الذي شكله. التغيير الثاني بعد مكيافيلي ، والذي يشترك في نفس الروح ، يتعلق فقط بالفلسفة السياسية أو الأخلاقية. لقد قطع مكيافيلي تمامًا الصلة بين السياسة والقانون الطبيعي أو القانون الطبيعي، أي بين السياسة والعدالة التي تُفهم على أنها شيء مستقل عن التعسف البشري. لم تأخذ الثورة الميكافيلية القوة الكاملة إلا عندما أعيد تأسيس هذه الصلة: عندما أعيد تفسير العدالة، أو القانون الطبيعي، بروح مكيافيلي. تم تنفيذ المهمة بشكل رئيسي من قبل هوبز. يمكن وصف التغيير الهوبزي [3] على النحو التالي: في حين أن القانون الطبيعي قبله كان مفهومًا في ضوء التسلسل الهرمي لنهايات الإنسان حيث احتل الحفاظ على حياة الفرد أدنى درجة، صمم هوبز القانون الطبيعي فقط من حيث من هذا الحفظ. نسبيًا، تم تصور القانون الطبيعي بشكل أساسي من حيث الحق في الحفظ، وتمييز هذا الحق عن أي التزام أو واجب. ويبلغ هذا التطور ذروته في استبدال حقوق الإنسان بالقانون الطبيعي (الإنسان يحل محل الطبيعة؛ والحقوق تحل محل القانون). بالفعل، في هوبز نفسه، يشمل الحق الطبيعي في الحفاظ على الذات الحق في “الحرية الجسدية” وفي حالة ذهنية لا يشعر فيها الإنسان بالاشمئزاز من الحياة، والتي هي قريبة من الحق في الحفاظ على الرفاهية، والتي تشكل محور تعاليم لوك. في هذه المرحلة، لا يسعني إلا أن أؤكد أن الأهمية المتزايدة المعطاة للاقتصاد هي نتيجة لهذا التطور. في النهاية توصلنا إلى فكرة أن الثروة والسلام العالميين هما الشرط الضروري والكافي للعدالة الكاملة. تظهر الموجة الثانية من الحداثة مع روسو. غيّر هذا المفكر المناخ الأخلاقي للغرب بشكل عميق مثل مكيافيلي. تمامًا كما فعلت مع الأخير، سأصف فكر روسو بالتعليق على اثنتين أو ثلاثة من ملاحظاته. اتسمت الموجة الأولى من الحداثة باختزال المشكلة الأخلاقية والسياسية إلى مشكلة فنية، وبتصميم مفهوم الطبيعة الذي يتطلب الحضارة تغطيتها [بالورنيش] كما [قد] بالنسبة لشيء ما [4] [الفاتورة] الاولية. يستهدف نقد روسو هاتين الخاصيتين. أما الأول، فقد تحدث السياسيون القدامى باستمرار عن الأخلاق والفضيلة؛ حديثنا عن التجارة والمال “. احتج روسو باسم الفضيلة، على الفضيلة غير النفعية الأصيلة الخاصة بالجمهوريات الكلاسيكية، ضد المذاهب المهينة والمثبطة للعزيمة لأسلافه. لقد عارض كلاً من الروح الخانقة للملكية المطلقة والنزعة التجارية الساخرة إلى حد ما في الجمهوريات الحديثة. ومع ذلك، لم يستطع استعادة المفهوم الكلاسيكي للفضيلة كنهاية طبيعية للإنسان، وكمال الطبيعة البشرية. لقد أُجبر على إعادة تفسير الفضيلة لأنه تبنى المفهوم الحديث لحالة الطبيعة، كالحالة التي يجد الإنسان نفسه فيها في البداية. لم يأخذ هذا المفهوم من خلفاء هوبز وهوبز فحسب؛ لقد فكر في الأمر حتى استنتاجه: “لقد شعر الفلاسفة الذين درسوا أسس المجتمع جميعًا بضرورة العودة إلى حالة الطبيعة، لكن لم يصل أحد منهم إلى هناك”. في الواقع، وصل روسو إلى هناك لأنه رأى أن الرجل في حالة الطبيعة هو رجل جرد من كل ما حصل عليه بجهوده الخاصة. الإنسان في حالة الطبيعة هو دون الإنسان أو ما قبل الإنسان؛ لقد تم اكتساب إنسانيتها أو عقلانيتها من خلال عملية طويلة. في لغة ما بعد روسو، لا تعود إنسانية الإنسان إلى الطبيعة بل إلى التاريخ، إلى العملية التاريخية. عملية مفردة أو خطية ليست غائية: لم تكن نهاية العملية أو ذروتها متوقعة أو متوقعة، ولكنها ظهرت فقط مع ظهور إمكانية تحقيق العقلانية أو إنسانية الإنسان بالكامل. إن مفهوم التاريخ، أي مفهوم العملية التاريخية كعملية خطية، يصبح فيها الإنسان إنسانًا عن غير قصد، هو نتيجة لتطرف روسو لمفهوم هوبز عن حالة الطبيعة. لكن، كيف يمكن معرفة أن مرحلة معينة من تطور الإنسان تمثل أوج حياته؟ أو، بشكل عام، كيف نميز الخير عن الشر إذا كان الإنسان بطبيعته دون البشر، إذا كانت حالة الطبيعة دون البشر؟ دعونا نكرر: الإنسان الطبيعي لروسو لا يفتقر فقط إلى الاجتماعية، مثل الإنسان الطبيعي لهوبز، ولكن أيضًا يفتقر إلى العقلانية. إنه ليس الحيوان العقلاني، بل هو الحيوان الذي يتمتع بحرية التصرف، أو بتعبير أدق قدرة لا حدود لها على الكمال أو المرونة. ولكن كيف يجب أن يتم تشكيلها أو تشكيلها بنفسها؟ لا ينبغي أن تكون طبيعة الإنسان كافية لتوجيهه على الإطلاق. التوجه الذي يعطيه له يقتصر على هذا: في ظل ظروف معينة، أي في مرحلة معينة من تطوره، يكون الإنسان غير قادر على الحفاظ على نفسه إلا من خلال إنشاء مجتمع مدني. من ناحية أخرى، قد يعرض الحفاظ عليه للخطر إذا لم يضمن أن المجتمع المدني لديه بنية محددة، و بنية مواتية للحفاظ عليه. يجب أن يجد الإنسان في المجتمع المعادل الكامل للحرية التي يمتلكها في حالة الطبيعة؛ يجب أن يخضع جميع أفراد المجتمع بشكل متساوٍ وكامل للقوانين الناتجة عن مساهمات كل منهم. يجب أن يكون من المستحيل الطعن في القوانين، القوانين الوضعية، إلى قانون أعلى، إلى قانون طبيعي، لأن مثل هذا الاستئناف من شأنه أن يضر بسلطة القوانين. مصدر القانون الوضعي، ولا شيء غير القانون الوضعي، هو الإرادة العامة. تحل الإرادة المتأصلة أو الجوهرية في مجتمع مشكل بشكل صحيح محل القانون الطبيعي المتعالي. بدأت الحداثة بالاستياء الذي أثارته الهاوية التي تفصل الكائن عن ما يجب أن يكون، الحقيقي عن المثالي. كان الحل الذي اقترحته الموجة الأولى كالتالي: التقريب بين ما يجب أن يكون عن طريق خفض ما يجب أن يكون، من خلال تصور ذلك بطريقة لا تتطلب الكثير من البشر أو يتم منحها لأقوى وأقوى. الشغف الأكثر شيوعًا. على الرغم من هذا الانخفاض، ظل الاختلاف الأساسي بين الوجود والحاجة إلى الوجود؛ لم يستطع هوبز نفسه أن ينكر بشكل صريح وبسيط أنه من المشروع الاستئناف من الكينونة، من النظام القائم، إلى ما يجب أن يكون، إلى القانون الطبيعي أو الأخلاقي. إن تصور روسو للإرادة العامة، الذي لا يمكن أن يخطئ، على هذا النحو – والذي، بمجرد وجوده، هو ما يجب أن يكون – أظهر كيف يمكن التغلب على الهاوية التي تفصل بين الوجود والواجب. بالمعنى الدقيق للكلمة، أظهر روسو هذا فقط بشرط أن تكون عقيدته عن الإرادة العامة، وعقيدته السياسية تتحدث بشكل صحيح، مرتبطة بعقيدته في العملية التاريخية؛ صلة الوصل التي كانت من عمل خلفاء روسو وكانط وهيجل العظماء، وليس روسو نفسه. وفقًا لهذا المفهوم، فإن المجتمع العقلاني أو العادل، والمجتمع الذي يتميز بوجود إرادة عامة معترف بها على أنها الإرادة العامة، أي المثالية، تتحقق بالضرورة من خلال العملية التاريخية، دون أن يقصد الناس تحقيقها. ما الذي يسمح للجنرال بأن لا يخطئ؟ لماذا الجنرال الإرادة بالضرورة جيدة؟ الجواب: حسن لأنه عقلاني، وعقلاني لأنه عام. إنه ينبثق من تعميم الإرادة الخاصة، للإرادة التي ليست جيدة على هذا النحو. ما يرى روسو هو ضرورة أن يتحول كل فرد، في مجتمع جمهوري، إلى قوانين رغباته وكل ما يطلبه من مواطنيه. لا يستطيع أن يقول فقط، “لا أريد أن أدفع الضرائب”؛ يجب أن تقترح قانونًا يلغيها. بتحويل رغبته إلى قانون محتمل، يصبح مدركًا لجنون إرادته الأولى أو إرادته الخاصة. لذلك، فإن العمومية البسيطة للإرادة هي التي تضمن أنها جيدة: ليست هناك حاجة للجوء إلى اعتبار لنظام آخر، إلى أي مراعاة لطبيعة الإرادة. الكمال يتطلب. هذا الفكر الذي يصنع الحقبة هو في عقيدة كانط الأخلاقية التي وصلت إلى وضوحها الكامل. يكفي، من أجل الاعتراف بمبدأ جيد، أنه يمكن أن يصبح مبدأ تشريعًا عالميًا. إن الشكل البسيط لعقلانيتها ، أي عالميتها ، يضمن جودة المحتوى. لذلك، فإن القوانين الأخلاقية، كقوانين الحرية، لم تعد تُفهم على أنها قوانين طبيعية. يتم تأسيس المُثل الأخلاقية والسياسية دون الرجوع إلى الطبيعة البشرية: فقد تحرر الإنسان جذريًا من وصاية الطبيعة. بعض الحجج ضد المثالية المستمدة من الطبيعة البشرية، كما هو معروف لتجربة العصور التي لا جدال فيها، لم تعد ذات أهمية: ما يسمى بالطبيعة البشرية هو ببساطة نتيجة التطور السابق للإنسان، إنه ببساطة ماضيه، التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بمثابة دليل لمستقبل الإنسان المحتمل. الدليل الوحيد للمستقبل، لما يجب أن يفعله البشر أو يطمحون إليه، يتم توفيره عن طريق العقل. العقل يحل محل الطبيعة. هذا هو معنى العبارة التي يجب أن تكون لا أساس لها في الوجود.
الكثير من أجل ما ألهمه، في فكر روسو، كانط والفلسفة المثالية الألمانية، فلسفة الحرية. لكن هناك فكرة أساسية أخرى في روسو، لا تقل أهمية عن تلك التي أشرت إليها، والتي، على الرغم من تخليها من قبل كانط وخلفائه، قد أثمرت في جزء آخر من العالم الحديث. قبلت المثالية الألمانية مفهوم الإرادة العامة وآثار هذا المفهوم وجعلته متطرفًا. لكنه تخلى عن الطريقة التي أطلق عليها روسو نفسه هذا المنطق. “ولد الإنسان حراً، وفي كل مكان هو في الحديد (…). كيف حدث هذا التغيير؟ لا أعلم. ما الذي يمكن أن يجعلها شرعية؟ أعتقد أنني أستطيع حل هذه المشكلة “. أي أن المجتمع الحر، المجتمع المتميز بوجود إرادة عامة بداخله، يتميز عن المجتمع المحكوم بالاستبداد، حيث تتميز العبودية المشروعة عن العبودية غير الشرعية. هي نفسها عبودية. لا يستطيع الإنسان أن يجد حريته في أي مجتمع، ولا يمكنه أن يجد حريته إلا من خلال العودة من المجتمع، مهما كان جيدًا وشرعيًا، إلى الطبيعة. بعبارة أخرى، الحفاظ على الذات، هذا المحتوى للحق الطبيعي الأساسي الذي يُشتق منه العقد الاجتماعي، ليس هو الحقيقة الأساسية. لن يكون هناك خير في الحفظ إذا كانت الحياة نفسها، إذا لم يكن مجرد الوجود جيدًا. يتم اختبار جودة الوجود النقي في الشعور بالوجود. وهذا الشعور هو الذي يثير الاهتمام بالحفاظ على الوجود، لأنه يثير كل نشاط بشري. لكن هذا القلق يعيق التمتع الأساسي ويجعل الإنسان بائسًا. فقط العودة إلى التجربة الأساسية يمكن أن تجعل الإنسان سعيدًا. نادرًا ما يكون البشر قادرون على تحقيق ذلك، في حين أن جميعهم تقريبًا قادرون على التصرف وفقًا للحق في الحفظ وما ينبع منه، أي العيش كمواطن. يجب على المواطن أداء واجبه: يجب أن يكون المواطن فاضلاً. لكن الفضيلة ليست لطفًا. اللطف (الحساسية والرحمة) الذي يخلو من الإحساس بالواجب أو الالتزام، وبدون جهد – ولا فضيلة بدون جهد – محجوز للإنسان الطبيعي، الإنسان الذي يعيش على هامش المجتمع دون أن يكون جزءًا منه. هناك هوة لا يمكن التغلب عليها بين عالم الفضيلة والعقل والحرية الأخلاقية والتاريخ من جهة وعالم الطبيعة والحرية الطبيعية والخير من جهة أخرى. يبدو من الضروري هنا ملاحظة عامة حول مفهوم الحداثة. تم تصور الحداثة منذ البداية في مواجهة العصور القديمة، لذلك كانت الحداثة قادرة على تضمين عالم القرون الوسطى. تم إعادة تفسير الفرق بين العصر الحديث والعصور الوسطى من ناحية، والعصور القديمة من ناحية أخرى، في حوالي عام 1800 على أنه الفرق بين الرومانسية والكلاسيكية. في أضيق معانيها، حددت الرومانسية حركة الفكر والحساسية التي كان روسو هو البادئ بها. لا شك أن الرومانسية أكثر حداثة من الكلاسيكية بأشكالها المختلفة. لعل أفضل وثيقة للصراع المثمر بين الحداثة والعصور القديمة، كصراع بين الرومانسية والكلاسيكية، هو كتاب جوته فاوست. وصف الرب نفسه فاوست بأنه “شخص صالح”. هذا الانسان الطيب يرتكب جرائم فظيعة، خاصة وعامة. سأترك جانبًا حقيقة أنه قد تم تخليصه بفعل عام مفيد، بفعل يمكّنه من الوقوف على أرض حرة وسط شعب حر، وأن هذا العمل السياسي المفيد ليس إجراميًا ولا ثوريًا، بل بشكل صارم وشرعي. أصبح ذلك ممكنا من خلال التنازل عن فاوست من إقطاعية منحه له الإمبراطور الجرماني. أقتصر على التأكيد على أن خير فاوست ليس فضيلة بالتأكيد. بعبارة أخرى، كان روسو هو من فتح الأفق الأخلاقي لأشهر أعمال جوته. صحيح أن خير فاوست لا يتطابق مع الخير بالمعنى الروسي. في حين أن لطف روسو مصحوب بالامتناع عن الفعل، نوع من الهدوء، فإن لطف فاوست هو القلق، الكفاح المستمر، الاشمئزاز من كل شيء انتهى، مكتمل، كامل، “كلاسيكي”. كانت أهمية فاوست للحداثة، بالنسبة لتصوير الإنسان الحديث لنفسه كإنسان حديث، قد تم تقديرها بحق من قبل سبنجلر ، الذي أطلق على الرجل المعاصر رجل فاوستي. يمكننا القول إن شبنجلر استبدل “رومانسي” بكلمة “فواستية” في وصفه لشخصية الحداثة. مثلما ترتبط الموجة الثانية من الحداثة بروسو، فإن الموجة الثالثة مرتبطة بنيتشه. يواجهنا روسو التناقض بين الطبيعة، من ناحية، والمجتمع المدني، والعقل، والأخلاق، والتاريخ من ناحية أخرى، بحيث تكون الظاهرة الأساسية هي المشاعر المباركة. التي تنتمي بالكامل إلى الطبيعة، والتي هي إلى جانبها تمامًا بقدر ما تتميز عن العقل والمجتمع. يمكن وصف الموجة الثالثة بأنها تتكون من مفهوم جديد للشعور بالوجود. هذا الشعور الجديد ليس تجربة الانسجام والسلام بقدر ما هو الرعب والكرب. إنه الشعور بالوجود التاريخي باعتباره مأساويًا بالضرورة. ليست مشكلة الإنسان فقط غير قابلة للحل كمشكلة اجتماعية، كما قال روسو، ولكن ليس هناك مفر من الإنسان في الطبيعة. لا توجد إمكانية للسعادة الحقيقية، وإلا فإن أعظم إنجاز للإنسان لا علاقة له بالسعادة. أقتبس من نيتشه: “يقع على عاتق جميع الفلاسفة خطأ البدء من انسان اليوم والاعتقاد بأنهم يستطيعون الوصول إلى هدفهم من خلال تحليل رجل اليوم. إن الافتقار إلى المعنى التاريخي هو الخطأ الوراثي لجميع الفلاسفة. نقد نيتشه لجميع الفلاسفة السابقين هو إعلان جديد لنقد روسو لهم. لكن ما له معناه الكامل في روسو غريب جدًا عند نيتشه؛ حدث اكتشاف التاريخ بين روسو ونيتشه. إن القرن الذي يفصل روسو عن نيتشه هو عصر الحس التاريخي. يشير نيتشه إلى هذا: لقد أسيء فهم جوهر القصة حتى الآن [5]. هيجل هو أهم فيلسوف في التاريخ. بالنسبة لهيجل، كانت العملية التاريخية عملية عقلانية ومعقولة، تتويجًا للتقدم في الدولة العقلانية، دولة ما بعد الثورة. المسيحية هي الدين الحق أو الدين المطلق. لكن المسيحية تتمثل في مصالحتها مع العالم، مع المنهج، في علمنة كاملة، وهي عملية بدأت مع الإصلاح، واستمر عصر التنوير واستكمل في حالة ما بعد الثورة، وهي أول دولة تقوم بوعي على الاعتراف حقوق الانسان. عند هيجل، نحن مضطرون بالفعل إلى القول إن جوهر الحداثة هو المسيحية العلمانية، لأن العلمنة هي مقصد هيجل بوعي وصريح. وفقًا لهيجل، هناك إذن نقطة ذروة ونهاية للتاريخ، مما يسمح له بالتوفيق بين فكرة الحقيقة الفلسفية وحقيقة أن كل فيلسوف هو ابن عصره: الحقيقة ونهاية الفلسفة تنتمي إلى لحظة تاريخية مطلقة، إلى ذروة التاريخ. رفض الفكر ما بعد الهيجلي فكرة أن التاريخ يمكن أن يكون له نهاية أو قمة. لقد تصور السيرورة التاريخية على أنها غير مكتملة وغير قابلة للفساد، مع الحفاظ على الاعتقاد، الذي لا أساس له الآن، في تقدم العملية التاريخية وعقلانيتها. كان نيتشه أول من واجه هذا الموقف [6] إن التصور [7] بأن جميع مبادئ الفكر والفعل تاريخية لا يمكن إضعافه بأمل لا أساس له في العقلانية والتقدم والتوجه الجوهري للتسلسل التاريخي لهذه المبادئ. جميع المُثُل هي نتيجة الأعمال الإبداعية التي حققها الإنسان، والمشاريع البشرية الحرة، التي تشكل الأفق الذي تمكنت فيه ثقافات معينة من التطور. إنها ليست منظمة في نظام، ولا توجد إمكانية لإحداث توليفة حقيقية. ومع ذلك، ادعت جميع المُثُل المعروفة أنها تستند إلى دعم موضوعي: الطبيعة أو الله أو العقل. يدمر الإدراك التاريخي هذا الادعاء ومعه كل المُثُل المعروفة. لكن فهم الأصل الحقيقي لجميع المُثُل، وفهم أنها تنبع من إبداعات أو مشاريع بشرية، هو بالضبط ما يجعل مشروعًا من نوع جديد جذريًا ممكنًا، ما يجعل من الممكن تحويل جميع القيم: مشروع منسجم مع التصور الجديد، على الرغم من أنه لا يمكن استنتاجه منه (وإلا فلن يكون بسبب عمل إبداعي). لكن، ألا يعني كل هذا أن الحقيقة قد تم اكتشافها أخيرًا – حقيقة كل المبادئ الممكنة للفكر والعمل؟ يبدو أن نيتشه يميل أحيانًا إلى الاعتراف بذلك، ويميل أحيانًا إلى تقديم فهمه للحقيقة كمشروعه الخاص أو تفسيره الخاص. في الواقع، اختار الموقف الأول، وكان يعتقد أنه اكتشف الوحدة الأساسية للإبداع البشري ولجميع الكائنات: “أينما وجدت الحياة، وجدت إرادة القوة”. إن تحويل جميع القيم التي يسعى نيتشه إلى تحقيقها يتم تبريره في نهاية المطاف بحقيقة أنه متجذر في أعلى إرادة للسلطة – في إرادة قوة أعلى من تلك التي أدت إلى ظهور جميع القيم السابقة. لم يكن الإنسان كما كان حتى ذلك الحين، ولا حتى الإنسان في ذروته، ولكن فقط الرجل الخارق هو الذي سيكون قادرًا على العيش وفقًا لتحول جميع القيم. التصور النهائي للوجود يقود إلى المثالية الغائية. لا يدعي نيتشه، مثل هيجل، أن الإدراك النهائي يتبع تحقيق المثالية الغائية. في هذا الصدد، فإن وجهة نظر نيتشه تشبه وجهة نظر ماركس. ومع ذلك، هناك اختلاف جوهري بين نيتشه وماركس: بالنسبة لماركس، يجب بالضرورة أن يتحقق المجتمع اللاطبقي، بينما بالنسبة لنيتشه، فإن مجيء الرجل الخارق يعتمد على الاختيار الحر للإنسان. لا يوجد سوى يقين واحد لنيتشه فيما يتعلق بالمستقبل: إنها نهاية الإنسان كما كان حتى الآن. ما سيحدث سيكون إما سوبرمان أو آخر رجل. الرجل الأخير، الانسان الأكثر انخفاضًا والأكثر سقوطًا، الانسان الاجتماعي الخالي من المُثُل أو التطلعات، لكنه يتغذى جيدًا ، وملبس جيدًا ، ومُسكنًا جيدًا ، ويهتم به الأطباء والأطباء النفسيون العاديون ، هو رجل المستقبل الماركسي الذي يُنظر إليه من معادٍ. – وجهة نظر الماركسية. ومع ذلك، على الرغم من المعارضة الجذرية بين ماركس ونيتشه، فإن الحالة النهائية المتطرفة تتميز في نظر نيتشه وماركس بأنها تمثل نهاية عهد الثروة: لأول مرة، سيكون الانسان سيد مصيره. ومع ذلك، هناك صعوبة خاصة بنيتشه. بالنسبة لنيتشه، أي حياة بشرية أصيلة، فإن أي ثقافة عالية تقدم بالضرورة طابعًا هرميًا أو أرستقراطيًا. يجب أن تتوافق أعلى ثقافة في المستقبل مع النظام الهرمي الطبيعي بين البشر، وهو نسق يتصوره نيتشه، من حيث المبدأ، وفقًا لمخطط أفلاطوني. ولكن كيف يمكن أن يكون هناك ترتيب هرمي طبيعي، بالنظر إلى القوة اللانهائية تقريبًا للانسان الخارق؟ من ناحية أخرى، بالنسبة لنيتشه، فإن حقيقة أن البشر هم في الغالب معيبون أو مجزؤون لا يمكن أن تُنسب إلى سلطة الطبيعة، ولا يمكن أن تكون أكثر من إرث الماضي، أو التاريخ على هذا النحو. الحالي. لتجنب الصعوبة الناتجة، أي لتجنب الرغبة في المساواة بين جميع الرجال عندما يكون الإنسان في أوج قوته، يحتاج نيتشه إلى الطبيعة أو الماضي، كسلطة أو على الأقل كمثال يمكن من خلاله لا يستطيع المرء الهروب. ولكن بمجرد أن تصبح حقيقة لا يمكن دحضها بالنسبة له، يجب عليه أن يفعلها أو يفترضها. وهذا هو معنى مذهبه بالعودة الأبدية. يجب أن تكون عودة الماضي، للماضي كله، إرادة حتى يصبح الانسان الخارق ممكنًا. من المؤكد أن طبيعة الإنسان هي إرادة القوة، والتي تعني في المستوى الأول الإرادة للتغلب على الآخرين: الإنسان بطبيعته لا يريد المساواة. يسعد الإنسان بالتغلب على الآخرين وكذلك على نفسه. في حين أن رجل روسو الطبيعي عطوف، فإن رجل نيتشه الطبيعي قاسٍ، وما يقوله نيتشه عن العمل السياسي هو أمر غير محدد [8] وغامض أكثر مما يقوله ماركس عنه. بمعنى ما، أي استخدام سياسي لنيتشه هو تحريف لتعاليمه. ومع ذلك، فإن ما قاله قرأه سياسيون وألهمهم. مما يعني أيضًا أنه مسؤول عن الفاشية كما كان روسو مسؤولاً عن اليعقوبية، وقد استخلصت استنتاجًا سياسيًا من الملاحظات السابقة. نشأت نظرية الديمقراطية الليبرالية، مثل نظرية الشيوعية، في الموجتين الأولى والثانية من الحداثة. تبين أن التضمين السياسي الثالث هو الفاشية. ومع ذلك، فإن هذه الحقيقة التي لا يمكن دحضها لا تسمح لنا بالعودة إلى الأشكال السابقة للفكر الحديث. نقد نيتشه للعقلانية الحديثة أو الاعتماد الحديث على العقل لا يمكن تجاهله أو نسيانه [9] وهذا هو السبب الأعمق للأزمة التي تمر بها الديمقراطية الليبرالية. لا تؤدي الأزمة النظرية بالضرورة إلى أزمة عملية، لأن تفوق الديمقراطية الليبرالية على الشيوعية، الستالينية أو ما بعد الستالينية ، يظهر بوضوح تام. وفوق كل شيء، تجد الديمقراطية الليبرالية، على عكس الشيوعية والفاشية، دعمًا قويًا في نمط فكري لا يمكن بأي حال من الأحوال تسميته بالحداثة وهو الفكر ما قبل الحداثي لتقاليدنا الغربية.
الاحالات والهوامش
[1] ه .ي يقترح بعض التفسيرات لاستخدام استعارة الموجة التي سنعود إليها لاحقًا. ومع ذلك، يقترح البروفيسور جيلدين تقريبه من مفهوم “الترسيب” عند هوسرل ، فيما يتعلق بتاريخ الفكر. وراء هذا، هناك فكرة أن “الحداثيين” يحتاجون، أكثر من أي وقت مضى، إلى تاريخ من الفكر يحلل هذا الترسيب مع تجنب الوقوع في فخ التاريخية. يهدف هذا النص الذي كتبه شتراوس بشكل أساسي إلى تحديد نقاط التحول في تاريخ الفكر الغربي التي أدت إلى الحداثة. اقتراح ه .ي. لدفع “دلالات هذه الموجة” ، “لإثرائها بالمعاني المختلفة التي اتخذها المدينة اليونانية” يبدو أنه يتجاوز روح هذا النص. في الواقع، إنه بالفعل المصطلح اليوناني الذي يشير إلى موجة على بحر أو بحيرة، لا سيما في سياق العاصفة (راجع على سبيل المثال متى 8:24 ، باليونانية) ؛ كما يشير إلى المشاعر التي تجعل الإنسان يتصرف بغير حصر.
[2] راجع مفهوم الحظ في “الأمير”، مكيافيلي ، الفصل الخامس والعشرون.
[3] في الكتابات التي سبقت هذا المقال، نسب شتراوس الموجة الأولى لهوبز. ومن المثير للاهتمام، أنه في هذا المقال أرجع الأمر إلى مكيافيلي ويوضح بوضوح العلاقة الأساسية بين المفكرين.
[4] الجملة المقابلة في النسخة الإنجليزية الأصلية “… ومفهوم الطبيعة في حاجة إلى أن تغلفه الحضارة باعتبارها مجرد قطعة أثرية” غامضة إلى حد ما. ي. يقترح الترجمة التالية: “… وبمفهوم الطبيعة الذي يتطلب أن تغطيها الحضارة على أنها قطعة أثرية خالصة”. غالبًا ما يشير معنى المصنوعات اليدوية في اللغة الإنجليزية إلى “بقايا حضارة قديمة أو ثقافة أخرى”، بينما تثير المصنوعات اليدوية في الفرنسية غالبًا “خطأ” وتؤكد جانبًا اصطناعيًا. لكن، إذا كان شتراوس يشير هنا، على سبيل المثال، إلى “الحفاظ على الذات” لدى هوبز، فإن هذا المفهوم ليس مصطنعًا بأي حال من الأحوال. عند هوبز، يغطي القانون الأخلاقي أو صاحب السيادة “حالة الطبيعة” المكتشفة بالعقل، بهدف استبدال حالة الحرب الشاملة بالسلام الاجتماعي. لذلك فضلنا المصطلح العام “كائن” على “قطعة أثرية” وأضفنا المصطلحات بين قوسين معقوفين بعد مناقشاتنا حول هذه النقطة مع الأستاذ جيلدين.
[5] في اللغة الإنجليزية “حتى الآن”، بالمعنى الدقيق للكلمة، “حتى اللحظة التي يعبر فيها نيتشه عن هذا الفكر”. ومع ذلك، إذا اعتبرنا أننا ما زلنا في الموجة الثالثة، فيمكننا استقراء فكر نيتشه في “حاضرنا”. في أسلوبه في الكتابة، يعمل شتراوس باستمرار على هذا النوع من التحول حيث “الحاضر ليس الحاضر” و “المستقبل ليس المستقبل” وحيث يتماهى مع المؤلف الذي يفكر، كما لو كان للتأكيد على رؤيته المناهضة للتاريخية.
[6] لا ينسب شتراوس الموجة الثالثة إلى هيجل أو ماركس (كممثلين لما يسميه هنا بلا شك الفكر ما بعد الهيغلي) لأسباب تبدو واضحة في مقاربته. لنفس الأسباب ، لا يمكن للمرء أن يستحضر “موجة رابعة من الحداثة” التي ربما حدثت في فرنسا ، مثل ه .ي. ربما في إشارة إلى ما بعد الحداثة ، على سبيل المثال من قبل دريدا. دعونا نؤكد أيضًا أن نيتشه يختبر هذه الموجة الثالثة كمصدر لألم شخصي حقيقي ، إذا جاز التعبير. في حين تعتبر “موجة” ما بعد الحداثة بمثابة “احتفال” تقريبًا.
[7] في “البصيرة” الإنجليزية. لقد فضلنا “الإدراك” على “المنظور” (راجع ه .ي.) ، لأن المصطلح الأخير يمكن أن يثير “ارتدادًا” معينًا لن يحدثه الفكر الحديث ، وفقًا لشتراوس.
[8] قد يكون من المثير للاهتمام ملاحظة ذلك في الصفحات الأخيرة من “ما هي الفلسفة السياسية؟ يعود شتراوس إلى هذه الفكرة ويرى في نيتشه مشروعًا سياسيًا محددًا جيدًا.
[9] مع التأكيد على النقطة العقدية للأزمة وأصلها، لا يظهر شتراوس مخرجًا. على الرغم من أن الكتابات الأخرى التي كتبها شتراوس تظهر ميله “الطبيعي”، إلا أنه في هذا المقال وحتى نهايته، لم يعبر عن مثل هذا الاتجاه. لذلك من الصعب أن نرى هنا “فترة زمنية لا تتعارض مع موقفه” الطبيعي “، مثل ه .ي. ومن هنا تأتي صعوبة التمسك أيضًا بشرح اللجوء إلى استعارة الموجة التي اقترحها ه .ي. في هذه المصطلحات: “الاندفاعات دون ضرورة تاريخية؛ أفضل من ذلك، فهو يشير إلى قوة الطبيعة البحرية، أو إلى “كائن أبدي وغير قابل للتغيير يحدث فيه التاريخ”.
المصدر
Léo Strauss, Les trois vagues de la modernité Dans Le Philosophoire 2005/2 (n° 25), pages 167 à 180
الدكتور زهير الخويلدي / كاتب فلسفي / تونس