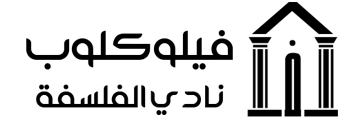مكانةُ الدرسِ الفلسفيِّ في المغربِ – محمد الورداشي
يعاني الدرسُ الفلسفيُّ إشكاليةً كبرى في العالمِ العربيِّ بالأساس، وهذه الإشكاليةُ تتمثلُ في ضعفِ حضوره داخل الجامعات العربية، وكذا الثانويات. لهذا سنحاول بحثَ إشكاليةِ الدرس الفلسفي في المغرب، محاولين تحديدَ الأسبابِ التي أدت إلى هذا التأزم، فضلا عن بعض المقترحات لتدريس الفلسفة في الجامعة والثانوية بالمغرب.
حينما نلقي نظرةً شاملةً لكل ما يُنتج سنويا في الجامعات المغربية حول الدرس الفلسفي، نجد أن هنالك تراجعا كبيرا في هذا المجال؛ فالفلسفة، في العالم العربي عامة، والمغرب خاصة، لم تعد تعاني حصرَها وتقييدَها بالمجال الأكاديمي فحسب، وإنما نجد تضييقا عليها حتى من داخل الجامعة، ناهيك عن التعليم الثانوي. إذن، ما الأسباب التي أدت إلى خفوت الفلسفة داخل المغرب؟ وكيف نعيد للفلسفة الظروفَ الملائمةَ حتى تقومَ بالأدوار المنوطة بها؟
ثمة أسبابٌ كثيرةٌ، لا يتسع المقامُ لسردها كاملة، كانتِ الداءَ الذي ينخر الفلسفةَ بشكل تدريجي، ومنها:
– تقهقر العقل الفلسفي أمام تيار العقل الديني،
– تراجع اهتمام العقل العربي بالفلسفة عامة والفكر خاصة،
– اتساع الهوة بين الفكر الفلسفي الغربي، وتلقيه من قبل العقل العربي،
– كون أغلب ما يؤلف في الفلسفة مؤلفا باللغة الانجليزية والفرنسية،
– التركيز على المضمون بدل تعلم التفكير،
– تضييق الخناق على الفلسفة، ومن ثم إبعادُها عن المجتمع وقضاياه، وحصرُها في المجال الأكاديمي،
– تعاطي أغلب الباحثين للفلسفة في برجها العاجي دون الانغماس والانخراط في هموم وتحديات الواقع،
– انعدام شبه كلي للسؤال الفلسفي، حيث إننا بتنا في زمن يكره الأسئلة.
هذه بعض الأسباب التي تبدو لنا ذات تأثير كبير على تقهقر الدرس والسؤال الفلسفيين في الجامعة، كما أنها تنسحب على الفلسفة في السلك الثانوي. ومنه، سنحاول اقتراح بعض الحلول التي قد تكون طرحت من قبل، لكنها لم تُنزَّل على أرضية الواقع، وإنما بقيت في مرحلة تشخيص المرض دون القيام باستئصاله. ومن ثم نقترح:
– تعليم التلاميذ والطلبة أن الفلسفة قمينة بالتعاطي مع مختلف المشاكل والقضايا التي يتأجج بها المجتمع المغربي. فالفلسفة لم تكن يوما عالة على العلوم الإنسانية الأخرى، وإنما يصعب أن نتصور دراسةً إنسانيةً اجتماعيةً دون حضور أسس ومرجعيات فلسفية، وبالتالي فإن الفلسفة هي القاعدة، الحاضرة المضمرة، في كل دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية.
– جعل التلميذ والطالب وجها لوجه أمام القضايا الفلسفية، انطلاقا من تعليمهما بأن تدريس الفلسفة لا يقوم على تقديم المضامين، وإنما يتأسس على ثقافة طرح السؤال، وخلق قلق معرفي يدفع المقبل على الفلسفة إلى طرح سلسلة من الأسئلة الفرعية، ومحاولة مقاربتها تفكيرا وبحثا ومناقشة.
إن ما تحتاجه الفلسفة حتى تزدهر في العالم العربي عامة، والمغرب على وجه الخصوص، أمران: ثقافة طرح السؤال، ومنهجية التفكير في السؤال؛ لأن الفلسفة ليست تلقينا، وسقراط لم يكن ملقنا، من خلال ما ورد في محاورات أفلاطون، وإنما كان ينهجُ طريقةً توليديةً، ما يجعل محاوريه يتدرجون في التفكير الفلسفي، ومحاولة الجواب انطلاقا من تطور أسئلة سقراط التي تهدف إلى تعليم المحاورين كيف يفكرون.
– التخلي عن تقديم المضامين الفلسفية للفلاسفة على حساب دفع التلميذ والطالب للبحث عن طريقة تفكير أولئك الفلاسفة، ولا يتأتى هذا إلا بالإيمان أن نتاجهم لن يتم فهمُه إلا بالعودة إلى أسسهم ومنطلقاتهم،
– الاعتماد على فلاسفة حداثيين قريبين من عصر المقبل على الفلسفة، وهكذا سيكون أكثرَ استجابةً مع تفكيرهم وأفكارهم،
– التعامل، فلسفيا، مع بعض القضايا الموجودة في محيط التلميذ والطالب، وتشجيعهما على التعاطي معها عن طريق السؤال،
– الرفع من شأن الأسئلة التي توقظ الذهن أكثر من الأجوبة؛ لأن المتعلم للفلسفة، ينبغي أن يعي أهمية السؤال أكثر من البحث عن الأجوبة الجاهزة في الكتب الفلسفية.
هنالك وصفةٌ سريعةٌ للتعامل مع الدرس الفلسفي:
ينبغي على مدرس الفلسفة، سواء أكان أستاذا جامعيا أم أستاذا للتعليم الثانوي، أن يؤهل المتلقين لاستقبال السؤال الفلسفي، وذلك من خلال تبيان أهميته، وأهمية نتائجه على الفرد والمجتمع والإنسانية. ثم بعد ذلك، يطرح السؤال، شريطة أن لا يكون غامضا بل مشجعا على التفكير والتأويل، منتجا حيرة وشكا في ذهن متلقيه.
على أن ثمة أمرا مهما ينبغي التأكيد عليه؛ إذ ليس من الصحيح أن نقول للمتلقي إن هنالك جوابا قارا ينبغي أن تصل إليه، ولكن علينا أن نبين له كون الفلسفة تهدف إلى البحث عن الحقيقة، شأنها شأن باقي العلوم والأديان، بيد أن حقيقة الفلسفة تقوم على الشك والدحض، وهي نسبية بالدرجة الأساس، وهكذا يتعلم المقبل على الفلسفة قيمة النسبية في الأجوبة والنتائج الفلسفية، ومن ثم الانفتاح على الواقع ومساءلة قضاياه ومشاكله؛ لأن الفلسفة تعلمُ التفلسفَ والسؤالَ، ولا تقدمُ الحلَّ والجوابَ.
محمد الورداشي – باحث وناقد