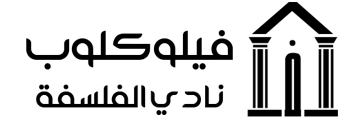الأكاديمة الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان
المركز الجهوي للتوثيق والتنشيط والإنتاج التربوي-خلية الانتاج
دروس في الفلسفة
السنة الثانية بكالوريا للتعليم الثانوي التأهيلي
(جميع المسالك)
مجزوءة الوضع البشري
الشخص – الغير – التاريخ
إعداد وإنجاز: الفريق التربوي لمادة الفلسفة – تحت إشراف المنسق الجهوي للمادة (2007-2008)
تصدير
ما يبدو أن مقرر الفلسفة الحالي بكل مؤلفاته المختلفة، يفتقر إليه أو لم يرد الخوض فيه، هو المادة المعرفية الأكاديمية المدعمة والمتضمنة في كل المجزوءات المقررة، ولهذا الترك او التخلي ما يبرره، وأول مبرر هو ترك المجال أمام حرية المدرس في اختيار مادته المعرفية، وكان الأهم هو التأطير الديداكتيكي والتأثيث النصي والتمرين الفلسفي، أجل لا تقل هذه الاختيارات المنهجية والتدريسية أهمية، ولا تشكو عذرا، لكن بمفردها تظهر غير كافية، فلابد من توحيد المنهج ولابد من توحيد التقويم ولابد أيضا من توحيد المضامين المعرفية ما أمكن، هنا اختار الفريق التربوي المادة الفلسفة بأكاديمية فاس بولمان أن يتدخل ليقترح مادة فلسفية معرفية يستأنس بها مدرسوا الفلسفة لكن بحرص كبير على التوضيحات التالية:
1 . لا يدعي الفريق من وراء هذا تقديم معرفة كاملة ، جامعة مانعة هذا من باب المستحيل ، لكنه يريد أن يغامر بتقديم مادة معرفية للاستئناس .
2 . ثم التقريب حتى لا نقول لتوحيد المراجع والإحالات التي يمكن اعتمادها في بناء الدرس .
3 . ولتجاوز النصوص التي تبدو غير ملائمة للأطروحة المراد معالجتها أو مقاربتها .
4 . ولتوحيد وتركيب مفاصل وأجزاء ووحدات المجزوءة . ومفاهيمها ونصوصها واشكالاتها .
5 . وأخيرا للتحرر من هيمنة الكتاب المدرسي وتحقيق مسافة بينه وبين المدرس .
المجزوءة: مجزوءة الوضع البشري
1 – مدخل
يقذف الإنسان في هذا العالم بحسب كيرغارد دون أن يستشار ومادام هو كذلك، فإنه يجد نفسه محاطا بجملة من الظروف والإكراهات التي تتحكم فيه وفي اتجاهه نحو المستقبل. وما يستأثر الاهتمام هنا، كون الوضع البشري يتضمن معنيين متناقضين:
يتمثل الأول في كون الإنسان كائنا مع الآخر، أي يعيش ضمن مجتمع ومحاط بإكراهات وقيود ذاك المجتمع، ومعرض إلى أن يفقد وجوده الأصيل في تعامله مع الآخر، بمعنى عرضة للاستلاب من طرف الآخر. كما أنه معرض ليفقد وجوده لا الأنطلوجي فقط وإنما حتى البيولوجي وذلك في لحظات المرض أو في لحظة الموت. ومن هنا يمكن وسمه بالكائن الهش.
يتجلى المعنى الثاني، في كون الإنسان قادرا على أن يضع مسافة بينه وبين هاته الإكراهات والشروط التي تحيط به وتنمطه وذلك اعتمادا على إرادته ووعيه. إنه دائما في رهان نحو تطوير قدراته وكفاءاته وتطويع محيطه. إنه كائن مشارك ومتعايش مع الآخرين. وفي هذا فهو كائن مفاوض يعمل من جهة ببصمة ذاته بتأثيرات المجتمع والآخرين عليه ويعمل كذلك على ترك بصماته على الآخرين. يتحدد وجود الإنسان إذن من زاويتين :
الأولى موضوعية والتي تتمثل في كوننا نشترك مع الآخرين في جملة من السمات الكونية والتي نجملها في كوننا موجودين في العالم مع الآخرين وكوننا كائنات فانية.
الثانية ذاتية والمتمثلة في المشروع الشخصي الذي يحمله كل واحد منا بصفته شخصية أخلاقية وحقوقية. وذلك في أفق إما تقبل الإكراهات المحيط به والاستسلام لها أو تجاوزها أو تطويعها وتعديلها.
2 – تساؤلات مركزية
بأي معنى يمكن وسم الوضع البشري بكونه وضعا معقدا؟ وما طبيعة الإكراهات والضرورات التي يخضع لها؟ وهل بمقدوره تحديها وتجاوزها؟ وكيف تتفاعل المحددات الذاتية والموضوعية في تشكيل الوضع البشري؟
أولا : مفهوم الشخص
1 – مفارقات مفهوم الشخص
يحيل اصطلاح الشخص لدى المعجمين العرب القدامى إلى كل جسم له ارتفاع وظهور، فنقول ” رجل شخيص ” أي ظاهر للعيان. وعلى النقيض من ذلك يفيد نفس المصطلح في القواميس اللاتينية“Persona”القناع الذي كان الممثلون يحملونه في التراجيديا اليونانية. وهنا يعرف إبيكتيت الشخص بالدور الذي على الفرد أن يلعبه والذي لم يختره وإنما اختاره له الآخر. الشيء الذي يعني أن هذا المصطلح يفيد التقنع والإبتعاد عن الواقع والإخفاء. في ذات الوقت يحيل في ميدان الحقوق والقانون والقيم إلى الشخص المعنوي” Personne Morale “أي إلى الفرد من حيث اتصافه بصفات تمكنه من المشاركة العقلية والوجدانية في العلاقات الإنسانية. ومن شروط الشخص المعنوي أن يعي ذاته، وأن يكون قادرا على التمييز بين الخير والشر. قادرا على القيام بأفعال معقولة ومقبولة من طرف الناس. بمعنى لديه حقوق ووجبات. وبناء على هذا الاعتبار رفض الفلاسفة اليونان إلصاق صفة الشخص على العبد لأنه محروم من حقوقه المدنية.
إجمالا، علينا الإقرار بأن كلا من البعد الأخلاقي والحقوقي يشكلان سمات جوهرية لدى الشخص، على اعتبار كونه ذات واعية وحرة تتميز بالإرادة الكافية لتقبل أو رفض القيم الأخلاقية المحلية أو الكونية المحيطة بها. بمعنى الشخص، في هذا السياق، هو المواطن الكامل المواطنة، الذي يتمتع بحقوق كاملة أمام القانون (حق التصويت والترشح في الانتخابات، حق توقيع عقد، حق تكوين شركة) وملتزم بعدة واجبات.
2 – تساؤلات
بأي معنى يمكن اعتبار مفهوم الشخص مفهوما انفلاتيا يصعب تحديده بدقة؟ هل نعرف الشخص أو الأنا من خلال شكل الفرد الجسدي وصورته الجمالية؟ أم من خلال أنشطته العقلية ومستوى ذكائه؟ أم علينا اعتبار الشخص أو الأنا مفهوما مجردا لا يمكن تحويله إلى موضوع؟ وما أوجه العلاقة بين مفهومي الشخص والهوية الذاتية؟ وأية قيمة يمكن إضفاؤها على الشخص وذلك بوصفه تعبيرا عن ذات أخلاقية وحقوقية؟ وما حدود حرية الشخص؟ أي ما طبيعة المعوقات والإكراهات التي تحول دون أن يحقق الشخص حريته على شكل مشروع؟
3 – مسارات مفهوم الشخص
1 . 3 . معالم تاريخية :
معلوم أن مفهوم الشخص هو سمة ألصقت بالمواطن اليوناني، وتعني الإنسان الفرد، في حين ألغيت هذه الصفة على العبيد الذين اعتبروا مجرد آلة والأجانب الذين وسموا بالبرابرة. وللإشارة، فإن هاته الفكرة ستشكل مستقبلا مرجعا للنزعة المركزية الغربية وللتوجهات الاستعمارية. إلا أن فكرة الذات الحرة والعاقلة المتمسكة بهويتها الشخصية رغم التحولات التي تعرفها قد ظهرت مع سقراط و افلاطون. فسقراط من خلال قولته الشهيرةاعرف نفسك بنفسك، قد حاول أن يبين أن هناك الأنا أو الذات القادرة على تحقيق معرفة ذاتية بذاتها دون حاجة إلى الغير. كما أن أفلاطون في محاورة فيدون أكد على أن الشوائب المادية والجسدية تعيق النفس على بلوغ حريتها وتحقيق معرفة كاملة بذاتها.
وفي الفلسفة الإسلامية نجد إبن سينا يحاول ملامسة مفهوم الشخص أو الأنا من خلال اعتباره أن النفس ثابتة وغير متغيرة، على الرغم من التغيرات التي تطرأ على الجسد ويعتمد في ذلك على دليلين : 1 / كونها تستطيع أن تتذكر أحداثا مضت بينما هاته الإمكانية غير قائمة في الجسد وكذلك 2 / رغم أن الشخص يكون في حالة سكر وتخدير لا يستطيع أن ينسى أنه أنا.
وفي العصر الحديث ، أثار ديكارتمفهوم الأنا أو الذات والذي سيشكل الأرض الصلبة لتحديد مفهوم الشخص. فهذه الأنا من خلال الكوجيطو الديكارتي هي الوحيدة التي تنفلت من أية عملية شك وأساس تحقيق المعرفة الكاملة. فأنا أشك في كل شيء ولكن لا أستطيع أن أشك في أني أنا لا أشك ومادامت كذلك فأنا موجود وكل ما يحيط بي موجود. ومن هنا نفهم أن ديكارت على غرار سقراط أعتبر أن الذات أو الشخص أساس المعرفة اليقينية، وأساس التمييز بين الصواب والخطأ والخير والشر. وهي ذات حرة ومستقلة، بمعنى أن هذه بوصفها ذاتا عاقلة لا يقف دورها في تحقيق المعرفة وإنما كذلك في كونها تتمتع بالإرادة الكافية لتميز الخير عن الشر. وهذا يفيد ضمنيا أنها ذات مسؤولة .
إلا أن الفيلسوف الذي ربط بشكل صريح بين الأخلاق ومفهوم الشخص هو الفيلسوف الألماني كانط. وتجلى هذا الربط في اعتماده عبارة الأمر المطلق(L’impératif catégorique) . ويعني كانط بهاته العبارة أن نتصرف أخلاقيا إزاء الآخرين بالشكل الذي نتصرف به مع ذواتنا وذلك باعتبار الإنسان غاية وليس وسيلة. فنحن ككائنات بشرية نتميز عن بقية الكائنات العاقلة بكوننا لا نسخر كوسائل فغايتنا في ذواتنا( fin en soi ) . بمعنى إننا نتمتع بالإرادة الكافية لنتصرف لوحدنا وكما نريد وبشكل ذاتي لتحقيق جملة من الغايات التي نطمح إليها، ومن هنا جاز وسم الإنسان بالشخص القادر لوحده أن يميز بين الخير والشر وإن مارس أحيانا الشر. ومصدر تمييزه هذا كونه كائنا عاقلا.
2 . 3 . الهوية الشخصية :
بالعودة إلى قولة سقراط ” اعرف نفسك بنفسك ” نستنبط أن ما يميز الشخص قدرته على تكوين معرفة ذاتية حول ذاته وتصرفاته وسلوكه. ومن هنا يمكن تعريف الشخص بحسب لوك بالذات أو الأنا القادرة على تعقل ذاتها. والوعي بذاتها والتفكير في ذاتها رغم تنوع السياقات والوضعيات التي تواجهها. وعلى هذا الأساس جاز لنا التمييز بين المعرفة العادية العامة والمعرفة بالذات. فالمعرفة العادية هي معرفة الموضوعات الخارجية في تنوعها وتغيرها. بينما المعرفة بالذات هي نوع من الوعي بالأنا المفكرة التي تظل هي هي رغم التحولات التي تعرفها في الزمان والمكان. وهذا ما يشكل الهوية الذاتية. وعليه ، تتحدد الهوية الذاتية من خلال الإجابة عن سؤال مركزي وهو كيف يمكن التفكير في رحلة الأنا في الزمان المتبدل والأمكنة المتغيرة؟ هل أنا الشخص نفسه الذي كنته قبل عشرين سنة؟ لقد اقترح لوك حل إشكال الهوية الشخصية بفكرة الذاكرة: إذا كنت الشخص ذاته الذي كان قبل عشرين سنة، فلأنني أتذكر مختلف المراحل التي مر بها وعيي أو شعوري. وبناء على ما سبق، فإن كلما امتد شعوري بسلوكاتي وتصرفاتي وأفكاري في الماضي كلما اتسعت دائرة هويتي
وعلى النقيض مما ذهب إليه لوك يصعب بحسب شوبنهاور تحديد الهوية الشخصية من خلال الذاكرة لأن التقدم في سن أو المرض أو إصابة في المخ يؤدي إلى تعطيل في الذاكرة وهذا يعني هذا تعطيلا في هويتي؟ كما أن الهوية الشخصية ليست كما سبق وأن أكد ديكارت الذات العارفة لأن النشاط المعرفي ما هو بحسب شوبنهاور إلا وظيفة بسيطة من وظائف الدماغ. إن الهوية تتأسس بناء على عنصر ثابت فينا والذي يبقى دائما ولا يعرف الشيخوخة وهو نواة وجودنا ويسمي بالإرادة. والتي تشاطرنا الحيوانات فيها ضمن خانة عامة تسمى بإرادة الحياة وهي مبدأ كوني يعبر عن المجهود الغريزي لدى الحيوان للحفاظ على نوعه في مواجهة بقية الأنواع. وبالتالي فإن الإرادة الشخصية للإنسان المؤسسة لهويته ما هي إلا إحدى تمظهرات إرادة الحياة والتي تترجم إلى إرادة التفكير وإرادة الوعي بكوننا كائنات مخيرة ومريدة.
3 . 3 . الشخص بوصفه قيمة :
بري كانط بأن الشخص ذاته معسكر للأخلاق ومرجعا للقوانين وذلك لكونه ملزما بالأمر المطلق في ممارسته للوجبات الأخلاقية. ولا جدال في أن منبع هذا الأمر المطلق العقل الذي يلزم الإنسان بمقولة عدم التناقض إن على المستوى المعرفي أو في ممارستنا للقيم. وهذا يتجلى بوضوح في مبدأ المساواة في الحقوق الذي دعا إليه إعلان حقوق الإنسان 1789. فمبدأ المساواة بحسب كانط وبناء على قاعدة الأمر المطلق لا يحتاج إلى إعلان صريح. فهو قائم في العقل بشكل قبلي. بمعنى لنفترض أن هناك شخصا عنصريا يتصرف بشكل إيجابي مع المقربين منه في المقابل يتعامل بطريقة سلبية مع الغرباء . إن سلوكا كهذا لا ينسجم ومبدأ الأمر المطلق الذي يفيد تصرف مع الآخرين كما تتصرف مع ذاتك. إنه سلوك متناقض وبالتالي فصاحبه قد قام بممارسة لا عقلية.
وبناء على ما سبق فإن ما يمنح الإنسان قيمة أخلاقية كونه أولا شخصا أي ذاتا عاقلة وليست شيئا وبالتالي ليست وسيلة. فغايتها في ذاتها. ومن هنا فإنني أمارس الأخلاق لأنني شخص عاقل أتمتع بالإرادة الكافية النابعة من هذا العقل والتي تخول لي أن ألتزم بجملة من القيم لا خوفا من عقوبة أو لا رغبة في جزاء ولكن أمارسها كغاية في ذاتها، أي لكونها تنسجم ومبادئ العقل.
لكن ردا على كانط السؤال الذي يطرحه غوسدورف، بأي معنى يصح اعتماد المسلمة الكانطية في تعريف الذات الأخلاقية والقائمة على فكرة مؤداها: أن الأخلاق نابعة من مبادئ العقل الكونية والقبلية وبالتالي فالقوانين المنظمة للأخلاق كونية ومطلقة وفي ذات الوقت فهي ذاتية المنشاً ؟ هل منبع الأخلاق نابع دائما من الذات الفردية العاقلة؟ ألا يمكن القول بأن الأخر بوصفه مجتمعا وثقافة له دور في بناء القيم؟ ومن هنا ألا يمكن الحديث عن نسبية الأخلاق وتنوعها؟
إن القول بأن الذات عاقلة أو الأنا مفكرة هي مصدر الأخلاق مسألة فيها نظر بحسب غوسدورف لأنها تسقط الإنسان في نوع من العزلة الوجودية، فالإنسان لا يؤسس ذاته الأخلاقية إلا في انفتاحه على الآخرين وتضامنه مع هؤلاء الآخرين . ومن هنا علينا الخروج مما ذهب إليه كانط من حديث عن أخلاق نظرية كونية ومجردة وقبلية للحديث عن أخلاق ملموسة تتشكل ضمن مجال التعايش وداخل المجموعات البشرية وبفعل عملية المشاركة الجماعية في إقامة هاته الأخلاق. وتختلف باختلاف الجماعات المنتجة لها. ومن هنا علينا الإقرار بنسبية الأخلاق ومحليتها بدل كونيتها.
3 – الشخص بين الضرورة والحرية
لا جدال في أن الإنسان معرض لنوع من الاستلاب بسبب القيود والضرورات التي تفرض عليه من طرف المجتمع. ومن هنا يطرح السؤال التالي: ما إمكان منح حرية للشخص في ظل هاته الظروف؟ بأي معنى يمكن اعتبار الشخص حر في التخطيط لمشاريعه وتحقيق تطلعاته ؟
1 . 4 . الشخص مشروع حر (سارتر):
الشخص بحسب سارتر مشروع حر ومفتوح على إمكانيات لا نهائية. فهو يمتلك القدرة الكافية لتجاوز الوضعية التي يوجد فيها وذلك بواسطة الفعل أو الحركة التي يقوم بها في اتجاهه المستقبل.
ويتجسد كل من الاختيار والحرية لدى سارتر في اختلاف أسلوب وطريقة وثب كل شخص نحو المستقبل ونوعية الإمكانات التي تتحقق لدى البعض دون الآخر في مجال عيشه.
وتأسيسا على ما سبق يؤكد سارتر على ضرورة إخراج الإنسان من الرؤية الحتمية العلموية التي ترى أن الشخص محاط بجملة من الإكراهات النفسية والاجتماعية والبيولوجية والثقافية التي تؤرخ له قبل أن يولد. بمعنى التي توجهه نحو مستقبل تم إعداده بشكل مسبق.
وفي هذا الصدد يرفض ساتر الديالكتيك المادي الماركسي الحتمي الذي يرى أن قوانين الجدل التي تتحكم في الطبيعة نفسها تتحكم في مصير الإنسان. فمشكلة الماركسية بحسب سارتر أنها حاولت إقامة دياليكتيك بدون إنسان. وعليه فهو يدعوا إلى نوع من الديالكتيك الإنساني والذي يفيد أن الأحداث البشرية ليست محددة تحديدا جبريا سابقا بمقتضى قوانين خارجية سابقة. وإنما بطلها هو الإنسان. فليس أسلوب الإنسان في الوجود سوى طريقة خاصة في إقامة علاقة بينه وبين العالم والتي تبني انطلاقا من كونه كائن حر وواع. الشيء الذي يسمح له بأن يتخذ وجهة نظر معينة من العالم.
2 . 4 . الشخص حر ولكن بشروط (مونييه):
نعلم أن سارتر قد انتهى إلى فكرة مؤداها أن الشخص هو الذي يصمم مستقبله ثم يعمل على تحقيق هذا التصميم على شكل مشروع، متحديا الظروف الموضوعية التي تقف حجر عثرة أمامه. وبهذا فالشخص قادر على التعالي عن الإكراهات التي تحاول الحد دون وثبه اتجاه المستقبل. وبالتالي فهو كائن حر وواع ومسؤول عن اختياراته المستقبلية.
لكن مونييه يرى أن قولا كهذا ينم عن نزعة تفاؤلية رخيصة، فليس كل قدر الإنسان بين يديه. فحرية الشخص متلازمة مع وضعه وواقعه ومحاصرة بهذا الوضع. بمعنى لا يستطيع الإنسان الخروج عن الحدود التي رسمها له واقعه. وعلى هذا الأساس على الإنسان أن ينظر إلى حركته بنوع من الموضوعية. إذ عليه أن يعي أن ليس كل شيء ممكن وفي كل لحظة ومتى شاء. بمعني كلما كان فضاء حركة الإنسان ضيقا بسبب طبيعة الظروف التي يواجهها (اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية ونفسية ) كلما كانت مشاريعه وأحلامه وأفاقه محدودة. لكن متى يمكن اعتماد عبارة سارتر الإنسان حر في اتجاهه نحو المستقبل؟ جواب مونييه :عندما يتمتع هذا الإنسان بوجود غني، يشكل له مرتكزا للوثب نحو المستقبل، أي عندما يكون إطار حركته غير مشروط.
ومن هنا يلفت مونييه انتباهنا إلى مسألة جوهرية؛ فقبل أي تسويق لمفهوم الحرية في الخطابات السياسية وفي المواثيق والدساتير لابد من التأكد من أن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تؤمن الشروط العامة للحرية. بذلك سنشكل وجودا غنيا يمنح إمكانات متنوعة للشخص في اتجاهه نحو المستقبل.
وعلى غرار سارتر يتفق مونييه على أن الحرية ليست التصرف بعفوية ولكن الحرية عندما أمنح للإنسان قيمته الإنسانية بوصفه شخصا. أي عندما أنخرط في مسار الشخصية بمعنى تقدير الإنسان والدعوة إلى تحرير الإنسانية ككل وبشكل ملتزم ومسؤول. ومن هنا فالحرية مسؤولية والتزام يدفعني إلى الدفاع عن حرية الآخر مهما اختلفت عقيدته ودينه ومرجعيته.
خلاصة تركيبية:
لا خلاف في أن الصعوبات التي تحول دون تقديم تحديد دقيق لمفهوم الشخص راجعة لكون المفهوم منفتحا على مجالات متعددة فلسفية، حقوقية وأخلاقية. لكن مع ذلك يمكن تتبع بعض مساراته التعريفية من خلال ربطه بهوية الشخص اعتمادا على ملكتي الذاكرة والشعور (لوك) أو بالاعتماد على الإرادة (شوبنهاور) أو من خلال كون الشخص ما هو إلا تعبير عن كائن أخلاقي عاقل؛ يمارس الفعل الأخلاقي من خلال قناعات عقلية (كانط) أو من خلال الانفتاح على الآخر والتضامن معه (غوسدورف). وأخيرا من خلال الاعتراف به بكونه كائنا حرا في اتجاهه نحو المستقبل وأن مصيره بين يديه على شكل مشروع (سارتر) أو أن هذا الإختيار في وتبه نحو المستقبل محدد بطبيعة الظروف التي يواجهها. ولهذا ليكون الشخص حرا لابد من إيجاد الظروف الملائمة لممارسة فعل الحرية (مونييه)
لا خلاف في أن الإنسان مادام كائنا اجتماعيا فليس بمقدوره أن يعيش وحيدا في هذا العالم. فهو محتاج للغير/الآخر. وحاجته للغير لا تقف في بحثه فقط عن من يسانده لتحقيق مشاريعه ومن يتعاون معه في معالجته لجملة من الصعوبات التي يطرحها أمامه واقعه اليومي. وإنما فضلا عن ذلك فهو يبحث عن من يعترف به أولا أنه موجود فعلا ومن يشاركه ذلك الوجود. فانفعالات الشخص وعواطفه وأحكامه واكتشافاته لا قيمة لها دون أن يكون الأخر شاهدا عليها وضامنا لها. وهذا ما يترجم إلى حاجة الفرد للتواصل بوصفها ضرورة ملحة. ومن هنا تتأسس نظرتي للغير بوصفه إما شبيها لي لكونه يشاطرني نفس الآراء والمواقف وتحركنا انفعالات وتعاطفات متشابهة. أو غريبا عني لأنه يخالفني في الرأي في وضعيات معينة، أو يختلف عني في معتقداته وثقافته وتوجهاته. وفي هذا فإنني أبدأ بتلمس نوع من الغرابة في سلوكه والتمايز في نظرته للعالم. الشيء الذي يشكل بؤرة لخلاف بيني وبينه وبداية لتصرفات عدوانية وعنيفة اتجاهه. وتأسيسا على ما سبق نفهم أن الغير يحمل معاني متناقضة. فهو أنا الآخر وآخر غير أنا. بمعني هو شبيه ومختلف عنى، قريب وبعيد عني، مألوف وغريب عني. أنه يعكس صورة مليئة بالتناقضات والألغاز. صورة تجذبني إليها تارة وتثير حيرتي وجزعي تارة أخرى. وبناء على ما سبق تطرح الأسئلة التالية :
- مادام الغير مفهوما إشكاليا يثير معاني متضاربة. فهل معرفته ممكنة؟ وبواسطة أية آلية يمكن معرفته؟ هل بشكل مباشر بقياس ذاته إلى ذاتي؟ أم بشكل غير مباشر بالتعامل معه كموضوع للإدراك؟ أم بالتفاعل معه؟
- هل يصح اعتبار وجود الغير شرط لوجودي أم تهديد لهذا الوجود؟ أي علاقة أخلاقية يمكن اعتمادها مع الغير؟ وإلى أي حد يمكن الإبقاء على علاقة تصالحية معه تأخذ أرقى أشكالها في الصداقة على اعتبار أنها فضيلة وواجب أخلاقي؟
- هل وجود الغير شرط لوجود الأنا أم تهديد له؟
تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الغير بوصفه مفهوما فلسفيا إشكاليا لم يتبلور بشكل واضح إلا مع الفلسفة الحديثة وبخاصة مع هيغل. وقبل ذلك وبدءا من الفلسفة اليونانية وحتى بداية الفلسفة الحديثة فقد سيطرة نزعة فلسفية ترى أن الأنا هي الوحيدة الموجودة في العالم ( Solipsism ) وهي مصدر كل اليقينات والمعارف ولا تحتاج للآخر في تحديد وجودها أو تعريف ذاتها ويبدوا ذلك جليا من خلال المذهب السقراطي القائم على مقولة “إعرف نفسك بنفسك” والذي كان له بالغ الأثر على فلسفة ديكارت الذاتية القائمة على الكوجيطو التالي “أنا أشك إذن أنا أفكر إذن أنا موجود “. فالذات عند ديكارت تتعرف وتعي ذاتها لا بلجوئها إلى الغير وإنما بركونها إلى ذاتها. فديكارت يشك في كل شيء في وجود الأخر والعالم الذي يحيط ولكن لا يستطيع أن يشك في وجوده الذاتي. فأنا أفكر هو اليقين الوحيد الذي لا يستطيع الشك أن يقتحمه. ففي تأملات ديكارت الميتافيزيقية حتى الأشياء التي أدركها بحواسي أو أتخيلها ليس لها وجود خارج ذاتي وأناي.
إجمالا إن وجود العالم والآخرين يظل إشكالا قائما في فلسفة ديكارت. فهذا الفيلسوف في قمة ارتيابه يشك في وجود ذوات واعية أخرى تحيط به إذ يقول : “نعم أرى أجسادا تتحرك أمامي وتتحدث ولكن بأي حق وانطلاقا من أي دليل أستطيع أن أتيقن من كون هاته الأجساد ذواتا واعية. فأنا متأكد فقط بأنني كائن واع لأن وعيي هو ما أستطيع أن أعيشه بشك مباشر. أما ما أراه من مشاهد بشرية أمامي، فأنا غير متيقن هل هي وهم، خيال أم واقع، حلم أم يقظة”. من هنا يتضح أن ديكارت تعرف على ذاته لا من خلال الآخر وإنما عبر تجربة عزلة وجودية مطلة. الشيء الذي دعا شوبنهاور إلى أن يوجه له هذا الانتقاد الحاد والذي قال فيه ” هذا المجنون سجن الذات في حصن منيع لا يمكنها النفاذ منه”. كما أكد فوكو في الفلسفة المعاصرة أن أنا المفكر لدى ديكارت قد أقصت قضايا لها دور في تحديدها وهي التاريخ والمجتمع والغير.
وبناء على ما سبق، أسس هيغل في كتابه فينومينلوجيا الروح فلسفة جديدة مضمونها أن الإقرار بوجودي ينبني على الاعتراف بوجود الغير . لكن كيف ذلك؟ إن أخذ الاعتراف من طرف الأخر بكوني موجود بالفعل ليس أمرا هينا وإنما يأخذ شكل مواجهة شرسة مع الآخر. ومرد هاته المواجهة الصراع التاريخي القديم الذي كان بين شعورين. والذي يوضح كيف أن كل ذات على حدة تريد تريد أن تعي ذاتها وتتعرف عليها لا بالركون إلى ذاتها وإنما من خلال موضوع غريب عنها. بمعنى أن كل ذات ترغب في أن يعترف بوجودها من طرف ذات أخرى تواجهها. ولكن أن يعترف بها كسيد وبالتالي يتم الإعتراف بالذات الثانية كعبد. ومن هنا برزت تلك المواجهة الشرسة بين الشعورين. وفي قمة الصراع وأوجه يخاطر كلا الشعور بحياتهما بالابتعاد عن الرغبة العضوية/ الحياتية، للا يصبحا عبيدا لتلك الرغبة أي ليظلا ذواتا مستقلة عن الرغبة… رغم أنها تعمل على استمالتهما وجذبهما إليها. لكن أحد الشعورين لا يستطيع مقاومة الرغبة ويصبح عبدا لها وبالتالي عبدا للسيد.
ما يخلص له هيغل أن الذوات البشرية هي سجينة يقينات ذاتية بوجودها وما تحتاجه هو اعتراف موضوعي وبكونها أنوات موجودة بالفعل من طرف الغير. لكن هذا الاعتراف الذي تبحث عنه كل أنا كونها أنا مستقلة وواعية وسيدة. الشيء الذي يلزمها بالدخول في صراع أنطلوجي مع الآخرين. ينتهي بانتصار أحد المحاربين والإبقاء على حياة الآخر ليعترف به كسيد ويقر أنه عبد له.
وتأسيسا على موقف هيغل نفهم أن علاقة الأنا بالغير هي علاقة صراع تهدف إلى تحويل أحد أطراف الصراع إلى عبد أو إلى موضوع. الشيء الذي دعا الفيلسوف هيدغر إلى اعتبار الغير أو الأخر تهديدا لوجودي الذاتي. فمعلوم أنني كذات أصيلة وفريدة موجود مع وهذا الإحساس الذي ينتاب وجودي مع الآخرين ينفي التشابهات التمايزات القائمة بيني وبين الآخرين ويجعلني أعتقد أن ذاتي تشبه ذواتهم، مما يجعلني أتقبل علمية التنميط الشخصي وفقا لنماذج شخصية قائمة لدى الآخرين. و الآخرين. أنني في هاته اللحظة قد بدأت أفقد وجودي بوصفه وجودا أصيلا لصالح الوجود الزائف . هكذا يصبح خطابي وسلوكاتي وحركاتي عبارة عن استجابة لما ينتظره الآخرون مني. إنني بهذا اسقط في عالم الشيئية ويصبح وجودي الذاتي المتميز يصرف في ضميرهم.
وتأسيسا على ما سبق نفهم أن الإنسان بحسب هيدغر أصبح يعيش في العصر الحديث حالة جماعية زائفة، لأنه قد اتخذ من الوجود مع الآخرين ذريعة للتنازل عن وجوده الخاص، فلم يعد وجوده الخاص سوى مجرد انغماس في عالم الجمهور. هكذا فقد إنسان العصر الحديث حريته وصار مجرد موضوع ينطق بلسان الآخرين . وعليه الاختيار إذن وهنا الاختيار صعب، بين وجود أصيل وحقيقي والمتمثل في الذات القائمة بذاتها والمسؤولة عن ذاتها ووجود زائف والمتجلي في ذات غريبة على ذاتها فقدت حريتها وأصبحت تحيي لحساب الآخرين ومن هنا فقد هبطت إلى مستوى الموضوع. فانغمست مع الجماعة آملة من وراء ذلك التهرب من حريتها والتنصل من مسؤولياتها والتخلص من الشعور بالقلق.
الناس/ الغير يشكلون سلطة جمعية غير شرعية تسلب الذات شعورها بالمسؤولية . وهنا يجد الإنسان نفسه مدفوعا إلى التخلي عن التزامه الشخصي فيأخذ بأحكام الآخرين ، ويتمسك بالتوسط في الأمور ويدين بكل ما يدين به الجمهور. وعندئذ سرعان ما تصبح حياته الشخصية صورة من صور الجمهور. وسرعان ما يهبط الوجود الذاتي الخاص إلى هذه الدرجة العامية المبتذلة فهناك لا يعود المرء يعلق أدني أهمية على مسؤوليته الشخصية بل يوجه كل هتمامه نحو تلك المشاعر العادية التي قد تعينه على الانصراف نهائيا عن التفكير عن التفكير في مصيره الحقيقي.
هكذا الآخر مهدد لوجودي لكونه يجذبني للاغتراب عن ذاتي ( Entfremdung ) والانحدار إلى مستوى الشيئية والتنازل عن الوجود الحقيقي الأصيل. إن الإنسان إجمالا معرض لخطر السقوط أي خطر الاغتراب عن الذات والسقوط في عالم الموضوعات ( Vefall ).
لكن رغم سلبية هذا الأخر المتمثلة في تهديده الوجودي فهو يظل حسب هيدغر مهما. فالوجود مع الآخرين هو من مقومات الموجود الإنساني. إن الذات لا تجد نفسها مهجورة قد خلى بينها وبين وجودها الخاص فحسب، وإنما هي تجد نفسها في عالم آخر الذي لا بد أن تتعامل معه وتعيش بجواره. والشعور الفردي الذي قد ينتابنا ليوهمنا بأننا موجودين لوحدنا دون الآخرين إنما يبرز فوق أرضية شعورنا الجماعي مع الغير. هذا ما يعبر عنه هيدغر بقوله ” إن الوجود بدون الآخرين هو نفسه صورة من الوجود مع الآخرين”.
وعلى غرار تصور هيدغر لعلاقة الذات بالغير يرى سارتر أن الآخرين على الرغم من كونهم يشكلون تهديدا لخصوصياتي فإنهم يمثلون وسيطا ضروريا ومرجعا أساسيا لمعرفة أناي . فعبر الآخر فقط أستطيع أن أدرك أن لدي وجود موضوعي وواقعي وعبر الآخر فقط أتمكن من تحقيق معرفة حول ذاتي.
ويبقى أن نشير بحسب سارتر أن علاقي الأنطولوجية بالغير تقودني دائما إلى الرغبة في تجاوزه والتعالي علية ومفارقته وجعله موضوعا لتأملي الخالص، نفس الرغبة نجدها لدى الغير نحوي والمتمثلة في رغبته التعالي علي وجعلي موضوعا لتأمله الخالص. فالأمر هنا لا يخرج عما سبق وأن أكده هيغل عن منطق من يشيئ من ومن يحول من إلى موضوع، فهناك منطق صراعي قائم بيني وبين الآخر.
وأحد مظاهر الصراع القائمة بيني وبين الآخر يجسدها سارتر في تجربة النظرة . فالأشخاص الذين أنظر إليهم أقوم بتحويلهم إلى أشياء وإلى موضوعات للدراسة والتقصي. إنهم يصبحون مضطهدين بأحكام القيمة التي أصدرها عليهم، وفي ذات الوقت عندما ينظر إلي شخص فإنني أحس بانزعاج شديد بأن حريتي مهددة من طرف الآخر. ويتجلى ذلك بوضوح في كون الإنسان عندما يكون لوحده يتصرف بعفوية وتلقائية وحرية دون قيد حتى تتجمد حركته وأفعاله وتفقد عفويتها وتلقائيتها.
فأنا في وضعية خجل وخوف من أن أفقد حريتي ، بمعنى أن أأاصبح موضوعا أو شيئا يتصفحه الآخر. وهنا يظل الآخر بالنسبة لي يشكل الآخر جهنم. لكن مع ذلك فإن هذا الصراع يظل ضروريا من أجل أن تحقق الأنا وعيا بذاتها بوصفها ذاتا حرة ومتعالية وتلقائية.
يبدوا أن هذه الخلاصة التي انتهى إليها كل من هيغل وهيدغر وسارتر لم تخرج في جانب كبير منها عن تلك الرؤية التقليدية الميتافيزيقية التي ترى إلى أن الوجود موزع إلى أزواج من الثنائيات المتصارعة فيما بينها ( خير/ شر، ذات/ موضوع، أنا/ أخر، ظاهر، باطن). بينما علاقة الأنا بالآخر كما يقول ماكس شيلر هي علاقة كلية أي علا موحدا لا يقبل التجزئة ولا الانقسام إلى ذات وموضوع وعبد وسيد “فإن أول ما ندركه من الناس الذين نعيش معهم ليست أفكارهم ولا أجسادهم ولا نفوسهم فإن أول ما ندركه هو مجموعة لا تنقسم ولا تتجزأ وعلينا ألا نسارع إلى تجزئتها إلى شطرين”.