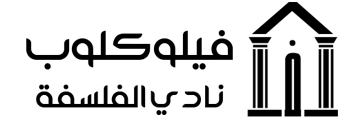تعليمات 2 شتنبر 1925 لأناطول دومونزي في تدريس الفلسفة
- تعليمات 2 شتنبر 1925 لأناطول دومونزي
- تقديم وترجمة: عبد الغني التازي
مما لا شك فيه، أن القارئ بمجرد الاطلاع على زمن وتاريخ هذه التعليمات، وانتمائها إلى المنظومة التعليمية الفرنسية، لابد أن يتساءل:
1 – ما الفائدة من قراءة تعليمات –خاصة بتدريس الفلسفة- تعود إلى سنة 1925؟
2 – ماذا يمكن أن نستخلص –كدروس وكعبر- من هذه التعليمات المرتبطة أساسا بالنظام التعليمي الفرنسي؟
سؤالان، من الأكيد، أن لهما مشروعيتهما النظرية والعملية، ويمكن أن نقدم بصددهما، بعض عناصر الإجابة.
بالفعل، هي تعليمات تنتمي زمانيا إلى مرحلة نسبيا قديمة –بداية القرن 20- لكنها مع ذلك، مازالت كما يقولL.L.Grateloup ، تحتفظ بكل عنفوانها وراهنيتها[i].
كما أنها، ما فتئت توجه، أو على الأقل، تشكل مصدر توجيه للتعليم الفلسفي الفرنسي[2].
من جهة أخرى، هي تعليمات –وهذا أمر جد هام- تأتي في سياق تاريخي مليء بالدلالات الأساسية لفهم الشروط الضرورية لترسيخ تعليم فلسفي له مكانته وقوته.
وفي إطار الحديث عن هذه التحولات التاريخية[3]، يمكن الإشارة “أساسا” إلى بروز الثانويات في فرنسا في سنة 1802، ودخول التعليم الفلسفي إلى هذه الثانويات انطلاقا من سنة 1809، وهي السنة التي يمكن اعتبارها لحظة ميلاد التدريس الفلسفي في الثانويات الفرنسية. وقد صاحب ذلك، العمل على تنويع قنوات نشر الفكر الفلسفي وتعميمه في كل الشعب والمعاهد. لتبدأ بعد ذلك، مرحلة أساسية تتميز بتأثير ف.كوزان V.Cousin وجماعته على التعليم الفلسفي الفرنسي. وقد صاحب ذلك، الاهتمام بجودة التدريس، وتكوين المدرسين وخلق شهادة التبريز (سنة 1828). كما تم الحرص والتشديد على حرية المدرس وصلاحيته المطلقة في اختيار أسلوب التدريس، والقضايا المعالجة، انطلاقا من المقرر (سنة 1880) كما تم إدخال تدريس الفلسفة إلى كل الجذوع المشتركة.
لقد كان من أهداف ونتائج هذه التحولات، جعل تدريس الفلسفة تدريسا مؤسسيا، مع إعطاء الفلسفة وتدريسها، وصفا متميزا داخل النسق التعليمي الفرنسي، وليس النظر إليها كمجرد مادة مدرسية كباقي المواد المدرسية الأخرى.
إن هذا التأسيس المؤسساتي لتدريس الفلسفة، يشكل النقطة الأساسية التي سيركز عليها أناطول دومونزي، في بداية تعليماته: “إنه من بين السمات المميزة للتعليم الثانوي الفرنسي هو تأسيس –في إطار دروس- لتعليم فلسفي أولي، لكن شامل وواضح، تخصص له سنة بكاملها”. والتأكيد على هذه السمة الأساسية، يهدف إلى ترسيخ تلك العلاقة الوثيقة بين تدريس الفلسفة وبين اختيارات المجتمع والدولة الفرنسيين. أي أن تعليم الفلسفة هو تعليم وطني إلزامي، متواجد في كل الشعب المدرسية، يقوم به أستاذ متخصص ويشكل موضوع اختبار كتابي إلزامي في الباكالوريا وبالنسبة لكل الشعب[4].
إلا أن التحولات التاريخية التي عرفها تأسيس تدريس الفلسفة، لم يكن ليسير دائما في خط تصاعدي. إذ عرف لحظة انكماش وتقهقر، خصوصا في عهد الوزير FORTOUL (سنة 1851)، المنتمي إلى المرحلة الثانية من الإمبراطورية الفرنسية (التي أعقبت الانقلاب)، والذي ألغى تدريس الفلسفة، وشهادة التبريز إرضاء للكنسية واليمين[5] وهو الحدث الذي يشير إليه “دومونزي” قائلا: “ولسنا مطالبين هنا بتبرير هذه المؤسسة [تدريس الفلسفة]: فالآن هي ليست محور نقاش ولم تكن مهاجمة إلا من طرف حكومات معادية لكل تصور ليبرالي“.
إن تعليمات “دومونزي” ليست إذن إلا انخراطا في تقليد فرنسي مؤكد على هذا التأسيس المؤسساتي لتدريس الفلسفة، كاختيار محايث للنظام الديمقراطي. واعتبار تدريس الفلسفة الضامن الحقيقي لهذا النظام. لذلك يشير دومونزي، في معرض حديثه عن أهمية الفلسفة بالنسبة للتلميذ، إلى الدور الأساسي لهذا التدريس: “فإنه من الأفضل أن يكونوا مسلحين بطرق التأمل، وبعض المبادئ العامة للحياة الثقافية والأخلاقية التي تقدم لهم سندا، في هذا الوجود الجديد، وتجعل منهم رجال مهنة قادرين على الرؤية فيما وراء المهنة. وأن تجعل منهم مواطنين قادرين على ممارسة الحكم الواضح والمستقل الذي يتطلع إليه مجتمعنا الديمقراطي”. إضافة إلى ما سبق، فإن هذه التعليمات، تعليمات وزارية وتحمل توقيع وزير، وتقدم صورة شاملة لكل ما يتعلق بتدريس الفلسفة. لكنها، في نفس الوقت، تعطي توضيحات وتدقيقات ذات قيمة نظرية وعملية جد عالية.
إن تعليمات “دومونزي” عندما تؤكد على ضرورة وضع كلمة الحرية في مستهل التعليمات، فإنها بذلك تؤكد على قيمة فلسفية-إنسانية، يجسدها الدرس الفلسفي ويمارسها كل من الأستاذ والتلميذ. وعبر هذه القيمة يتم التفكير في كل ما يرتبط بالدرس الفلسفي من: الكتاب المدرسي، وطرق الإنجاز، والموقف من إملاء الدروس، وقيمة ووظيفة الفروض والامتحانات وعروض التلاميذ…إلخ.
إنها تعليمات تبني نسقا متكاملا: غايته الحرية وما يرتبط بها من حس نقدي، وتحمل للمسؤولية، وانخراط في زمانية المجتمع…إلخ، وفكرته الأساسية التلميذ/المواطن.
أخيرا، إنها تعليمات وزارية، تحمل توقيع وزير، تجمع بين الشمولية، والدقة والوضوح. وهي شروط ضرورية لتسهيل فعل تدريس الفلسفة وفقا اختيارات مجتمعية وسياسية واضحة المعالم.
تعليمات 2 شتنبر 1925
إنه من بين السمات المميزة للتعليم الثانوي الفرنسي، هو تأسيس –في إطار دروس- لتعليم فلسفي أولي، لكن شامل وواضح، تخصص له سنة بكاملها. ولسنا مطالبين هنا بتبرير هذه المؤسسة: فهي الآن ليست محور نقاش، ولم تكن مهاجمتها إلا من طرف حكومات معادية لكل تصور ليبرالي. لذلك سوف نقتصر على التذكير بالخدمة المزدوجة والمنتظرة منها.
من جهة، يمكن التعليم الفلسفي الشباب من الاستيعاب الأفضل، بواسطة هذا الجهد الثقافي الجديد، لحمولة وقيمة الدراسات العلمية والأدبية ذاتها، والتي اهتموا بها لحد الآن، كما يمكنهم من بلوغ التركيب.
من جهة أخرى، وفي الوقت الذي سيغادرون فيه الثانوي لولوج الحياة، ويهيؤون أنفسهم لمهن مختلفة بواسطة دراسات متخصصة، فإنه من الأفضل، أن يكونوا مسلحين بطرق التأمل، وببعض المبادئ العامة للحياة الثقافية والأخلاقية التي تقدم لهم سندا في هذا الوجود الجديد، وتجعل منهم رجال مهنة قادرين على الرؤية فيما وراء المهنة. وأن تجعل منهم مواطنين قادرين على ممارسة الحكم الواضح والمستقل، الذي يتطلع إليه مجتمعنا الديمقراطي.
روح التعليم الثانوي:
لهذا نريد أن تكون كلمة حرية مدونة في مستهل هذه التعليمات.
إن حرية الرأي، ومنذ القديم، قد تم ضمانها للاستاذ، إلا أنها تبدو الآن متعارضة مع طبيعة التعليم الفلسفي ذاته. لا شك أن هذه الحرية، تضم في ذاتها مجموع التحفظات التي تفرض على الأستاذ فطنتها وحذرها البيداغوجي. أي، بشكل عام، الاحترام الواجب على الأستاذ اتجاه الحرية والشخصية الناشئة للتلميذ. إن الأستاذ عليه ألا يتجاهل بأنه بصدد التعامل مع عقول فتية ولينة، وغير قادرة بشكل تام على مقاومة تأثير سلطته، ولهم القابلية للانجذاب نحو الأشكال الطموحة والأفكار المتطرفة. إن الشباب غير مزود بعد، بالعلم والتجربة الذاتية، وينكب إراديا على المذاهب التي تبهره بحداثتها أو بخصائصها الحادة.
إن على الأستاذ مساعدة الشباب للمحافظة على التوازن، بمراقبتهم لما فيه مصلحتهم. فكما أن لا أحد ينكر على الأستاذ حقه في تبليغ خلاصاته الذاتية، حول الأسئلة المتنازع فيها، واقتراحها على التلاميذ؛ فكذلك، لا يمكنه أن يتركهم جاهلين بالطبيعة الحقيقية للمشاكل، وبالأسباب الرئيسية التي استندت عليها المذاهب التي يرفضها وبالاختيارات التي تفرض ذاتها على كل إنسان في زماننا هذا.
إن معنى الحرية ذاته، يجب أن يجنبنا كل دوغمائية. وبالنسبة إليهم، فالتلاميذ يتعلمون داخل قسم الفلسفة، حرية الفعل والتأمل، بل يمكن القول، إن هنا يكمن الموضوع الخاص والأساسي لهذا التعليم. ومما لا شك فيه، فإنه يجب عدم تجاهل القيمة الداخلية للمعارف التي سيقدمها لهم. ومن تم، واعتبارا لطبيعة هذه الدراسات ومحدودية سن التلاميذ، فإنها دراسات لها أساسا قيمة تربوية، بمعنى أنها جديدة بالنسبة إليهم، إلى درجة إدهاشهم في البداية وأحيانا تحيرهم. ومع ذلك، فإنها دراسات لها روابط عميقة مع مكتسباتهم السابقة، علمية أكانت أم أدبية، وأيضا مع تجاربهم النفسية والأخلاقية. من جهة أخرى، فالشباب مطالب بفهم جيد، وبتأويل عميق لما يعرفه سابقا، وبنوع من الوعي الأكثر وضوحا وشمولية. وفي جميع الحالات، فإن الأستاذ عليه أن يتموضع وفق هذه النظرة، خلال الفترة التمهيدية.
لا يجب على الدهشة التي يشعر بها الشاب، عند اللقاء الأول مع الفلسفة، أن تتحول إلى إحباط، بل يجب أن تكون بالخصوص، وكما شعر بها سقراط بعمق، دهشة معرفة ما كنا نجهله، وما كنا نعتقد أننا نعرفه، وأن نكتشف الغياهب والمشاكل، حيث كنا نعتقد أننا في حضرة الأفكار الواضحة والوقائع البسيطة.
لنقل، بأنه داخل هذا المجال، أكثر من غيره، يرتكز أولا الحس البيداغوجي للأستاذ على كيفية التعامل مع مبدأين متعارضين. من جهة، عليه أن يكون متشجعا بنوع من الثقة في ذكاء، التلاميذ، والعمل على تجلي هذا الذكاء. فليس هناك أي مشكل أو تصور غامض بذاته، كما قد يحصل في بعض العلوم المتخصصة. وهذا الأمر مشروط، بشكل كبير، بمهارة الأستاذ في التعبير، وتقديم الأفكار الفلسفية، وجعلها قابلة للإدراك من طرف العقول المتوسطة، كما أن هناك طريقة منفردة، مجردة أو معقدة لعرض هذه الأفكار، مما يؤدي إلى جعلها غير مدركة، أو على الأقل، عقيمة حتى بالنسبة للأذكياء.
وبالمقابل، فإن الأستاذ عليه عدم تجاهل ذلك الجزء البسيط من نضج وتجربة دماغ له ثمانية عشر سنة. عليه أن يحتاط، بشكل خاص، مما يمكن أن نسميه “الوضوح اللغوي” للأشكال، لأنه، كما أن طفلا يعتقد بإمكانية فهم “حكاية لافونطين” التي يحفظها عن ظهر قلب، فإن الفيلسوف-الشاب، يتخيل إراديا أن بإمكانه إدراك الفكرة لأنه يعرف الألفاظ التي تتكون منها، في حين، إذا كانت الكلمات نادرا ما لها معنى ثابت ومطلق، كما يؤكد على ذلك اللسانيون، وإذا ما كانت حمولتها الحقيقية مشروطة بالسياق الذي يحيط بها؛ فالحري بهذه الملاحظة أن تطبق أكثر على اللغة الفلسفية، التي تصبح غير دقيقة عندما تأتي من اللغة المشتركة، وسيئة التحديد عندما تصبح لغة تقنية.
لذلك، لا شيء أكثر رعبا في التعليم الفلسفي، من الإفراط في التجريد. إن الشباب، كما أشرنا، يرضون بكل طواعية ويقنعون بيسر. والأستاذ سيكون له إذن هم دائم، وهو تجنب كل “سكولائية”، وكل نقاش حول الأسئلة التي لم يتم توضيحها، والتي لها معنى محسوس وعلاقات مع التجربة والواقع. وعليه أن يبذل ما في وسعه ليعبر بألفاظ مألوفة، أو على الأقل، بلغة الحياة العادية المشتركة، أن يعبر عن الحق، والتاريخ والعلم الوصفي والصيغ العامة التي يتوصل، من خلالها، التفكير الفلسفي إلى تقديم بعض الإشكالات.
وعندما يصل التلميذ -الذي تدرب سابقا على استعمال هذه التراكيب الفلسفية، وأصبح بإمكانه أن يفتخر قليلا بهذا المكتسب الجديد- عندما يصل إلى استعمال هذه اللغة بنوع من الرضى، آنذاك علينا التيقن مما يضع في إطار هذه اللغة الخاصة، والتزامه بترجمتها إلى وقائع، وأمثلة وتطبيقات، ليس هناك وقائع دون أفكار. هذا بالضبط ما يميز الثقافة الفلسفية، لكن أيضا، لا أفكار بدون وقائع. إنها القاعدة البيداغوجية التي تفرض ذاتها، إذا ما أردنا أن يكون هذا التعليم سهل المنال، وخصوصا، أن يكون مفيدا، بالنسبة لعقول مبتدئة.
بعد ذلك، وهذا جد أساسي بالنسبة للأستاذ، فبدل مناقشة “الأطروحات” ومناظرة المدراس، سيكون الاهتمام منصبا على وضعية الأسئلة ذاتها، والتي يجب أن تقدم، ليس كإنتاج مصطنع لتقليد خاص بعالم الفلاسفة، ولا كنتيجة لتنافر بعض “المقولات”، أو بعض الأجزاء المأخوذة كديكور لبعض أسماء الأنساق، بل كنتاج للواقعة ذاتها، أخلاقية أكانت أو فيزيائية، ونتاج أيضا للغياهب المقدمة إلى الذي يريد أن يجعلها معقولة. إن “المذاهب”، عندما نعتقد في فائدتها، ومن تم نعمل على جعلها معروفة، تظهر إذن كتعبير عن مختلف وجهات النظر الممكنة حول القضية موضوع الدراسة. إن المذاهب تساعد على تصنيف الأفكار المستخلصة من الأشياء ذاتها، وآنذاك تكتسب كل قيمتها.
ما من شيء قادر على تزييف الفكر، وتغيير اتجاه التأملات الجادة وخلق النفور عند أصحاب العقول الصلبة، بحيث لا يرون فيها سوى جدل عبثي، إلا تلك “الاستعراضات” اللامتناهية للآراء المتناقضة حول مشاكل لم نكد ننتهي من النطق بها. إن مثل هذه “الاستعراضات” الضعيفة، من الناحية التثقيفية بحكم إيجازها الذي لا يمكن تفاديه، وبحكم الاستحالة التي تصادفنا، في كثير من الأحيان، عند الإلحاح على الدراسات المباشرة للنصوص الأصلية؛ كل ذلك يجعل هذه الاستعراضات تشحن الذاكرة دون أن تنور الفكر.
من أجل هذا، لن يهمل الأستاذ تلك الفرص الجديدة، التي يمنحها له المقرر، لموضع الثقافة الفلسفية في علاقة مع المشاكل الواقعية التي تفرضها الحياة الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية، المرتبطة بالمحيط الذي على الشاب العيش فيه. إذا كان الشاب، ليس لديه إحساس بأن التأمل الفلسفي يتحرك في عالم آخر، بدون علاقة مع العلم والحياة، فلماذا نخشى من إثارة مشاكل”الراهن” أمامه؟ أليس من الأفضل توضيحها على ضوء الفكر المشرق النزيه، عوض انتظار اللحظة التي ستحل فيها المشاكل، بالنسبة إليه، داخل الانجذاب إلى الانفعالات، وتحت تأثير الأحكام-القبلية الاجتماعية، وتحت ضغط المصالح، وكل أسباب الزيغ، التي لا زال كل الوقت أمام تلميذنا للنجاة منها. لا يتعلق الأمر بإدخال السياسة في أقسامنا، بقدر ما هو حديث عن الشروط الاقتصادية للحياة المعاصرة، وعن أعمال التآزر والحماية الاجتماعية. أية لحظة تكون صالحة لشبابنا لبداية اكتساب الإحساس، والإحساس المتأمل لكل مهامه المستقبلية، سوى في هذا السن حيث الروح، بالطبيعة، أكثر عطاء. لكن، وفي نفس الوقت، هو في حاجة ماسة إلى الحماية ضد الطيش والطوباوية.
المنهج:
إن الأستاذ حر في منهجه، كما هو حر في آرائه. والتعليمات الحالية لا تعمل، إلا على تأكيد التعليمات السابقة: فنفس المنهج غير ملائم لكل الأسئلة ولا لكل الأساتذة. ووصفة الدرس، كما تعبر عن ذلك، بصراحة المقررات، متروكة لما يناسب الأستاذ. فكما أن أستاذا له أسبابه الخاصة للتقريب بين الأسئلة، فإن الآخر، له ما يبرر الفصل بينها، أو تناول درسه من هذه الزاوية دون الأخرى. بل قد تكون الممارسة مفيدة عند اتباع جزئين مختلفين للدرس الواحد بشكل متواز. مثلا، السيكولوجيا والأخلاق، المنطق والميتافيزيقا…إلخ. فالتلاميذ سيجدون تنوعا أكثر، والأستاذ سيجد سهولة بالنسبة لبعض المقارنات المفيدة. أما الاستثناء الوحيد المعبر عنه سابقا، والذي علينا تأكيده، هو إملاء الدرس. لكن، قد يكون مفيدا إملاء، إما درس ملخص بعد الحصة، أو مجمل مختصر يعطى قبل العرض الشفاهي، يسمح للتلاميذ بمسايرة أحسن، وذلك بإدراك التصميم والتمفصلات التي يضمها الدرس. إنه المكمل الضروري للدرس الحر، والملائم لربح الوقت. إن مثل هذا المجمل المختصر، والمختزل في بضعة أسطر، من الممكن أن يوزع على التلاميذ، بعد استنساخه، وذلك من أجل تجنب كل إملاء. أما بالنسبة للدرس ذاته، فمن الأكيد أن المنهج السقراطي الخالص، له إيجابيات بيداغوجية. لكن يجب ألا ننسى أنه المنهج الأصعب من حيث الاستعمال. فهو منهج يتطلب من الأستاذ خصائص استثنائية، من حيث الرزانة في القول، وصرامة في الفكر ووضوحه، ورشاقة الروح لاستثمار الإجابات وتجنب الاعتراضات، وأخيرا، فهو منهج يشترط توفر الأستاذ على سلطة كبيرة على التلاميذ. من جهة أخرى، هو منهج لا يلائم إلا الأقسام ذات أعداد قليلة نسبيا، وتضم عددا كافيا من تلاميذ أذكياء ومتحمسين وقادرين على قيادة الآخرين. أخيرا، وحتى لو توفرت كل هذه الشروط، فإنه في جميع الحالات منهج بطيء. ومما لا شك فيه، فهو مفيد ليقظة الفكر. لكن، في خضم الضغط الكبير للمقررات، فهو منهج ينحو نحو تغيير اتجاه الأساتذة. إنه منهج، على الرغم من قيمته النظرية، لا يمكنه إذن، أن يكون عمليا. ولا يمكن النصح به، بشكل عام، دون تحفظات.
ومع ذلك، وحتى لو أننا تبنينا منهجا آخر، فإنه من الضروري الاحتفاظ ببعض إيجابيات المنهج السقراطي. وحتى عند صياغة الدرس على شكل محاضرة، فالأستاذ مطالب بإشراك التلاميذ ما أمكن في حركية فكره، وذلك اعتمادا على البحث الذي سيقدم لهم على أنه بحث في الحاضر. إن بعد وصورة هذه المشاركة للقسم مع الأستاذ، يمكنها أن تتنوع بشكل لا نهائي. وستصبح أكثر اتساعا وشمولية، عندما يتعلق الأمر بمشاكل نفسية أو أخلاقية، يستطيع الشباب، أو يعتقدون إمكانية تقديم بعض الإضاءات حولها. وقد تكون المشاركة جد محدودة عند معالجة المشاكل الأكثر تعقيدا أو تقنية. لكن، قد يكون دائما بالإمكان ومن المفيد، على الأقل من أجل الاسترخاء وإعادة تجديد الانتباه، أن يتدخل الأستاذ، من وقت إلى آخر، ليتحقق من أن تلاميذته يفهمونه ويسايرون درسه. وسيقوم بإثارة بعض التقاربات بين الأفكار، والعمل على اكتشاف الأمثلة، أو أيضا، حيث يعرف أنه يتعامل مع تلاميذ أذكياء وجادين، سيعمد إلى إثارة الأسئلة والاعتراضات. لكن، لا ينبغي نهائيا أن يكون درسا على صورة محاضرة يكون فيها المستمع سلبيا. وكيفما كانت طريقته في العمل، فإن الأستاذ لن يؤدي وظيفته، بشكل حقيقي، إذا لم يضع التلميذ في وضعية تفكير فعلي اتجاه ما يقدمه أو يعرضه أمامهم، وإذا لم يتحقق من نجاحهم. من جهة أخرى، فإنه سيعمل على إعادة وضعهم في الجهد، وغالبا ما يكون الأمر صعبا، لمسايرة فكر يأتيهم من الخارج. لكن، عندما يقوم باستدعاء تلقائيتهم الثقافية، فإن الأمر سيكون بالنسبة إليهم، أكثر متعة كما أنه أكثر فائدة، إن الأستاذ، عندما يظهر أكثر ترحيبا بالأسئلة والأجوبة، أحيانا الساذجة أو المنحرفة لفكر مبتدئ، وعندما يعمل على استخلاص الأحسن وتجنب أي إقصاء أو إحباط عن طريق اللامبالاة، خصوصا بواسطة التهكم اتجاه أية محاولة متواضعة لتأمل شخصي؛ في الوقت الذي يعطي فيه مظهرا مستحسنا للطيبوبة، فإنه يخلق الحياة في الفصل، ويسمح بالتواصل بين العقول، ويطور في الوقت ذاته، الشخصية والحس الاجتماعي للتلاميذ. إنه بذلك يؤدي عمل المربي.
إن استعمال الكتاب المدرسي، لا يمكن، في حد ذاته، أن يؤسس طريقة مقبولة. وعندما يختبئ الأستاذ وراءه، فإنه يفقد سلطته ويتنازل عن شخصيته. لهذا، لن يكون اللجوء إلى الكتاب المدرسي إلا بشكل عرضي. سواء، من أجل إتمام درسه حول نقطة هو ذاته لا يملك حولها أي فكر أصيل، أو من أجل ربح الوقت. وحتى في حالة “الدرس المكتوب على الآلة الكاتبة” فإن عمله الخاص هو الذي يضعه بين يدي التلاميذ. لكن هذا العمل لن يكون دون سلبيات. فهناك خطورة أن يظل الأستاذ سجين عمله/ملخصه، ويصبح محرجا عند محاولة القيام بالجهد الهادف إلى التجديد، والذي يفرضه دائما تعليم حسي بشكل فعلي. أما التلميذ، من جهته، قويا بفعل النص الذي يملكه، لن يكون مباليا بما يجري في القسم. إن مثل هذه الممارسة، لن تكون إذن مفيدة لا للتقدم الذاتي الشخصي ولا للسلطة البيداغوجية للأستاذ، فلا شيء يقوم مقام التبليغ المباشر والحي للفكر بواسطة الكلام، حيث التواصل الحقيقي بين العقول. وفي الوقت الذي يكون فيه الأستاذ ملزما بتقديم فكرة على شكل محاضرة، فليس من المستصاغ ألا يسجل التلاميذ أية عناصر فقط. وسنجد أنفسنا، بالفعل، مضطرين إلى تكرار، تحت صورة إملاء جد واسع، لما قلناه بنوع من الشمول والحرية. مما ينتج عنه ضياع مؤسف للوقت والفائدة. وفي ظل هذه الشروط، هناك خطورة أن ينسى التلميذ التحليل الذي سمعه –كمستمع سلبي- بدون أن يكتب أو يتكلم. ومن الدرس لن يحتفظ إلا بملخص ناقص، ويظن، دائما، بأنه كاف لإرضائه. هناك كثير من الأساتذة يبدون تشككهم، بغير حق، اتجاه عملية أخذ عناصر فقط، من طرف التلاميذ. ويمكننا التأكيد، باسم التجربة، أنه بالعكس، كل التلاميذ بإمكانهم بلوغ ذلك بشكل مناسب. ويكفي، في البداية، أن يعمل الأستاذ على تدريب تلاميذه، وأن يحافظ دائما في ارتجاليته الأكثر جدية، على هذا الوضوح في البيان، ونبرات الكلام، مع التنويع في الإيقاع الذي يكون تارة بطيئا وتارة أخرى سريعا؛ وذلك حسب أهمية التطوير والذي بفضله يميز المستمع بين الأساسي والثانوي، وبدون كتابة اختزالية sténographie، يتابع الدرس بإخلاص وذكاء. إن هذه العناصر –المأخوذة على شكل نقط- عندما يتم مراجعتها وإتمامها بعد الفصل، وفي الوقت الذي ندرس فيه الدرس، سيكون للتلميذ، وبدون ضياع للوقت، مجموعة من الصياغات الفعلية التي ستصبح أداة عمل خاص لتهييء الباكالوريا. هذا الدرس، على الأستاذ مراقبته بشكل دائم. وعندما نقول مراقبة فلا يعني ذلك التصحيح، لكن مجرد أخذ عينة، وحراسة دائمة لعمل التلميذ، إذ بدونها قد يتهاون حتى المجدون. إن المراقبة من الوظائف البيداغوجية الأكثر أهمية، ونأسف لملاحظة إهمالها أحيانا.
إن القراءة هنا، وربما أكثر مما هي في جانب آخر، التكملة الضرورية للتعليم. فالأستاذ مطالب بتكوين مكتبة فلسفية في فصله مطعمة بإسهامات التلاميذ، مع تشجيع هذا التضامن بين الأجيال المتعاقبة. كما عليه العمل على تطوير ذوق الدراسة والبحث الشخصي، وأن يوجه منهجيا اختيار القراءات. إن حب الاكتشاف عند الشباب، على الرغم من أنه قد يؤدي به إلى نوع من الإضافات، فلن يكون دائما متجها نحو ما هو أكثر فائدة واستيعابا. واعتمادا على المحتويات، يجب دائما تكييف القراءات مع المواد المدرسية وربط صعوباتها مع الذكاء ودرجة تهييء الفرد.
ومن الأكيد أن الفرضInterrogation في درس الفلسفة، لن يكون مجرد استظهار للدروس. بل على الأستاذ استعماله للتحقق من درجة مراجعة التلاميذ ودراستهم للدرس خارج الفصل. لكن، وهذا هو الأساسي، التحقق من فهم الدرس واستيعابه. إن فرضا جيدا هو ذاك الذي يعمل على إعادة تجديد وتتميم الدرس، واستخراج الأفكار والخلاصات الأساسية، وعلى إثارة الأسئلة، والاعتراضات وردود الأفعال الشخصية.
ويمكن أن نمنح لعروضExposés التلاميذ مكانا: مكانا خفيا على أي، لأنه بالنسبة لهذه النقطة سيكون علينا الاعتماد، ليس فقط على جزء يسير من التجربة حتى عند المتفوقين، بل وأيضا على جزء بسيط من الثقة التي يكنها صديق لأصدقائه. وأخيرا، يمكن أن يكون العرض، بشكل عرضي، تمرينا مفيدا، ونحن لا نريد أن نحظره، كما لا نريد أن ننصح به دون تحفظات. إن الأستاذ يظل هو الحكم. ويكون من المستحسن أن تأتي المبادرة من التلاميذ: عندما يكون هناك اهتمام شخصي بسؤال ما، يريد التلميذ المساهمة بأفكاره؛ كما قد يشعر تلميذ آخر بقيمة مؤلف، ويجب أن ينقل إلى أصدقائه فائدة قراءته. إننا لا نريد أن نحبط هذا الحماس الثقافي. وبالنسبة للامتحان-الخالص- يمكن أن تضاف بعض التمارين المصاحبة والمكملة له. مثلا، يمكن أن نضع سؤالا يصبح محور تفكير جماعي، ومحادثة، ونوع من المقالة الشفهية، حيث يدلي كل واحد برأيه، وحيث يمكن أن تنبثق مجادلة داخلها، تحت توجيه وتحكيم الأستاذ بحيث يسعى خصمان إلى الدفاع عن أطروحتهما. إننا لا نسعى، في إطار هذا الكل، إلا إلى خلق الإحساس بتنوع التمارين التي يضمها قسم الفلسفة، وهي تمارين قادرة على إدخال الحياة إلى هذا القسم، والتأكيد على الفائدة المباشرة التي يمكن أن يحصل عليها التلاميذ. فالأستاذ لن يكون المتكلم الوحيد، ولن يفرض أفكارا جاهزة بدون المساعدة الحية للمستمعين. إن التعليم الفلسفي سيفقد أهم شيء من قيمته، إذا ما قدم بلا مبالاة، وسلبية كمجرة مادة للامتحان.
إن الإنشاء الفلسفيDissertation عليه أن يهدف إلى غاية مماثلة. فالمواضيع سيتم اختيارها بطريقة تسمح باستعمال الدرس تحت خاصية جديدة، لكن بإقصاء كل إعادة إنتاج حرفي. إذا كنا، حتى في الباكالوريا، نهدف شيئا فشيئا إلى تجنب مجرد “سؤال الدرس” الأكثر صلاحية للذاكرة الخالصة، ونفضل وضع “إشكال” فلسفي جديد يتطلب تدخل التأمل الذاتي الذي سيقدم كل ما هو قادر عليه، فبالأحرى أن يكون الأمر كذلك في الفصل. وهنا، وهذا بديهي أيضا، لا يمكن للإنشاء أن يختزل إلى مجرد التأكد من المعلومات المكتسبة: على الإنشاء أن يدفع التلاميذ نحو بلورة الأفكار، وعرضها بنظام والقيام بالتركيب والكتابة.
إن الإنشاء هو التحضير الأكثر ذاتية، والأكثر تعبيرية عن عمل تلميذ الفلسفة. فبواسطته يمكن قياس ذكائه بشكل تام. لهذا، من اللازم أن يكون أكثر تكييفا. ويكون من المستحسن، خصوصا في المرحلة الثانية من السنة، تقديم مواضيع مختلفة، ليس فقط من أجل الإكثار من الأسئلة المعالجة، لكن أيضا، من أجل التدرج والتنويع في الصعوبات التي ليست متجانسة بالنسبة للكل. إن عملا ناقصا يكون أقل فائدة، ومن المرغوب فيه أن يجد كل واحد منا نفسه أمام مهمة، يمكنه القيام بها على أحسن وجه، ويحس اتجاهها بنوع من الذوق. ومن أجل السبب ذاته، ليس من السيء العمل على تهييء المواضيع المقترحة، على الأقل بالنسبة للتي هي أكثر صعوبة، بهدف استشفاف المعنى الحقيقي والإحساس بالفائدة. إن هذا التهييء، الذي نمارسه باستمرار، بالنسبة لتمارين مدرسية أخرى، هو مفيد هنا فائدة أكبر.
إن من الصعوبة بمكان، صياغة نص يطرح بالضبط السؤال الذي يوجد نصب أعين الأستاذ، فبالأحرى، بالنسبة لمبتدئين غالبا ما يخطئون في معالجة السؤال، ويجانبون الصواب ويتناولون التفاهات التي لا فائدة منها، ويهدرون وقتهم في دحض أطروحات مستبعدة أو خارج النقاش أو يستندون على فرضيات شائعة لكنها اعتباطية. إن العناية الأولى للأستاذ، يجب أن تكون موجهة نحو تجنيب التلاميذ هذه الانحرافات، بأن يعلمهم تحليل نص أشكال ما، وتحديد وحصر السؤال. إذا كان المترشح في الامتحان يبقى وحيدا، فيجب أن نبدأ في منحه الطريقة التي هو في أمس الحاجة إليها في هذه اللحظة، وأن نوضح له كيفية تطبيقها. وعند الإنجاز، سيمسك الأستاذ بيده(*)، ليس فقط لتصحيح اللغة، بل عند التركيب، والذي هو في الفلسفة، يأخذ خاصية أكثر صرامة من باقي المواد الأدبية الأخرى. إن الأستاذ عليه أن يشترط، في الإنشاء الفلسفي، تقديم تصميم مصوغ بشكل مختصر. كما عليه تعليم إدماج السؤال بدل وضعه في الأول خاليا من كل تقديم: سيعود التلاميذ على تقديم الأطروحات التي يسعون إلى دحضها تحت الصيغة الأكثر معقولية وقوة، وهذا أمر، مرتبط في نفس الوقت بأمانة النقد وشرط لكل مناقشة متينة. وسيعمل الأستاذ على خلق الإحساس عند التلميذ، بشكل عكسي، بتناسب موقف حذر وموقف متواضع في الخلاصات.
إذا كان هناك اشمئزاز من رؤية شباب في سن السابعة عشرة يجزمون “بعجرفة” في مشاكل، أمامها قد تتردد عقول أكثر نضجا وصرامة؛ إلا أن ذلك ليس سببا في امتناع هؤلاء الشباب عن إبداء الرأي، والتعبير بوضوح عن قرار منسجم مع مناقشتهم.
إن التواضع الذي يسم سنهم لا يعبر بالضرورة عن صورة شكية وعن اللامبالاة.
إن كثرة الإنشاءات الفلسفية يمكن أن تتنوع حسب الظروف، وعدد، وقيمة التلاميذ والقراءات الشخصية التي يقدرون عليها. ويمكن أن نوافق، في بعض الحالات على التناوب بين تصميم بسيط وإنشاء كامل الشروط.
مادة التعليم:
إن مادة التعليم لا تستدعي إلا بعض الملاحظات: إلى هنا، فإن المقررات هي واضحة بشكل كبير. لكن بعض النقط مع ذلك، تحتاج ضرورة إلى توضيح. نلاحظ في البداية، أنه داخل المقرر الجديد لأقسام الفلسفة، هناك مكانة، إلى حد ما جد واسعة، قد أعطيت للميتافيزيقا. وإيجاز المقرر القديم حول هذه النقطة، يبدو أنه يدعو الأستاذ إلى الاكتفاء بالنزر القليل، هذا على الرغم من أنه يسمح له بالتوسع في أسئلة ذات طبيعة أكثر شمولية. ورغم ذلك، فقد قمنا هذه المرة، عند صياغة تصميم الدراسة وبنوع من الانتباه، بالعمل نحو خلق الإحساس بهذا الإسهاب، وذلك بالتقريب بين أسئلة كانت سابقا مشتتة، أو بأن نرجع لها خاصيتها الحقيقية.
هناك، بدون شك، صورة لميتافيزيقا تتجاوز سنة بكاملها، وربما شفاهية ولكنها لا تهدف إلى إحباط العقول الشابة. إن بعض الأساتذة، واعتبارا لهذه الخاصية الموجودة في هذا الجزء من الدرس، من الممكن، أن تدفعهم الرغبة بشكل طبيعي، إلى إعطائه فقط فائدة تاريخية واستذكارية. إلا أننا لم نعد في الزمان الذي تأسست فيه، بين الميتافيزيقا والعلم الوضعي، أطروحة مضادة حادة وجذرية بل هما يظهران الآن أكثر تقاربا. والفيلسوف لم يعد غريبا عن العلم ولا معاديا له؛ والعلماء، وبحكم التقدم الجديد، اكتسبوا بشكل عام إحساسا أكثر وضوحا وحيوية، بأن علمهم، في اللحظة التي لم يصل فيها بعد إلى حدوده القصوى، عليه أن يتوقف، لإثارة أسئلة، لا يمكن لا للملاحظة ولا للبرهنة الصارمة الإجابة عنها، والتي مع ذلك تفرض ذاتها على الفكر. إن الميتافيزيقا يمكن إذن، بل ويجب أن تعالج داخل فكر متناغم تماما، إن لم نقل متطابقا مع فكر العلم.
إن المقررات الجديدة، من جهة أخرى، لم تعتقد في وجوب تأسيس درس متميز لتاريخ الفلسفة. والأسباب التي كانت وراء الحذف لازالت قائمة. ليس السبب هو عدم وجود الوقت، الذي يطرح الآن بحدة أكثر من السابق. لكن السبب بالضبط، هو أن عرض الأنساق المختزلة فهي إيجاز مبالغ فيه، يفقد بذلك كل قيمة تربوية. وتحت التأثير المزدوج والمشوه لهذه الاصطناعية –التي لا يمكن تجنبها- وغياب التجربة عند الشباب، فإن المذاهب العليا لأفلاطون، وما لبرانش وليبنتز، توشك أن تظهر تحت صورة لا معقولة أو حتى كاريكاتورية. هل هناك من شيء أكثر إغضابا من مثل هذا الإحساس عند شباب علينا أن نعودهم على احترام التجليات الكبرى للفكر؟
إن هذا القول يبين كيف ينبغي فهم مقال المقرر الاختياري المحرر بالشكل التالي: “جدول المجموع الموجز المحدد للتتابع الكرونولوجي وعلاقات المذاهب والمدارس”. لا يتعلق الأمر هنا بتاتا، بعرض للأنساق، وإنما فقط، بعمل التنسيق التاريخي والنظري للمذاهب، والتي سيكون الدرس لحظة لخلق الفرصة للتعريف بها، لكن بطريقة مشتتة بالضرورة.
أما بالنسبة لـ”العرض التاريخي لاشكال كبير…إلخ” فإنه يستهدف بالضبط القيام، بالنسبة لنقطة محددة، بما لا يمكن القيام به بالنسبة لمجموع تاريخ الفكر؛ وتهيء الشباب، بهذا الشكل وكلما سمح بذلك التعليم الأولي إلى ما يمكن أن يكون عليه، في هذا المجال، المنهج والفائدة من دراسة تاريخية. لهذا أيضا، وداخل اختيار الأسئلة المتشابهة، فإن الأستاذ المهتم بالحمولة البيداغوجية لتدريسه، سيتجنب الوقوف عند مؤلفين من الدرجة الثانية. وسيهتم، بالمقابل، بأحد هؤلاء العظام الذين هيمن اسمهم على قرن بأكمله، وعلى كل الحركية الفلسفية، أو على بعض الأسئلة الجوهرية، التي كانت إجابته عنها قد حكمت كل توجه الفكر.
أخيرا، وداخل اختيار كل مادة تخصص، يكون الأستاذ قادرا على ربط إسهاماتها بالدوافع المستخلصة من الفائدة الثقافية للتلاميذ، ومع تلك التي تشتق من كفاءته الذاتية حول نقطة معينة. وذلك، لأنه من المفيد للأستاذ، كما بالنسبة للقسم، أن يكون قادرا –في شروط معينة- على منح الرضى لاختياراته، ويستمر في تثقيف ذاته في اتجاه محدد وأن يعطي للتلاميذ نموذجا للفكر الذاتي والعميق نوعا ما. من جهة أخرى، فليس من غير المفيد، الإشارة إلى أنه، وحتى داخل هذه الدراسة الخاصة بمشكل محدود، فإن الأستاذ لا يجب عليه إهمال مهمة التربية والثقافة الموكولة إليه. إذن، يجب عليه أن يحتاط من معرفة تكون غايتها في ذاتها، ومن ترف عبثي لأسماء وأعلام، وإشارات بيبليوغرافية، أو تقنية، أو مناقشات منهجية، لا يمكن إلا أن تؤدي إلى نفور جل التلاميذ بدون فائدة تخدم بالفعل تطور الفكر.
الخلاصة:
هذا هو التصور الذي لدينا عن التعليم الفلسفي. تعليم يسعى إلى تطوير ملكات التأمل عند الشباب، وجعلهم، بالضبط، في حالة استعداد للحكم، لاحقا، اعتمادا على أنفسهم؛ بدون لا مبالاة وأيضا بدون دوغمائية. أن نمنحهم، حول مجموع مشاكل الفكر والفعل، آراء تسمح لهم بالاندماج الفعلي في مجتمع زمنهم وفي الإنسانية. هذه، بشكل عميق، الوظيفة الخاصة بأستاذ الفلسفة. وليس هناك ما هو أجمل من هذا، ولا يمكنه أن يعطي فكرة أعلى وأوسع لهذا التعليم. لكن، ومن أجل أداء هذه الوظيفة، عليه أن يعرف أسلوب تكييف هذا الطموح الكبير مع الإحساس بتواضع الوسائل التي يتوفر عليها. وعليه أن يضع نفسه رهن إشارة العقول الجديدة، الواجب عليه جعلها ناضجة، وأن يكون محبوبا ليفهمهم، وأيضا ليخدمهم بشكل جيد, وأخيرا، عليه كسب ثقتهم بواسطة هذا الإخلاص، وهذه التلقائية التي تؤثر بشكل يسهل على الشباب.
[i]- L.L.Grateloup : Notices pédagogiques, Ed. Hachette, Paris, 1986, p6.
[2]- Encyclopédie philosophique universelle, sous la direction d’André Jacobs, vol. 1. Univers philosophique, Ed. PUF, 2ème, 1991, R.Brunet, p815.
[3]- Ibid, p808-814.
[4] – Ibid, p815.
[5] – Ibid, p815.
(*) المقصود هنا: المراقبة الجيدة للإنجاز.
———————————————