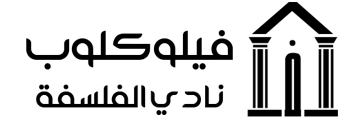محمد المغراوي: تدريس الفلسفة: أهو تدريس للتفلسف أم تدريس لتاريخ الفلسفة؟
محاور المقالة:
· 1- كانط (Kant) وتدريس الفلسفة.
· 2- جاك دريدا ((J.Derrida وإشكال تدريس ما لا يمكن تدريسه.
· 3- هيجل (Hegel) والمشروعية التاريخية لتدريس الفلسفة.
على سبيل التقديم
شكل تدريس الفلسفة، نقاشا حادا بين مجموعة من الفلاسفة و المنظرين التربويين، وترتبط هذه الإشكالية، بمسألة تبليغ الفلسفة وإيصالها إلى المتلقي بطريقة تحفظ خصوصية المادة، ضمن الممارسة العملية للدرس الفلسفي، إنها بمعنى آخر تساؤل عن بيداغوجيا ممكنة للفلسفة من داخل رحمها، وهي مسألة وإن كانت راهنة، إلا أنها تحيل على نقاشات فلسفية قديمة، برزت بالخصوص مع أفلاطون ضمن مقولات النضج الفلسفي، وسن التفلسف التي تكون الفلسفة بموجبها قابلة للتعلم، واستمرت عبر تاريخ الفكر الفلسفي مع كانط (Kant)،
هيجل (Hegel) ونيتشه (Nietzsche)، وصولا إلى ودولوز (Gilles Deleuze) ودريدا ((J.Derrida… وقد أثيرت في إطارها علاقة الفلسفة بتاريخها، وكذلك علاقتها بالمؤسسة كإنتاج للمعارف وللحقائق وأيضا علاقة حرية الفرد في التفكير وفي إصدار الأحكام، بالضرورة البيداغوجية والديداكتيكية. وذلك ضمن إستراتيجيتين مختلفتين في تبليغ الفلسفة: تراهن الأولى على تعلم التفلسف وتراهن الثانية على تعليم الفلسفة.
إن السؤال عن الطريقة التي تكون من خلالها الفلسفة أمرا قابلا للتدريس، يستبطن في جوفه إشكالا جوهريا يرتبط أساسا بالتساؤل حول مشروعية تدريس الفلسفة، ولا نعني بذلك الخطاب التأملي المتعالي وإنما محرك الإشكال هنا هو الفلسفة كمادة تعليمية كباقي المواد. لذا فإن الإشكال الذي يعترضنا هنا هو: إلى أي حد يكون تدريس الفلسفة من خلال محددات بيداغوجية وديداكتيكية أمرا ممكنا خصوصا مع خصوصية الخطاب الفلسفي؟
محاولة الإجابة عن هذا السؤال، تقتضي منا بحث الإمكانات المتعددة التي تجعل الفلسفة مادة دراسية شأنها في ذلك شأن باقي المواد. إلا أن المفارقة الأساسية هنا هو أن الفلسفة تختلف مضمونا ومنهجا عن باقي المواد، ولعل أكبر دليل على ذلك هو التمايز الحاصل بين مفهومي الفلسفة والعلم. فالمواد ذات الطابع العلمي كالرياضيات والفيزياء مثلا لا تطرح إشكال على مستوى التدريس، ذلك لأنها تتعامل مع معادلات ثابتة تنطلق من مبادئ صورية مسلم بها، حيث تكون هي المنطلق للبرهان دون الحاجة إلى البرهان عليها (وفي هذا تكمن الوظيفة والتساؤلية للفلسفة حول العلم). هذا بالإضافة إلى وضوح المناهج و عدم الحاجة إلى طرح سؤال الأصل أو التاريخ. على خلاف الفلسفة التي تتخذ من بحث الأصل وموضوعات العالم مجالا لها. إن الإختلاف واضح هنا حيث يكون مجال العلم مجالا محددا، إذ يمكننا التمييز بين موضوع الرياضيات وموضوع البيولوجيا مثلا، وهو ما يشكل الإستحالة بالنسبة للفلسفة باعتبارها أساسا هي موضوع اللاموضوع أي أن موضوع الفلسفة هو عبارة عن قضية كلية (تشمل كل المعارف)، مما يجعلها خطابا تأمليا تجريديا، وهنا يطرح إشكال تدريس الفلسفة كمادة تعليمية، بمعنى كيف يمكن أن ندرس شيئا غير قابل للتحديد؟ أي بأي معنى يمكن أن نحصر الفلسفة باعتبارها موضوعا للكل داخل بضع صفحات في المقرر الدراسي وبضع ساعات؟
إذا كان تدريس الفلسفة من منظور علمي يقوم على الثبات والتحديد أمرا غير ممكن، فهذا معناه قضية أساسية وهو أن تدريس الفلسفة لا يمكن أن يتم من داخل الديداكتيك العام الذي تكون فيه الفلسفة نسخة لباقي المواد. وإذا كان هذا الأمر يعني من شيء فإنه يعني ضرورة الإنتقال وتأسيس تصور فلسفي لتدريس الفلسفة أي تأسيس ديداكتيك محايث للفلسفة، فإلى أي حد يكون هذا الأمر ممكنا؟
إن مجرد الحديث عن إمكان التأسيس الديداكتيكي للفلسفة من داخل الفلسفة نفسها، يعني بالضرورة الحديث عن تصورين لهذا التأسيس: التأسيس انطلاقا من تاريخ الفلسفة والتأسيس انطلاقا من خصائص الفلسفة (التفلسف). فإلى أي حد يتخذ الدرس الفلسفي مشروعية تدريسه انطلاقا من هاذين التأسيسين؟
لقد كثر الحديث حول مسألة تدريس الفلسفة خارج تاريخها أي من خلال خصائصها، أو داخل تاريخها، ما أنتجت مجموعة من التصورات.يحدثنا إمانويل كانط (Kant.E) عن لا إمكانية تعلم الفلسفة (وهي الفكرة التي نجد أثرها عند جاك دريدا((J.Derrida) بل إمكانية تعلم التفلسف فقط، بينما يحدثنا هيجل (Hegel) بأن الفلسفة تستمد أصولها من تاريخ الفلسفة، والعكس بالعكس، الفلسفة وتاريخ الفلسفة كل منهما مرآة للآخر. ودراسة هذا التاريخ هي دراسة الفلسفة ذاتها[1] . بهذا القول يعكس هيجل (Hegel) تصوره حول تدريس الفلسفة، الذي لن يستقيم إلا بانطلاقه من تاريخ الفلسفة، الذي هو عبارة عن مجموعة من التصورات والأفكار التي تأسس على اختلافها وتناقضها المعنى الكلي الذي يحكم منطق تطور الفلسفة كفكرة شاملة، كيف لا، والفلسفة هي التركيب في دائرة الروح المطلق. فكيف يمكن تدريس هذا التاريخ الغني والمتضارب والمتشعب القضايا والإتجاهات؟؟
إذا كان للفلسفة إشكال تقليدي يصطدم به كل دارس للفلسفة وهو إشكالها بتعريفها، فإن هذا الإشكال يلزم عنه منطقيا إشكال آخر، وهو هل يمكن الحديث عن الفلسفة دون الإحالة الدائمة لتاريخها وبمعنى آخر أليست الفلسفة في عمقها تصور تاريخي لنمط إنتاج الفكر والخطاب. يبدوا أن هذا الإشكال يجد ما يبرره خصوصا وأن التصورات الفلسفة الحديثة منها أو المعاصرة أو حتى اليونانية هي تفكير برؤية جديدة في إشكالات فلسفية قديمة، أي أن الإشكال والمفهوم هنا معطيان تاريخيان ثابتان في حين أن المتغير هو طريقة تناولهما، لكن إذا كانت الفلسفة ذات طبيعة تلازمية مع تاريخها حيث تغدوا عرضا لمذاهب وتصورات فلسفية، فماذا عن قيمة الفلسفة وخصائصها النقدية والإستشكالية والمفهومية إذا اختزلناها في عرض تاريخي للأنساق؟ ألا يجعلها هذا على طرف المماثلة مع مادة التاريخ مثلا؟
إن التسليم بتلازم العلاقة بين الفلسفة وتاريخها إنما هو في الحقيقة سلب لمعطى التاريخ وإقرار بماهية الخطاب الفلسفي، فالإنتقال مثلا من الفلسفة المدرسية إلى الفلسفة الحديثة لم يكن انتقالا تاريخيا بل هو في العمق والجوهر تفعيل لآليات السؤال والنقد والشك الذي طبع عصر النهضة، بمعنى أن أساس الخطاب الفلسفي هو آلياته، حيث يكون التاريخ توثيقا أو معطى لاحق لكيفية تغير بنية الخطاب الفلسفي. فكيف إذا أسهمت الفلسفة من خلال خصائصها النقدية مثلا في تطور الخطاب الفلسفي، وإلى أي حد يمكن تأسيس تصور نظري لتدريس الفلسفة بالإستناد غلى هذه المعطيات؟
1) كانط(Kant) وتدريس الفلسفة.
يعد كانط (1724-1804) واحدا من أبرز فلاسفة العصر الحديث، بل وأكثر من ذلك إضافة نوعية لتاريخ البشرية، نظرا للصبغة الحداثية التي يكتسيها فكره وعمله على نشر التحرر بالفعل، لإخراج الإنسان من حالة الوصاية إلى حالة الإعتماد على الذات.
وقد كان مشروع كانط (Kant) الأساسي هو البحث في الإنسان، منظورا له من داخل نزعة متعالية تعاكس كل قيم الهبوط والتدني التي تجعل الإنسان خارج طبيعة الحقيقة.
فلا يمكن حسب كانط (Kant) أن تنتشر قيم الأنوار والعقلانية والتقدم والحرية وحقوق الإنسان، إلا باعتماد التثقيف الذي يعني تربية الإنسان على الإستعمال المشروع والعمومي للعقل لكي لا تذهب مواهبه عبثا. لقد كانت الغاية دائما النظر إلى الإنسان من زاوية فلسفية تنمي فيه ملكات المعرفة والتصرف والحكم والنقد، الذي يعني تمحيص كل ما يوجد من أفكار لتنقيتها من الشوائب.
لعل كانط (Kant) قصد بقوله نحن “لا نتعلم الفلسفة بل نتعلم كيف نتفلسف” أن نستعمل النقد كآلية فلسفية لجعل كل ما يكون العالم يخضع لمحك النقد، فهذا المطلب هو منهجي بامتياز، إلا أنه لا يأتينا من الخارج بل من صلب منطق الذات الذي يهدف إلى نزع الطابع الغرائبي والخرافي على العالم، أو إن صح التعبير فالتربية عند كانط (Kant) هي نقد يحرر الإنسان من كل ما هو ميتافيزيقي وخرافي.
إن غاية التربية لا تتمثل فقط في تدريس كيفية التفلسف بله في تأسيس الفكر الإنساني على تقعيد أنطولوجي جديد للتقدم، ينطلق من معرفة محتويات العقل وتعيين حدوده.
إن التربية بهذا المعنى هي بيداغوجيا النقد، الذي بموجبه لا نتعلم تاريخ أنماط التفكير، بل نتعلم الإشتغال على الآليات التي نتجت عنها أنماط التفكير الإنسانية، وهذا ما يظهر في قولة كانط (Kant) المشهورة حول تعلم التفلسف، إذ ليس المغزى تفعيل درس فلسفي يتمحور حول تاريخ الفلسفة كإيديولوجيا وأنساق ومذاهب، لكن العكس، يجب على الدرس الفلسفي أن يبحث في إمكانيات التحرر عن طريق الإستعمال النقدي للعقل.
فقولة كانط (Kant) بأهمية بمكان، حيث اهتم بها العديد من الفلاسفة بعد كانط (Kant) تأويلا ونقدا، لقد ناقشها هيجل (Hegel) وأولها جاك دريدا((J.Derrida وليوتار (Jean-François Lyotard) ووضحها فيلونينكو (Alexis Philonenko)، فعبقرية كانط (Kant) بالابتعاد عن تاريخ الفلسفة هي من ألهمت هؤلاء في رجوعهم للخطابات المؤسسة للتربية من داخل الفلسفة، لأنهم على الأقل استوعبوا خطورة الاستخدام السيئ لتاريخ الفلسفة داخل الدرس الفلسفي، باستثناء هيجل (Hegel) الذي أعطى تأويلا خاصا به من خلال كتابته تاريخا للعقل، إذ لا محال سنجد أنفسنا ندرس الفلسفة انطلاقا من تاريخها، لكن نحن لا نشك في الاستخدام العقلاني للتاريخ في الدرس الفلسفي، وهو نفس الأمر الذي حاول ليوتار (Lyotard) الاشتغال عليه من خلال الدرس والرجوع إلى مجراه، إذ نعني بذلك أن كل تعليم للفلسفة يبتغي ضرورة العودة لطفولة الفكر الفلسفي والكشف عن مسار نموه، إذ بذلك نقوم بمحاولة التنقيب عن آليات وضوابط اشتغل بها العقل الفلسفي لتأسيس خطابه كالسؤال والمفهوم والحجاج والأطروحات…
في حين حاول دريدا ((J.Derrida تأويل قولة كانط (Kant) من خلال إشكالية ضرورة المؤسسة وحرية التفلسف.
فالتربية على التفلسف عند كانط (Kant)، إنما هي تمرين لمواهب العقل لأجل تطبيق قيمه ومبادئه على كل ما هو مسيج بالطابوهات والتحفظات، فالعقل المربى فلسفيا هو الذي يخلق الأزمة والإنتكاسة والمفارقة.
لقد كانت غاية المدرسة الكانطية في التربية، إعطاء الشرعية المؤسساتية للتفلسف والفلسفة، بحيث لا يمكن للإنسان من داخل التصور الكانطي أن يكون كذلك حقا إلا إذا مارس التفلسف المشرعن والذي لا يعني ضرورة المؤسسة ضد حرية التفلسف بل للإستعمال الإرادي والحر لآليات العقل من أجل إنتاج الخطاب العمومي من هنا فالتربية عند كانط (Kant) ليست حبيسة المؤسسة فقط لأنها لو كانت كذلك لاضطرت للتوافق مع الجهاز الإديولوجي الذي تنتجه المؤسسة، لكن التربية عند كانط (Kant) هي العمود الفقري للفضاء العمومي الإنساني، بحث يتحول الإنسان إلى كائن سياسي ممارس للنقد ومطبقا لمبادئ العقل في الواقع، فكل هذه العمليات لا محالة إلا ونتج عنها خطاب الأنوار، وهذا الأخير يحدث التقدم في التاريخ.
يتبين إذن أن التربية عند كانط (Kant) تتغيى التقدم وإزالة اللبس الإجتماعي وسحب البساط عن الخرافة، التربية لها دور لا محالة سياسي بامتياز عند كانط (Kant)، وأكبر معبر عن هذه الفكرة هو الرضى التام لكانط عن أحداث الثورة الفرنسية التي اعتبرها أكبر تجسيد لأفكاره الأنوارية نظرا لاقتناعه بأن معاصريه في ألمانيا لم يفهموا مشروعه بعد.
وكما دافع كانط (Kant) عن النقد، فقد كان بزوغ فكره الفلسفي في جميع مشاريعه ينطلق من السؤال، لقد تساءل في نقل العقل الخالص لماذا تقدم العلم وتأخرت الميتافيزيقا، بحيث أضمر النية في تأسيس نظرية معرفة متكاملة تعبر عن النسق النيوتوني من جهة وتتيح للعقل إمكانيات التفلسف في الطبيعة أو حول معرفة الطبيعة، فعملة فالتفلسف المعرفي نتج عنه تحرير العق من الميتافيزيقا وإيمانه بالعلم فقط، أي الربط بين التجربة والفهم لإنتاج الخطاب، إذ لا محال إذ أردنا أن نعرف أن نرجع فقط إلى التجربة كمادة أولية للمعرفة، والعقل كمنظم لهذه المعرفة، يقول كانط (Kant) بهذا الصدد: “تبدأ كل معرفتنا مع التجربة، ولا ريب في ذلك البتة، لأن قدرتنا المعرفية لن تستيقظ إلى العمل إن لم يتم ذلك من خلال موضوعات تصدم حواسنا، فتسبب من جهة حدوث التصورات تلقائيا، وتحرك من جهة أخرى، نشاط الفهم لمقارنتها، وربطها وفصلها، وبالتالي إلى تحويل خام الإنطباعات الحسية على معرفة بالموضوعات… إذن، لا تتقدم أي معرفة عندنا زمنيا على التجربة، بل معها تبدأ جميعا”[2]
إن مفاد هذا القول هو تبيين الإمكانيات التي يخوض فيها الدرس الفلسفي ضمن نظرية المعرفة وهو مسار تعلمات يقطعها العقل، في بناء قدراته في كيفية بناء المدركات، سواء كانت حسية أو عقلية مع احترام حدود العالم.
إذن الدرس الفلسفي لن يخوض في الميتافيزيقا لأن العقل في تربيته السليمة لا يعرف إلا ما يتوصل إليه عن طريق الحواس. فالميتافيزيقا “وهي المعرفة العقلية الإعتبارية المعزولة تماما والمترفعة عن دروس التجارب استنادا إلى مجرد أفاهيم (لا إلى تطبيق الأفاهيم على الحدس كما في الرياضة) والمعرفة التي على العقل… فلم يحالفها الحظ حتى الآن في انتهاج درب العلم الآمنة”[3]
أما المشروع الأخلاقي وهو المتضمن لخطابات عديدة نتج عنها جواب كانط (Kant) على سؤال ما الأنوار ورسالته في السلام العالمي الدائم قد أسس للتربية على الفعل أي تأطير الوجود الفعل الإنساني بسؤال ماذا يمكنني أن أفعل؟
لقد تميزت الأخلاق الكانطية بالطابع المعياري للواجب والذي يعني إشكال أساسي وهو: كيف تكون التربية على القيم الكونية القبلية ممكنة؟ فهذا التوجه الذي بحث عن نوره في فلسفة الذات أحدث نقلة نوعية في الدرس الفلسفي المتعلق بالأخلاق إذ صارت أخلاق الواجب مطلبا أساسيا في جميع البرامج التعليمية، وهذا راجع للصبغة المنطقية التي تكتنف فكر كانط (Kant) باعتباره مسارا حقوقيا وتحريريا من كل سلطات القهر والإلزام في المجتمع.
إن أهم ما يميز الفلسفة الكانطية إذن النقد والسؤال، أو إن صح التعبير السؤال النقدي باعتباره المبدأ الأساس لتربية الإنسان على التفلسف، الأمر الذي يجعلنا من داخل الدرس الفلسفي لا نغوص في الذاكرة والتاريخ، بل نستعمل العقل وفقا لتحليلاته وخطاطاته التي تنتج المعنى التعليمي.
نخلص إذا إلى أن كانط (Kant) يضع حدا فاصلا في تدريس الفلسفة بين تاريخ الفلسفة وإمكان التفلسف وهذا يعنى قضية أساسية هي أن الإنطلاق من تاريخ الفلسفة لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يعيننا في إنتاج خطاب فلسفي يقوم على سيمات النقد والسؤال… فتاريخ الفلسفة لا يعلمنا الفلسفة في معناه الحق(التفلسف) بل يعطينا فقط ذاكرة للفلسفة هذا في حين أن منطلق الخطاب الفلسفي هو العقل لا الذاكرة، والقول بالعقل معناه إبعاد كل معرفة جاهزة (تاريخية) واعتماد صوت العقل في صورة النقد والسؤال، فهما أساس إنتاج الخطاب الفلسفي لذا فإن الضرورة تصبح هي كيف نتعلم العقل أو كيف تكون لنا القدرة على النقد والسؤال وبالتالي التفلسف. ولعل إنتقال كانط (Kant) من تاريخ الفلسفة إلى آليات التفلسف له ما يبرره خصوصا أن الأول يحيلنا على قراءة إيديولوجية نتبنى من خلالها هذا التصور أو ذاك على الرغم من الإختلاف القائم بينهما,إن هذا التحول هو إعلان لفاعلية العقل في التفلسف,بعدما كان مفعولا به في تاريخ الأنساق الفلسفية.
2) جاك دريدا(J.Derrida) وإشكال تدريس ما لا يمكن تدريسه.
يرى جاك دريدا ((J.Derrida من جهته “أن مقولة كانط (Kant) تسمح لنا بوضع تمييز داخل الفلسفة ذاتها بين التاريخانية المدرسية والعقلانية، إذ بإمكان التلاميذ أن يتعلموا ويستضهروا مضامين، هي عبارة عن أنساق فلسفية ، وفي هذه الحالة يمكن لأي كان أن يعتبر تلميذا بغض النظر عن سنه، فبإمكاننا كما يقول كانط (Kant) أن نحافظ مدى الحياة على علاقة تاريخية –أي مدرسية- مع الفلسفة التي لن تصبح سوى تاريخا لعرض المواقف الفلسفية”[4].
ويشير دريدا((J.Derrida إلى أن بإمكاننا الوقوف عند لحظتين ضمن هاته المقولة الكانطية: حيث تتمثل اللحظة الأولى، في أننا لا يمكن تعلم الفلسفة بل يمكننا تعلم التفلسف فقط، وتتمثل اللحظة الثانية، في أننا لا يمكننا سوى تعلم التفلسف، سوى التعلم، لأن الفلسفة ذاتها في متناولنا، ونحن نحاول الإقتراب منها، لكن ليس باستطاعتنا تملكها.
وإذا كانت وظيفة الفلسفة انتقادية أساسا، ألا يعتبر حصرها في مكان ما، متناقضا مع جوهرها القائم عبى التفكير بحرية؟ ألا يستوجب النقد الفلسفي نوعا من الترحال ومن الإستقلال عن كل مكان مؤسساتي، يتضمن في حد ذاته خطر سجن الفكر النقدي ووضعه تحت الإقامة المحروسة ألا يتعلق الأمر في هطه العلاقة بين الفلسفة والمؤسسة بمسافة وفسحة اختلاف؟ وهل تشغل الفلسفة حيزا محددا، أم أن حيزها غير موجود، مكان بدون مكان، يستمد مفارقته من مفارقة الفلسفة نفسها؟
هناك مفهوم أساسي عند كانط (Kant)، يسمح بالحديث عن بيداغوجيا للتفلسف عنده، هو مفهوم الحكم المعقلن، بالتالي ترفض هذه البيداغوجيا أي تدريس للفلسفة المذهبية والنسقية، وتعطي الحق للفردانية ولحرية التفكير مع أخذها بعين الإعتبار ضرورة الفكر الكوني الشمولي. ذلك أن هذه البيداغوجيا مؤسسة على فكرة التواصل الكوني وعلى إرادة التفكير الذاتي الحر في نفس الوقت. إذا انطلقنا من هذا التصور، فإن تدريس الفلسفية يجب أن يركز على تعليم التفكير بهدف تعويد العقل على الممارسة النقدية، كما يجب على الفلسفة أن تنفتح على المؤسسة المدرسية، شريطة الا تحاصر هذه الأخيرة ممارسة العقل النقدي.
اعتبر دريدا ((J.Derrida بأن العلاقة التي حددها كانط (Kant) بين الفلسفة والتفلسف، بين العقل النقدي و والمؤسسة وبين الكوني والفردي، هي في أساسها علاقة اختلافية. فهناك بين أطراف هذه العلاقة تجاذب وتباعد ، اقتراب وانسحاب، أي فاصل وفسحة ومسافة، وهو ما يسمح بقراءتها كاختلاف انطولوجي. إن وضع الفلسفة يتميز بعدم الإستقرار في مكان محدد، وحضورها داخل الفضاء المدرسي والجامعي هو حضور منسحب، كما أن وحدتها لا يمكن أن تتحقق كمحتوى، بل تظل كوحدة شكلية . وهذه المسافة بين المضمون والشكل هي التي تجعل من حضور الفلسفة كنص وككيان قائم بذاته، حضورا مستحيلا لأنه يتضمن غيابها وانسحابها أيضا، فليس هناك نص حاضر.
ومن هنا تكون الإشكالية العريضة التي حاول جاك دريدا ((J.Derrida الإجابة عنها هي: كيف يمكن تدريس ما لا يمكن تدريسه؟
إن الأمر يتعلق حسب دريدا ((J.Derrida بوضعية الفلسفة المتميزة، هي أنه يمكن تدريس الفلسفة بدون تعلمها، أو بعبارة أخرى استنادا إلى قول كانط (Kant)، أن الأستاذ لا يعلم الانساق الفلسفية ومضامينها، ولكنه يعلم كيفية التفلسف فقط المبني على التأمل الحر والنقدي للقضايا المطروحة. ولهذا أعطى جاك دريدا ((J.Derrida سبع وصايا[5] كإجابة على الإشكالية المتعلقة “بتدريس ما لا يمكن تدريسه” والتي هي نفسها استمرار لمقولة كانط (Kant) ” إننا لا يمكن أن تعلم الفلسفة وكل ما يمكنا تعلمه هو التفلسف”:
الوصية الأولى: الإحتجاج ضد خضوع ما هو فلسفي (في أسئلته وبرامجه ومادته) لأية غاية خارجية (النافع، المربح، الفعال…) ومن جهة أخرى لا يجب التخلي عن المهمة النقدية، أي التقييمية والتراتبية للفلسفة…
الوصية الثانية: الإحتجاج ضد سجن الفلسفة داخل قسم أو مقرر، والمطالبة بالوحدة الخاصة والمتميزة للفلسفة…
الوصية الثالثة: المطالبة بعدم فصل البحث أو المساءلة الفلسفيين عن التعليم…
الوصية الرابعة: المطالبة بمؤسسات في مستوى هذه المادة المعرفية، المستحيلة والضرورية واللازمة وغير النافعة. لكن الفلسفة تتجاوز مؤسساتها، ويجب عليه أن تظل حرة كل لحظة وألا تطيع سوى قول الحقيقة وقوة السؤال أو الفكر.
الوصية الخامسة: المطالبة بتوفير مدرس للمادة، لا يتميز بالتبعية رغم أن تكوينه وصرف أجرته يتم من طرف آخرين…
الوصية السادسة: يتطلب كل من المادة الفلسفية ونقل المعرفة والغنى المفرط للمحتويات، وقتا مناسبا ومدة زمنية متسلسلة، لكن تتطلب وحدة المادة وهندستها، نوعا من التجميع المنظم لهذا الوقت.
الوصية السابعة: يجب أن يمنح للتلاميذ، الطلبة والمدرسون أيضا إمكانية، أو لنقل شروط الفلسفة، فمن واجب المدرس أن يساعد التلميذ ويكونه، لكن هذا المدرس الذي سبق أن خضع بدوره للتكوين والمساعدة والتعليم يظل آخرا بالنسبة للتلميذ، لكن لا نريد، من جهة أخرى التخلي بأي ثمن عن التقليد الفلسفي المتميز بالإستقلالية والإعتماد على الذات.
إن هذه الوصايا الدريدية ليست إجابات قطعية عن الإشكالية المذكورة، كما أنها ليس حتى إجابات عليها، إنها تعبير عن المفارقة، المفارقة التي تميز هذه المادة التعليمية، مادة الفلسفة، في عدد من المستويات (المؤسساتي، الزمني، المعرفي، التعليمي…).
3) هيجل (Hegel) والمشروعية التاريخية لتدريس الفلسفة.
ينبع تصور هيجل (Hegel) للدرس الفلسفي وكيفية تدريسه وبنائه من تصوره للفلسفة ذاتها، حيث أن فلسفة هيجل (Hegel) لم تكن لتكون خارج التقليد الفلسفي الذي ينهل من تاريخ الفلسفة إذ تعتبر نتيجة لإشكالات فلسفية قديمة. فهي لم تنشأ من فراغ بل قامت على أنقاض إشكالات الفلسفات السابقة، ذلك أن كل مذهب فلسفي جديد هو تفكير برؤية جديدة في قضايا قديمة. وفي هذا نجد هيجل (Hegel) ينافح وبشدة عن كل عزل للفلسفة عن تاريخها. حيث يرى أن هذا الفصل ناتج بالأساس عن سوء قراءة للفلسفة بالتاريخ، والتي تصبح فيها الفلسفة فاقدة لمعناها الكلي حيث تتضايف فيها المعطيات التاريخية والدياليكتيكية والمنطقية. وعليه “فإن كان مؤرخوا الفلسفة يقدمون المذاهب التي يعرضونها كمجرد تعاقب للآراء المتباينة، بحث كان يروق لهم أن يقابلوا بعضها مع البعض الآخر بصورة جذرية مما يؤدي إلى تصويغ النتائج الإرتيابية”[6]، فإننا نجد هيجل (Hegel) يرفض هذا الموقف في كتابه محاضرات في تاريخ الفلسفة. “إن الفكرة الموجهة التي قادته في تطوافه عبر صالة أبطال الفكر هي أن السيستيمات التي عرضها يجب أن تعتبر كمراحل متعاقبة لتطور واحد بعينه: إنه تطور الفكر البشري الذي يتقدم عبر العصور تقدما دياليكتيكيا”[7].
إن هذا القول هو إقرار من حيث المبدأ بأن مذهب كانط (Kant) الفلسفي مشروط تاريخيا، ولا يمكن أن نفهمه جيدا ما لم نقابله مع المذاهب التي سبقته، الشيء الذي تكون فيه الفلسفة نتاجا تاريخيا، ولا نعني بهذا النتاج ذلك التعاقب الزمني بل غنه ذلك التطور الذي يتم بموجب الضرورة المنطقية للعقل في تعييناته المتعددة، التي يتجلى من خلالها سواء في المنطق أو الطبيعة أو الروح، فالخطأ في التصورات التي سبقت هيجل (Hegel) هو أن هذه الاخيرة تصورت الفلسفة كمجرد تعاقب فارغ من كل غائية في حين أن الاساس المولد لهذا التطور هو المعطى الدياليكتيكي. حيث يكون تناقض التصورات وتضاربها هي مكونات للعلاقة الجدلية التي تتقدم عبر عنصر السلب أو التناقض.
لا يمكن بأي معنى من المعاني فصل الفلسفة عن تاريخها ذلك أن الفصل هو افتقار لإدراك المعنى الكلي للفلسفة، لذلك فلا عجب أن نجد هيجل (Hegel) يتحدث عن خطر التجزيء في التصورات ما لم نفهم ذلك في الحركية التاريخية التي تمليها الضرورية العقلية، وعلى هذا النحو نستطيع القول بأن تصور كانط (Kant)عزل التريخ عن الفلسفة في مقام أول وعزل الفلسفة عن الضرورة المنطقية للعقل الكلي في مقام ثاني. فلا عجب إذن أن نجد هيجل (Hegel) (Hegel) يوجه نقدا إلى كانط (Kant) قائلا بأنه “ارتكب خطأ فادحاً عندما أكد أن المرء لا يتعلم الفلسفة بل التفلسف, كما كان المرء يتعلم النجارة لا كيف يصنع مائدة او كرسي…”[8]
لنتأمل قليلا قول هيجل (Hegel):” إن البراعم تختفي إذا تفتح الزهر وإنه ليحق لنا القول بأن الزهرة تدحض البرعوم كذلك الثمرة إذا ظهرت كأنها صورة زائفة من صور وجود النبات تحل هي محلها كأنها حقيقته. فكل شكل من هذه الأشكال لا يتميز فقط من الأخرى بل يصدها صدا لأنها على تنافر فيما بينها. ومع هذا فطبيعتها السائلة تجعل منها أيضا لحظات من وحدة عضوية يزول فيها التنافر، ولا يزول وحسب بل إن كلا منها لتصبح لها ضرورة كضرورة الأخرى. وهذه الضرورة المتساوية هي حياة المجموع”[9] يعطي هيجل (Hegel) بقوله هذا تصورا آخر للفسفة غير الذي ذهب إليه كانط (Kant)، وبالتالي تصور آخر لتدريس الفلسفة غير الذي ذهب إليه وتبناه كانط (Kant). وهو أن كل فلسفة حديثة في الزمن متضمنة للفلسفات التي سبقتها، ومن الضروري تدريس هذه الصيرورة التقدمية للفلسفة.
إذن يؤكد هيجل (Hegel) على مسألة مهمة بخصوص تدريس الفلسفة، ويرى أنه لا يمكن تدريس الفلسفة إلا باستحضار تاريخها، لأن الفلسفة تستمد أصولها من تاريخ الفلسفة، والعكس بالعكس، الفلسفة وتاريخ الفلسفة كل منهما مرآة للآخر. ودراسة هذا التاريخ هي دراسة الفلسفة ذاتها.
نفس الشيء نجده عند فيلسوف أخر، إنه كارل ياسبرز، الذي يرى أنه هناك ارتباطا وثيقا بين الفلسفة وتاريخيها. يقول ياسبرز: ترتبط الفلسفة بتاريخها بعلاقات متعددة ، فقد يكون التاريخ سلسلة من الأخطاء التي تم تجاوزها، أو يكون هو التقدم الذي تحقق بتحصيل المعارف الدقيقة وتجميعها، بحيث تمثل هذه اللحظة الحاضرة في هذا التقدم أقصى ذروة بلغها.”[10] ويميز بيرغسون بين تاريخ العلوم المتخصصة وتاريخ الفلسفة، فإذا كان تاريخ تلك العلوم (علم الكيمياء أو علم الرياضيات مثلا) لا يعد جزءا من دراسة تلك العلوم، فتاريخ الفلسفة جزء أساسي من من دراسة تلك العلوم.
4) الدرس الفلسفي عند دومونزي (Anatol de Monzie)[11].
سنبدأ هنا مما انتهى به أنطوال ديمونزي (Anatol de Monzie) قائلا:
“هذا هو التصور الذي لدينا عن التعليم الفلسفي. تعليم يسعى إلى تطوير ملكات التأمل عند الشباب، وجعلهم، بالضبط، في حالة استعداد للحكم لاحقا، اعتمادا على أنفسهم، بدون لامبالاة وأيضا بدون دغمائية. أن نمنحهم حول مجموع مشاكل الفكر والفعل، آراء تسمح لهم بالإندماج الفعلي في نجتمع زمنهم وفي الإنسانية. هذه، بشكل عميق، الوظيفة الخاصة بأستاذ الفلسفة. وليس هناك ما هو أجمل من هذا، ول يمكنه أن يعطي فكرة أوسع لهذا التعليم. لكن، ومن أجل أداء هذه الوظيفة، عليه أن يعرف أسلوب تكييف هذا الطموح الكبير مع الإحساس بتواضع الوسائل التي يتوفر عليها. وعليه أن يضع نفسه رهن إشارة العقول الجديدة، الواجب عليه جعلها ناضجة، وأن يكون محبوبا ليفهمهم، وأيضا ليخدمهم بشكل جيد، وأخيرا، عليه كسب ثقتهم بواسطة هذا الإخلاص، وهذه التلقائية التي تؤثر بشكل يسهل على الشباب.”
إن الوظيفة من هذا التقديم الذي جعله دومونزي (Anatol de Monzie) خلاصة قوله، هي إعطاء رؤية أولية عن هدفه، ورؤيته للفلسفة ولتدريسها ولمدرسها ولمتلقيها. لقد أوضح لنا أن دور الفلسفة في حياة الشباب، من تعليم للفكر التأملي والنقدي، ومن قدرة على إصدار الأحكام ومحاربة الدغمائية. أليست هذه الأهداف حاضرة في المنهاج المغربي؟ بلا، إنها حاضرة وبشكل جلي، حاضرة في الكفايات المستهدفة.
يقسم دومونزي (de Monzie) توجيهاته إلى ثلاثة أقسام مذللة بتقديم عام، قسم يعالج “روح التعليم الثانوي” وقسم ثان يعالج مسألة المنهج، وقسم ثالث خصصه ل”مادة التعليم”.
يأبى دومونزي (de Monzie) قي القسم الأول إلا أن يبدأ بكلمة حرية في مستهل توجيهاته. ويضع هذه الكلمة في مفارقة، مفارقة حرية الأستاذ وخصوصية التلميذ، حيث كان الأستاذ منذ القديم يتمتع بكامل حريته في الرأي، لكنه أصبح في مواجهة تحفظات و بيداغوجيا تخص تدريس الفلسفة. حيث أصبح من اللازم عليه أن يأخذ بعين الإعتبار خصوصية المتعلمين (العقلية ) وقلة تجربتهم وقابليتهم للإنجذاب إلى أفكار متطرفة، واحترام ميولاتهم. لكن يجب على الأستاذ في المقابل توجيههم، وتقديم المعارف إليهم، ومنحهم حرية الفعل والتأمل.
كذلك يجب على الأستاذ أن يأخذ بعين الإعتبار أن مادة الفلسفة تسبب دهشة لدى المتعلمين، عند اللقاء الأول، فلا يجب أن يجعلها تتحول إلى إحباط ولكن إلى دهشة معرفة المجهول. فالفلسفة تتقاطع مع مواد سبق للمتعلمين رؤيتها( علمية أو أدبية) أو مع تجاربهم النفسية والأخلاقية. هنا يأتي الدور البيداغوجي للأستاذ، في التعامل مع ذكاء التلاميذ ودعمه، وفي الوقت نفسه عدم تجاهل النضج البسيط لهم، لأن لهم يسر وطواعية في الإقتناع، لذا وجب على الأستاذ أن يحاول قدر الإمكان أن يبسط المعرفة الفلسفية (التي من مميزاتها الإفراط والتجريد) وبالتالي وجب على الأستاذ أن لا يترك الأسئلة دون توضيح خاصة التي لها معنى محسوس وعلاقات مع الواقع، واعتماد لغة مفهومة لا تقبل تأويلات مختلفة.
كذلك أكد دومونزي (de Monzie) على أهمية ربط الواقع بالأفكار وربط الأفكار بالواقع، ويرى بأنها، قاعدة بيداغوجية تفرض نفسها، يتم ربط الأفكرا بالواقع حين يقوم التلميذ بترجمة التراكيب الفلسفية إلى وقائع وأمثلة وتطبيقات، أما فيما يخص حاجة الأفكار إلى وقائع، فلجعل التعليم سهل المنال وأن يكون مفيدا للعقول الفتية. هذه الوقائع (فيزيائية أو أخلاقية) هي التي ينبغى على الأستاذ أن يجعها محور الدرس، وبالتالي تكون الأسئلة المطروحة إنتاج، وليس تقليد فلسفي، وحتى المذاهب فلا تأخذ قيمتها إلا من خلال تصنيفها للأفكار المستخلصة من الأفكار ذاتها. والإبتعاد عن تلك الإستعراضات اللامتناهية للآراء المتناقضة حول المشاكل. من أجل تأمل جاد ومحاربة العقول الصلبة، إنه علينا أن ننير العقل أن نتجنب شحن الذاكرة.
يؤكد دومونزي (de Monzie) على أن الأستاذ يجب أن لا يهمل الفرص التي يقدمها له المقرر لموضع الثقافة الفلسفية في علاقة مع المشاكل الواقعية التي تفرضها الحياة الأخلاقية والإجتماعية والاقتصادية، المرتبطة بالمحيط الذي على الشباب العيش فيه. لكن على الأستاذ أن يخلق عالما للتأمل خارج اليومي، أو بتعبير آخر لا يجب على التلميذ أن يجد نفسه داخل نقاش الحياة اليومية والمشاكل المرتبطة بها (اجتماعية واقتصادية وسياسية…) بل إن عليه أن يتعالى عن الواقع، بخلقه لقيم إيجابية كالتآزر والحماية الإجتماعية، كما أن عليه يكون ذو قدرة الإحساس المتأمل لكل مهامه المستقبلية.
يؤكد دومونزي (de Monzie) على مسألة أساسية بخصوص المنهج، وهي أن لكل أستاذ منهجه الخاص، فهو حر فيه، كما هو حر في آرائه، كما أن الأساتذة يختلفون في الطريقة التي يدرسون به، فلكل وجهة نظره وطريقته في العمل.
يتطرق بعد ذلك إلى قضية الإملاء، يقول: أما الإستثناء الوحيد المعبر عنه سابقا، والذي علينا تأكيده، هو إملاء الدرس، لكن، قد يكون مفيدا إملاء، إما درس ملخص بعد الحصة، أو مجمل مختصر يعطى قبل العرض الشفهي، يسمح للتلاميذ . بمسايرة أحسن وذلك بإدراك التصميم والتمفصلات التي يضمها الدرس. إنه المكمل الضروري للدرس الحر، والملائم لربح الوقت.” هنا يشير دومونزي (de Monzie) إلى مسألة مهمة، وهي أنه من الأفضل أن يقدم تلخيص يتضمن صورة عامة عن الدرس للتلاميذ، وذلك من أجل ربح الوقت، لكن لا يجب أن يكون الدرس إملائيا وحتى ذلك المختصر يمكن أن يستنسخ بدلا من إملائه.
بعد ذلك يتعرض للمنهج السقراطي الخالص الذي يرى أن له إيجابيات بيداغوجية، لكنه في الوقت نفسه يؤكد صعوبة استعماله لعدة أسباب نذكر من بينها:
ü يتطلب المنهج السقراطي رزانة الأستاذ وصرامة فكره ووضوحه ورشاقة روحه لاستثمار الإجابات وتجنب الإعتراضات، كما يتطلب سلطة كبيرة على التلاميذ،
ü المنهج السقراطي يفرض أن تكون الأقسام ذات أعداد قليلة نسبيا، وتضم عددا كافيا من تلاميذ أذكياء ومتحمسين وقدرين على قيادة الآخرين
ü المنهج السقراطي منهج بطيء رغم أنه مهم ليقظة الفكر، إلا أنه في ظل ضغط المقررات ينحو نحو تغيير اتجاه الأساتذة.
ü على الرغم من قيمة المنهج السقراطي النظرية، إلا أنه لا يمكن أن يكون عمليا.
بعد عرضه هذا لصعوبة اعتماد المنهج السقراطي، يؤكد على أهمية الإحتفاظ ببعض إيجابياته والتي من بينها:
ü إشراك التلاميذ في حركية الدرس اعتمادا على ما سيقدمه الأستاذ لهم من بحث في الحاضر فيصبح الدرس أكثر تنوعا وشمولية خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاكل أخلاقية أو نفسية، في حين ستكون المشاركة جد محدودة حين يتعلق الأمر بمشاكل أكثر تعقيدا أو تقنية.
ü على الأستاذ أن يتدخل من حين لآخر حتى يتبين أن تلامذته يفهمونه ويسايرون درسه، وإثارة التقاربات بين الأفكار وإعطاء الأمثلة.
ü لا ينبغي أن يكون الدرس على شكل محاضرة يكون فيها التلميذ سلبيا، وبالتالي ليؤدي الأستاذ وظيفته الحقيقية عليه أن يضع التلميذ في وضعية تفكير فعلي اتجاه ما يقدمه لهم. وسيكون الأمر أكثر متعة وفائدة حينما تستدعي تلقائيتهم الثقافية.
ü تخلق الحياة في القسم عندما يكون الأستاذ أكثر ترحيبا بالأسئلة والأجوبة لفكر مبتدئ، وعندما يستخلص الأحسن ويتجنب أي إقصاء أو إحباط عن طريق اللامبالاة.
يشير دومونزي (de Monzie) بعد ذلك إلى مسألة استعمال الكتاب المدرسي قائلا: إن استعمال الكتاب المدرسي لا يمكن في حد ذاته، أن يؤسس لطريقة مقبولة. وعندما يختبئ الأستاذ وراءه، فإنه يفقد سلطته ويتنازل عن شخصيته” وبهذا يكون دومونزي (de Monzie) قد ضرب في كل فعل يجعل الأستاذ غائبا في الدرس، إذ يجب عليه أن يستعمل الكتاب المدرسي بشكل عرضي، وليس كعكاز يتكئ عليه، يكون اللجوء إلى الكتاب المدرسي من أجل ربح الوقت أو إتمام درس حول نقطة يجهلها، لذا على الأستاذ يقوم بالتبليغ المباشر والحي للفكر بواسطة الكلام حيث يكون التواصل بين العقول. هنا لابد على التلاميذ أن يسجلوا النقاط الأساسية من الدرس، علما أنهم تدربوا على ذلك وأن الأستاذ يستعمل طريقة تسهل عليهم فهم الدرس وتحديد الأساسي من غيره، وذلك عبر الوضوح والبيان ونبرات الكلام والتنويع في الإيقاع حسب الأساسي والثانوي في الدرس. وبعد ذلك يراقب الأستاذ التلاميذ فالمراقة وظيفة بيداغوجيا جد مهمة، بفضلها يمكن للأستاذ محاربة تهاون التلاميذ.
إضافة إلى هذا كله، يركز دومونزي (de Monzie) على القراءة، ويعتبرها التكملة الضرورية للتعليم، والأستاذ مطالب بتكوين مكتبة فلسفية في فصله مطعمة بإسهامات التلاميذ، وينبغي تشجيع التضامن بين الأجيال المتعاقبة . كما عليه أن العمل على تطوير ذوق الدراسة والبحث الشخصي، وأن يوجه منهجيا القراءات. لكن يجب الأخذ في الحسبان أن حب الإكتشاف عند الشباب لن يكون دائما متجها نحو ما هو أكثر فائدة واستيعابا، وبالتالي يجب تكييف القراءات مع المواد المدرسية وربط صعوباتها مع الذكاء ودرجة تهيئ الفرد.
ولابد من استعمال الفرض في درس الفلسفة ليس في الإستظهار وإنما للتحقق من مراجعة التلاميذ ودراستهم للدرس خارج الفصل والأهم فهم الدرس واستيعابه، فالفرض الجيد هو الذي يعمل على تجديد الدرس وتتميمه، واستخراج الأفكار والخلاصات الأساسية، وعلى إثارة الأسئلة والإعتراضات وردود الأفعال الشخصية.
يعطي دومونزي (de Monzie) مكانا لعروض التلاميذ داخل الدرس، والتي يجب الإعتماد فيها على الثقة التي يكنها صديق لأصدقائه وليس فقط على جزء يسير من التجربة حتى عند المتفوقين، وهذا العرض يمكن أن يكون عرضيا حسب اختيار الأستاذ ويستحسن أن تأتي المبادرة من التلاميذ، عنذما يكون اهتمام شخصي بسؤال ما، ويريد التلميذ المساهمة بأفكاره، كما قد يشعر آخر بقيمة مؤلف ويجب أن ينقل إلى أصدقائه فائدة قراءته.
ويمكن أن تضاف بالنسبة للإمتحان بعض التمارين المصاحبة والمكملة له. كأن نضع سؤالا يصبح محور تفكير جماعي، ومحادثة، ونوع من المقابلة الشفهية، حيث يدلي كل واحد برأيه بتوجيه من الأستاذ، هذه التمارين تدخل الحياة إلى قسم الفلسفة، فالأستاذ لن يكون هو المتكلم الوحيد ولن يفرض أفكارا جاهزة بدون المساعدة الحية للمستمعين
لائحة المراجع
[2] إ. كانط، نقد العقل المحض، ترجمة وتقديم موسى وهبة، مركز الإنماء القومي، بيروت، الطبعة الأولى، 1988، ص45.
[3] إ.كانط، نقد العقل المحض، ترجمة وتقديم موسى وهبة، مركز الإنماء القومي، بيروت، الطبعة الأولى، 1988،ص33.
[4] عز الدين الخطابي ، مسارات الدرس الفلسفي في المغرب ، منشورات عالم التربية، الطبعة الأولى 2002، ص 39.
نقلا عن Derrida (J) , du droit à la philosophie, Galilée 1990, p p 517.521
.
[10]كارل ياسبرز: تاريخ الفلسفة بنظرة عالمية، ترجمة وتقديم عبد الغفار مكاوي، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1994، ص43.
ترجمة وتقديم عبد الغاني التازي، مجلة فكر ونقد، العدد 48، 2002، ص ص 118_128.
موقع فيلوكلوب