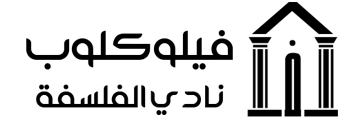محمد الورداشي يكتب “اللغةُ العربيةُ بينَ الثقافةِ والتربيةِ”
محمد الورداشي كاتب وباحث مغربي له مجموعتان قصصيتان: “حينما يتنكر الوطن لبنيه” (المغرب)، “القرية المهجورة ” (مصر). ومجموعة من المقالات نشرت في جرائد ورقية وإلكترونية داخل المغرب وخارجه.
لم تكنِ اللغةُ “أصواتا يعبر بها كل قوم عن أغراضهم” فحسب، كما ذهب ابن جني في حدها، وإنما كانت ولا تزال الوعاءَ الذي تختزنُ فيه الأممُ والشعوبُ ثقافتَهَا وآمالَهَا وتطلعاتِها، فضلا عن رؤيتها للعالم. كما أنهُ، أي الوعاء، يضمُّ حروبَها ومعاركَها، وانتصاراتِها وهزائمَهَا. هذا إلى جانبِ فكرها وحكمها؛ فاللغةُ، بهذا المعنى، وسيلةٌ للتواصلِ وللتعبيرِ عنِ الأغراضِ المتعددةِ، بيد أنها، أيضا، حاملٌ للهويةِ الثقافيةِ والحضاريةِ التي يُنتجها كلُّ شعبٍ منَ الشعوبِ أو أمّةٍ منَ الأممِ. لهذا نجدُ أنَّ الأممَ والشّعوبَ لا تألو جهدا في حماية لغتها وتطويرِهَا وتثويرها وتجديدهَا، فضلا عن تطويعها حتى تتمشى والتطوراتِ الاجتماعيةَ والسياسيةَ والعلميةَ، ومردُّ هذا الاهتمامِ إلى كونِها رمزا لوجودها تاريخيا وفكريا وحضاريا. ومن هنا، فإن “قوة الشعوب تُقاس بدرجة وفائها للغتها” (1) وثقافتها، وهذا ما وجه الحروبَ بينَ الأممِ والشعوبِ وجهةً ثقافيةً حضاريةً بالدرجة الأولى. على أنّ تدميرَ لغةِ شعبٍ ما هو نسفٌ لهويته وثقافته. وهذا ما دفعَنا في هذا المقالِ إلى تخصيص حديثنا، وبشكل مركز، على اللغةِ العربيةِ في المغربِ، وهذا ما لا ندعي الإتيانَ بجديدٍ فيه ما دامتِ القضيةُ قدْ طُرحتْ منذُ أنْ تعرضَ المغربُ للاستعمارِ السياسيِّ والعسكريِّ، وإنما سنحاولُ أنْ نبرزَ دورَ بعضِ الأفلامِ المغربيةِ التي أُنتجت في السنواتِ القريبةِ في تشويهِ اللغةِ العربية باعتبارها لغةً رسميةً أولى للدولةِ، وكذا تقزيمِ الأبعادِ المتقاطعةِ معها.
بعدما توصلَ المستعمرُ الفرنسيُّ إلى إخفاقِ الاستعمارِ السياسيِّ والعسكريِّ في تدميرٍ الشأنِ الاجتماعيِّ والثقافي بالمغربِ، أيْ نسفِ الهويةِ المغربيةِ، شَنَّ حملةَ غزوٍ ثقافيٍّ وفكريٍّ يتلخصُ في “فرنسةِ المغربِ”، فترتبَ على هذا الغزوِ بنوعيهِ مقاومةٌ مغربيةٌ أبيةٌ تزعمتها الحركةُ الوطنيةُ (2)، ويعزى هذا إلى كونها قدْ أدركتِ الأبعادَ الاستعماريةَ لهذا الغزوِ الذي يهدفُ إلى نسْفِ الهويةِ المغربيةِ منْ خلالِ محوِ لغتِها باعتبارها حاملا وناقلا لهذهِ الهويةِ. ومن ثمّ رفعتِ الحركةُ شعارا يقومُ على مبادئَ أربعةٍ كان على رأسها التعريبُ كردّ فعلٍ على الفرنسةِ أولا، وباعتبارهِ مدخلا للتحررِ الفكريِّ والثقافيِّ والسياسيِّ. وشكلتْ بهذا انطلاقةً واعيةً للدفاعِ عنِ اللغةِ، ما دفعَ ببعضِ الأحزابِ الوطنيةِ المُتأسسةِ عقبَ الاستقلالِ السياسيِّ إلى تبني هذه الدعوةِ والاستمرارِ في منافحةِ الفرنسةِ (3) هذه الأحزابُ التي رأتْ في التعريبِ مدخلاً للوحدةِ الوطنيةِ أولا، وللتنمية الاجتماعيةِ والثقافيةِ ثانيا، وكذا تأسيسِ معاهدَ ومراكزَ للبحثِ ومؤسساتٍ تهتمُّ بالشأنِ اللغوي في المغربِ سياسيةً وتخطيطا وتعريباً، والتي لا تزالُ تبذلُ مجهوداً عتيدا إلى وقتنا الراهنِ. وفي هذهِ اللحظةِ التاريخيةِ الراهنةِ، نجدُ منْ يرفعُ معاولَ الهدمِ، ويتأهبُ للوثوبِ على اللغةِ العربيةِ، إنْ على المستوى السياسيّ الوطنيّ والدوليّ، أوْ على مستوى الإعلامِ المُستلَبِ المائعِ الفارغِ، والبرامجِ التربويةِ والفلسفاتِ التعليميةِ التي تُتَرجمُ في المقرراتِ المدرسيّةِ للمتعلّمِ. بيد أن هذا الهدمَ يعدُّ تتمةً للغزوِ الثقافيِّ الفرنسيِّ لكنهُ يختلفُ مع هذا الأخيرِ من حيثُ كونُهُ يتمُّ بفعلِ (أبناءِ الوطنِ؟) المتظاهرينَ بالتشبثِ بالهوية المغربيةِ. كما أنه يختلفُ عنهُ من حيثُ منهجُهُ في تنزيلِ مخططاتِهِ لتحقيقِ مصالحَ ومآربَ سياسيةٍ لحزبٍ أو جماعةٍ أو طائفةٍ؛ لأن فرنسةَ المغربِ ثقافيا وحضاريا كانتْ واضحةً، وقدْ أعلنوا عنها صراحةً “كما عبر عنها “بينو” الوزير السابق في الحكومة الفرنسية (قائلا): “لقد خسرت فرنسا إمبراطورية استعمارية وعليها أن تعوضها بإمبراطورية ثقافية” (4) في حين أن منْ يشاركوننا الوطنيةَ ويختلفونَ عنا بالدماءِ الفرانكفونيةِ التي تجري في عروقهم يمارسون مهمّتَهُمُ الهدَّامَةَ ضمنيا؛ كأنْ ينفثوا سُمَّهم في المناهجِ والبرامجِ التربويةِ، وفي وسائلِ الإعلامِ السمعيةِ والبصريةِ. وكانَ منهجُهم في ذلك مُنصبّا على الأستاذِ باعتباره رمزا للتثقيفِ والتنويرِ، وتوعيةِ النشءِ بأهميةِ الهويةِ الثقافيةِ المغربيةِ، والعربيةِ والإسلاميةِ. ومنْ هنا، لم يدخروا جهدا في هدمِ هذا الرمزِ من خلالِ تشويهِ مكانتِهِ وتبخيسِ مهمتِهِ ووظيفتهِ وتقزيمِهَا، والدفعِ بهِ إلى الرضوخِ بدلَ النقدِ، والتكرارِ والاجترارِ عوضَ الإبداعِ والابتكارِ.
لقد تمظهرتْ هذه الحربُ الضروسُ ضدّ الهويةِ في أبعادٍ ثلاثةٍ: اللغوي والثقافي والتربوي. لكنّ بين هذه الأبعادِ وشائجَ قويةً بحيثُ يظهرُ كلُّ منها عبر الآخرِ؛ فاللغةُ هي خزانُ الثقافةِ، والأستاذُ ينقلُ هذهِ الثقافةَ وقيمَها بواسطةِ اللغةِ، وهكذا، نذهبُ إلى أنّ تقزيمَ الأستاذيةِ هو محوٌ للغةِ والثقافةِ. لكنَ الأنكى والأخطرَ في الأمرِ هو توظيفُ الفنِ في هذهِ المهمةِ الدنيئةِ؛ إذ لمْ يعدْ وسيلةً للتوعيةِ والتثقيفِ والتنويرِ في بعضِ الأفلامِ المغربيةِ مثلا، بل أضحى وسيلةً للسخريةِ منَ الأستاذِ/القدوةِ واللغةِ والثقافةِ. ونمثلُ لهذا بفيلمينِ أُنتجا في السنتينِ الأخيرتينِ وسلسةٍ.
الفيلمُ الأول هو “مول البنديرْ” الذي تدورُ أحداثُهُ حولَ أستاذٍ يعملُ في مدرسةٍ خصوصيةٍ، ويتميز، في الفيلمِ، بالثقافةِ والأخلاقِ التي يهدفُ إلى نشرها في المجتمعِ وترسيخها لدى النشءِ كما قدم لنا الفيلمُ، لكنهُ انتقل من مهمة حاملِ القيمِ إلى مغنٍّ في الأعراسِ والحفلاتِ. وقد ارتأى الفيلمُ أن يبرزَ الانتقالَ السريعَ في حالتهِ الاجتماعيةِ منْ شخصٍ مغمورٍ فقيرٍ (مربي الأجيال) إلى آخرَ غنيٍّ ومشهورٍ (الضرب على البندير). فالمشاهدُ قدْ يرى أن الفيلمَ يبرزُ معاناةَ الأستاذِ المغربيِّ، ومظاهرَ الفقرِ المدقعِ الذي يرتعُ فيهِ، لكنهُ، في المقابلِ، قدْ لا يفطنُ إلى الرسالةِ المضمرةِ المسكوتِ عنها في الفيلمِ، وهذهِ المقصديةُ تتوجهُ إلى شريحتينِ مترابطتينِ ترابطَ السببِ بنتيجتِهِ: الشريحةُ الأولى هي معشر الأساتذة الذين يحملونَ قيما ثقافيةً وأخلاقيةً، إذْ يبخسُ الفيلمُ حمولَتَهمْ هذهِ، ويقزمها فيحدّ من نفوذِها داخلَ المجتمعِ المغربيِّ؛ وخلاصتُهَا: لم يعدْ لوجودكم معنى، ومنْ ثمَّ يجدرُ بكم أن تنتقلوا إلى الغناءِ والتطبيلِ عوضَ تجشمِ عناءِ التربيةِ والتثقيفِ، وهذا تتميمٌ لما بدأتهُ الدولةُ منذُ فرضتْ نظامَ التوظيفِ بالعقدةِ، وترفعوا (بنادركم) بدلَ رفعِ لواءِ التنويرِ. والشريحةُ الثانيةُ تتغيا المتعلمينَ والطلبةِ على اختلافِ مستوياتِهم، وذلكَ باعتبارهمْ أجيالَ المستقبلِ الذينَ يتكوّنونَ في المدارسِ والثانوياتِ والجامعاتِ، ويحلمُونَ بأن يصبحوا أساتذةً، ومن ثم يخبرهم هذا الفيلمُ أن الأستاذَ يضيعُ وقتَهُ كما تضيعون وقتَكمْ، فضلا عن أن منتهى ما قدْ يبلغهُ بعد تتمة مسارهِ هو الفقرُ المدقعُ وشظفُ العيشِ، ومن هنا، فالأَولى بكم أن تتعلموا “ضرب البندير” لا التعلم والتنوير والتثقيف. وهذا ما نُعِدّهُ تقزيما لمهمة لا تستأهلُ التقزيمَ، وهي الأستاذيةُ، وتضخيما لشيءٍ لا يستحقُّ التضخيمَ، وهو نمطٌ منَ الغناءِ والتطبيلِ. ولعلَ المُشاهدَ للفيلمِ سيتبينُ أنهُ قدْ ضرَّ الأستاذيةَ وأساءَ إليها أكثرَ مما خدمَها.
أما الفيلمُ الثاني الذي يبينُ ترفَ المجتمعِ المغربي وزهدَهُ في الثقافةِ، فهو المعنونُ ب”التكريم”. إذْ تدورُ أحداثُهُ حول شخصيةٍ روائيةٍ لها صيتٌ كبيرٌ داخلَ الترابِ الوطنيِّ، كما ينقلُ لنا الفيلمُ، فاستُدْعيتْ لتكريمٍ في إحدى المدنِ المغربيةِ. بيد أن مقصديةَ الفيلمِ متناثرةٌ في أحداثِهِ، وفي كلّ مرحلةٍ من مراحلِ الفيلمِ يتبدى لنا جانبٌ منها على لسانِ ممثلٍ؛ كأن لا يعرفَ معنى الروائي والفرقَ بينه وبين كاتب السيناريو، أو لا يقرأُ أعمالَهُ أصلا فيزعمُ أنهُ قرأها واستفادَ منها الكثيرَ. كما تتجلى المقصديةُ في أن الشخصيةَ الروائيةَ تحملتْ وعثاءَ السفرِ ومصاريفَهُ ليتمّ تكريمُها، في الختامِ، ب”زربية وشيك بنكي غير موقع قيمتها خمسة آلاف درهم ليعُوض هذا المبلغ بثلاجة”. فالشخصيةُ فقيرةٌ من الناحية الاجتماعيةِ رغم ثرائها الثقافي والفكري والإبداعي، إلا أنها لم تلقَ سوى الإهمالِ والازدراءِ، ومن ثم نقولُ إنها رسالةٌ واضحةٌ لا تخفى على المتتبعِ للشأنِ الثقافي بالمغربِ، والذي تشهدُ عليهِ ميزانيتُهُ الهزيلةُ. لكن الفيلم يختتمُ بإبرازِ أن فشلَ الروائيِّ في تحقيقِ غايته من التكريمِ، استطاعت ابنتُهُ أن تُحققَ هذه الغايةَ من خلالِ استدعائها للغناءِ في وصلة الإشهار. وهنا بالذات، يطلعنا مرةً أخرى على مكانةِ الغناءِ في المغربِ مقابلَ الثقافةِ والتعليمِ، ومن ثم جاء الفيلمانِ ليقولا: “كنْ مغنيا تكنْ غنيا” (5).
ولئنْ كانَ الفيلمُ الأولُ مثالا ليس الوحيدَ لنسفِ الأستاذيةِ، والثاني مثالا لتبخيسِ الإبداع في الحقلينِ الأدبي والثقافي، فإنّ سلسلةَ “الخواسر” تقدمُ لنا خيْرَ دليلٍ على النيّةِ المبيتةِ لأعداءِ اللغةِ العربيةِ والثقافةِ المغربيةِ (6). فالسلسلةُ تهجينٌ لهذهِ اللغةِ من خلالِ مزجهَا تعسفا بالدارجةِ المغربيةِ بهدفِ تعكيرِ صفوِهَا، وزحزحتها عن مكانتها، والازدراءِ بمُقوماتِها الوطنيةِ والقوميّةِ. ولعل هذا ما يدفعنا إلى القولِ إنّ الفنّ المغربيّ الحقيقيَّ، الذي عهدناهُ عند فنانين مقتدرين مغاربة ذوي مبادئَ راسخةٍ ورسائلَ نبيلةٍ، هو الذي يهدفُ إلى ترسيخِ الهويةِ المغربيةِ بمختلِفِ مقوماتِها ومكوناتِها ومشاربِها دونَ المفاضلةِ بينها، كما أنهُ يأخذُ على عاتقِهِ تثقيفَ العقولِ وتنويرَهَا، وإثراءَ الوجدانِ وتطهيرَهُ، وصياغةَ ومسرحةً وتمثيلَ قضايا وهمومِ الشعبِ المغربيِّ فنيا، والدفعَ بهِ إلى التحررِ فكريا وثقافيا. وذلك لأن للفنِّ رسالةً لا بدّ أن يؤديها بإخلاصٍ وتفانٍ، بأنْ يكونَ وسيلةً للبناءِ الفكري والثقافي والحضاري، وليس هدما ونسفا للمقومات الثقافية الوطنية، وحجر عثْرةٍ في طريقِ التقدمِ. فالبلدُ الذي لا يحترمُ لغتَهُ ولا يخدمُهَا فإنهُ لا يحترمُ نفسَهُ ومواطنيه.
الإحالات والهوامش:
1- بوشعيب الزين: إشكالية التعريب والخلفية السياسية، حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي نموذجا، نشر مجلة فكر العربية، عدد 3، السنة الأولى، دجنبر 2016، ص161.
2- لمعرفة الدور الذي اضطلعت به الحركة الوطنية منذ سنة 1930م، أنظر الصفحتين 151- 152 من المجلة المشار إليها في الإحالة الأولى، والمقال لبوشعيب الزين.
3- من بين الأحزاب الوطنية التي اضطلعت بهذه المهمة في حدود معرفتنا، حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وحضور محتشم لحزب العدالة والتنمية في حكومة بنكيران عبد الإله.
4- سبقتِ الإشارة إلى المقال والمجلة، وهذا ما نقله في ص152 من المقال والمجلة المشار إليهما أعلاه.
5- تجدر الإشارة إلى أن ها هنا تخصيصا منا لطائفة من المحسوبين على فن الغناء في المغرب، ولا نعمم؛ لأن ثم فنانينَ مغاربةً قد أعطوا، ولا يزالون، للأغنية المغربة نكهتَها الثقافية والفنيةَ الخاصة، والتي ارتقت بها إلى مستوى يشنف أسماعنَا، ونفتخرُ بهِ إرثا فنيا وثقافيا مغربيا. ومنه، نشير إلى أن الأغنيةَ المغربيةَ التي بهذه الخصوصية والأصالة تستحق التشجيعَ والدفعَ بها إلى الأمامِ.
6- ونحن نتحدثُ عنِ اللغةِ العربيةِ باعتبارها لغةً رسميةً أولى للبلدِ، فإن هذا لا يحجبُ عنا كونَ اللغةِ الأمازيغيةِ لغةً رسميةً ثانيةً، لها مقوماتُها وخصوصياتُها الثقافيةُ التي تُعدُّ لبنةً في صرحِ الثقافةِ المغربيةِ. وقدْ آثرنا الإشارةَ إلى هذه النقطةِ، حتى لا يتخذها غيرنا حجةً علينا فيرمينا بالتعصبِ أوْ التنكرِ للغةِ الرسمية الثانيةِ.