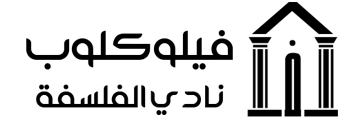الفيلسوف “النّذير” وغربة المصير عبد الوهاب البراهمي
- الفيلسوف “النّذيــــــــــر” وغربة المصير
- عبد الوهاب البراهمي
هو ذاك الذي يكون، في مجاز دولوزي ” بين الكلب والذئب”. بين الكلب في “خُلقه”، في حبّه الأقارب والأهالي وبغض الغريب، في وفاءه لسيده وحراسته “لمصالحه”، في عدم اكتراثه ” بالآخرين”، بين الكلب فيما يعنيه من العضّ أو القبض وسائر معاني التكالب وألفاظه…وبين الذئب في “خلقه” من حذر شديد وغدر وعدوانية، وما فيه من شرّ المفترس ووفاءه لأهله دون سواهم…
هو بين”الكلب والذئب” “نذيرا”، بشيرا ” كديك” الصباح( في مجاز ماركسي) ينذر بقرب طلوع الشمس ووَضَحِ النهار، يبشّر بيوم جديد، يصيح والناس نيام، حريصا على” اليقظة” والإيقاظ في ميقات لا يخلفه. أو لعلّه ” كبومة منيرفا” ( في مجاز هيجلي) في “خُلقها”، في الميل إلى العزلة والهدوء والسكينة، فلا تأتي إلاّ حينما يكتمل النهار، معلنة قدوم الليل، ومنذرة بميلاد “البداية”، بداية التأمل والتفكير الهادئ الرصين في سكون الليل، والليل رفيق ” الفلاسفة” في عزلتهم.
هو” الفيلسوف النذير” يحبّ الغريب قبل القريب، وفيّا للإنسان حارس” اللوغوس” والمعنى والمفهوم، يفني ذاته تأمّلا وتفكّرا من أجل ” الآخرين”، يحبّ ” الحقيقة” في ذاتها ويكره الجهل والحمق، لا ينقصه الحذر ولكنه يحذر من نفسه أكثر من حذره من الآخرين، من أهواءه، من آراءه وظنونه وأخطاءه ويحبّ الآخرين جميعهم، في خاصّتهم “الإنسانية” لا فيما هم عليه من تفاوت الحال واختلاف المقام. ينشد الكلّي والكوني و القيم المطلقة والمثل العليا، ويطلب ” الإنسان” قيمة القيم و غاية الغايات.
هو ذاك الذي يقف على أسوار المدينة يحرسها “ليلا نهارا” متيّقظا لأي خطر قادم، لا يسكن له فكر، يرهف السمع ” للوجود” ينصت لأنّاته وهمساته، لا يغفل عنه ولا تغمض له عين البصيرة، شاخصا يرقب الأفق، ينتظر ” ميلاد” شمس الحقيقة ليشعّ نورها الزمان والمكان. ” يتعلّم الموت” كما يقول أفلاطون، من أجل الحياة، حياة الفكر، حذرا متحوّطا باستمرار، يبحث عن “الحقيقة” في ظلام الليل ووضح النّهار، يستهدي “بنور قلبه” كما يقول الغزالي، بمثل”مصباح” ديوجان لايرس، يحمله نهارا يضيء به الطريق ” للنيام ” من حوله، أولئك الذين “لا يستيقظون إلا حينما يموتوا” بتعبير الغزالي. أولئك الذين يقيمون في العالم، مطمئنّين للعادة للإلف والمألوف، تحملهم الأيام برتابتها، يخوضونها خوض الغافلين لا يأبهون فيها إلاّ بما كسبوا من معاش وما حصّلوه من لذّة، ولا يعنيهم إدراك معنى الزمان ولا المكان ولا المستحيل والإمكان…
هو الذي ينبّه باستمرار إلى مزالق الوهم والعنف والظلم والجبن والوهن. وهو الذي يدعو إلى لزوم التحوّط والشك والنقد والسؤال عن ” البداهات” بالذّات، خشية أن نقع في الغلط والمغالطة وطمأنينة الوهم، عن المخفي والغريب، عمّا يدركه العقل وما يعسر عليه إدراكه، عن المعلوم والمجهول، عن المحسوس والمعقول، عن الفعل والفاعل والمفعول…
هو ذاك الذي لا يكلّ عن السؤال عن شيء ولا تثنيه الصعاب عن الخوض في كلّ شيء حتّى وإن لم يظفر بشيء سوى مزيدا من الحيرة والتردّد والقلق. ومع ذلك يزداد إصراره على الترحال في ثنايا وتضاريس المجهول والمعلوم ومتاهات المعنى … لعله يعود إلينا بفهم أو بإمكان فهم ، نرفع به لبسا و نوضّح ما أشكل علينا فهمه في الوجود والموجود، بما فيه من العجيب والغريب والمعهود..، فهما يضفي على وجودنا معنى ويمنح حياتنا هدفا ينزع عنها العبث واللامعنى ويحررها من التفاهة والابتذال، بوجاهة الفكرة وعمق السؤال .
هو الذي لا يكفّ عن الترحال في الفكر والفعل والقول والكائن والكيان والكينونة والزمان …، لا يملك من الزاد إلا إرادته،” إرادة المعرفة” و ” إرادة الحياة” بعبارة شوبهاور، لا يثنيه ألمها ولا يثبط عزيمته ما يصيبها أحيانا من يأس وإحباط ، ولا يأبه لترف الحياة وشغفها، ينشد ” الفهم” أو إمكانه ولا يرضيه الجهل والحمق والظنّ وقيود التقاليد والعادات والتمثّلات…ولا الإقامة في العالم، “كهفا مظلما تملأه الأغلال” في مجاز أفلاطوني في ” أمثولته” الشهيرة. بل هو بمثل “ذاك السجين” الذي تحدّث عنه أفلاطون، وقد ” حطّم قيوده” وخرج عن ” القطيع” القابع في ظلمة “الكهف” صاعدا إلى الأعلى مقتفيا أثر الضوء متطلّعا إلى ما يوجد خارجه، إلى ” عالم النور”، حيث تضيء ” شمس الحقيقة والخير الأسمى.. ” بنورها على الموجودات، فتكشف ” الأشياء” على حقيقتها.. وهو الذي يأبى، مع ذلك، إلاّ أن يعود إلى رفاقه في” السجن” بما أدرك وعرف، منذرا مبشّرا داعيا إلى الحق والخير والجمال.، مواجها كلّ الصعاب والأخطار وأقصى أشكال العقاب المعنوي والمادّي من الإعراض والتكذيب والسّخرية ..وحتّى الموت.
هو ذاك الذي “يقف على عتبة الجحيم” بتعبير لماركس، لا يتردّد في أن يلقى بنفسه فيه، إذا كان الثمن تحرير عقول البشر من عقال الدغمائية والعَقَدِية، أو تحرير الناس من نير العبودية والظلم والقهر والبؤس والفقر. وهو الذي يجابه ألم النفي، وعنف السلطة ، وقلق الموت، بلامبالاة أبيقور، وشجاعة ابن رشد، وحتّى ” بالانتحار” ، على طريقة ” سقراط” حينما يُحاكم ” بتهمة إنارة عقول الشباب”، ويُعاقب بالموت، فيختار شرب السمّ مفضّلا موتا يختاره على حياة ” الهُمْ”، حياة “الجهل والوهم والظنّ،والانقياد للأهواء ..” ، فيهب حياته للآخرين ثمنا ” لحبّه الحكمة” وطاعة للآله ” زوس”، وامتثالا “لقوانين المدينة”. أو على طريقة “جيل دولوز” محرّرا جسده من ” ألم الحياة ، سقما أنهكه” ملقيا بنفسه من علوّ، واهبا جسده للأرض، حيث المارّة على “طريق” الحياة يعيشونها كما هي.. عارية إلا من “رغبة في الحفاظ على الكائن ” بتعبير ” معلّمه” سبينوزا.
هو الذي يقيم على حافّة الجنون والعُصَاب من أجل تعقّل المعقول واللامعقول من” الحمق والجنون” ، و ما وراء العقل وما دونه وما بعده، في موقع ما، من “وراء الخير والشر” أو”مابعد الطبيعة” ، ” في “الفطرة” ، في” الشيء في ذاته” أو” في عمق الشعور والحدس العقلي؛ تعقّلا وتفكّرا وتأمّلا، في حركة حرّة لفكر لا يأبه بالأركان والزوايا ولا بالسطح ولا بالفراغ، يتحرّك في كل الاتجاهات ومن جميع الزوايا الممكنة، يقطع الثنايا والمسالك الوعرة ويحدث الفراغات ويلفّ الطيّات ويلقي بنفسه في المتاهات، يتحسّس التضاريس والنتوءات لجغرافية الفكر والوجود، ناظرا متأملا متفكّرا قارئا مفسّرا للظاهر، مؤوّلا للباطن؛ يطلب المعنى وما وراءه، يصرّ على الفهم، حتى لو كلّفه الأمر ارتيابا ليس له قرار، ارتياب تأويل لا متناه” بعبارة بول ريكور، لن نظفر فيه بسكينة ” الفهم” التام، ولا بسكينة النفس من قلق السؤال على معنى “أتاراكسيا” الريبييّن في زعمهم الشكّ مذهبا، أو على معنى”نسبية الحقيقة” حينما يكون الإنسان” مقياس جميع الأشياء ” على حد ّ عبارة السفسطائي ” برواغوراس؛ أو “يقين” الذات و” إطمئنانها لبداهتها “حينما تنثني إلى ذاتها وتنغلق على نفسها متعالية، قبالة العالم كما أراد لها ديكارت، أو “حدْسا” للذات في عمق الشعور بذاتها في الديمومة كما يزعم برجسون…
هو الفيلسوف ” النذير” بمنزلة ” النبيّ” كلّفته ” الآلهة ” كما يزعم سقراط، ليتحدّث للناس عن الحكمة بلسان المحاور البارع، ” بلسان ” زرادشت” نيتشه، حديث ” المعرفة المرحة”، وحديث الإنسان” المفرط في الإنسانية”؛” ديونوزويا” و” وبروميثيوسيا” و” أبولونيا”…بلسان “الآلهة ” في تعدّدها وتراتبها، بلسان “البطل الأسطوري”، بروميثيوس سارق النار من أجل الإنسان ..، حديثا تنسجه اللغة مجازا وكناية، أقوالا وحِكَما، ونثرا مسترسلا و”نثرا أشبه بالشعر”، ” خطابا ” للعقل”، يحاور من خلاله الفيلسوف تارة ” الأميّ ” مينون” وطورا السفسطائي ” غورجياس “، أو غيره ممّن تفنّنّوا في ” لعبة الكلام” أووقعوا في حبائله وتاهوا في فنونه؛ على طريقة سقراط الأفلاطوني، يجادل ويحاجج ويفرط في الحجاج، يبني السؤال كما لم يكن من قبل، “يصنع المفهوم” وينحته نحتا ويقدّه من صخر ويزرعه في أرض بوار ليبعث فيها الحياة، حياة “الفكرة” يبنيها بتسلسل البراهين والاستدلالات ووجوه القياس وفنون المنطق والكلام؛ فيضرب المثال والأمثولة ويقيم المقارنة والمماثلة، ويكشف المفارقة والتناقض و يَسْتشكل و يُأشكل ويعرّف ويُأَفْهِمُ، ويصوغ السؤال تلو السؤال، يقلّبه على وجوهه حتى يستقيم له الجواب أو بالأحرى إمكان جوابٍ، ما أن يحطّ رحاله، حتّى يتحوّل إلى سؤال يتكاثر يُولَد من جديد ويُوّلَد توليدا “سقراطيّا ” أو “بديالكتيك أفلاطوني”، يتكثّر، يتعدّد، ويتفرّد، في مسار تساؤل لا يسكن ولا يقرّ له قرار، ولا يرضيه ” الجواب” ولا السؤال مهما كان. كيف وهو الذي يقيم في الصّراع والنزاع، في الحرب والحبّ، في الصداقة واللطف وفي المقاومة والخوف، في الحضور والغياب، في الحيرة والتردّد، في الدهشة والإعجاب، في الغربة والغرابة والاغتراب، وفي كلّ ضروب التناقض ظاهره وباطنه، يجابه مصيره، فردا أعزل إلاّ من إصراره، في وحشة العزلة وغربة الطريق، وحيدا بين الجميع، ” يتجوّل بين الناس كأنما هو في حديقة بين الأشجار” على حدّ وصف ديكارت لنفسه.؟ !!!
هو ذاك الذي يقول و قد لا يكتب ما يقول حتى لا تموت الفكرة وتسجن في الحرف كما يزعم سقراط. أو هو الذي يقول ويكتب ما يقول ويسمع ما يُقال من وجوه الحكمة وفنون القول فيها حتى لا تضيع الفكرة في متاهات الشفهي. يدوّن ” بنات أفكاره” وما ورثه من بني ” نحلته” من الفلاسفة، يقلّب النظر فيها نقدا وتفسيرا وتحليلا وفهما وتأويلا، يجابه الكلام بالكلام ممتطيا ” فرس الإرادة “الجامحة” للرفض، للنقض للإختلاف، ممسكا ” بمطرقة النقد النيتشوية” يطلب” أفول الأصنام ” ، أو” مطبّبا للحضارة” فاحصا علّتها، منفجرا في وجه “الزيف والكذب والتمويه ” ،” كالديناميت” في وصف نيتشه لنفسه.
هو ذا الفيلسوف ” النذير ” يقول في الناس وللناس ويردّد القول بكلّ لسان، يهمس و يصرخ يخفي ويجهر، ينذر يبشرّ، يتوعّد ويتعهّد، يلين القول ويشّدد. ولكنّه مع ذلك كلّه ” نذير ” لا يُسمع لقوله، ولا يكترث غالب الناس لصنعه، “كبيت العنكبوت” يفنى العنكبوت في نسجه ثمّ يذهب مثلا في الوهن، أو كـ”سنّمار”، يخلص في ” البناء” لغيره ثم يموت “غدرا” ، غريبا يعيش وحده ويموت وحده وهو الذي يسكنه الجميع.
*******************