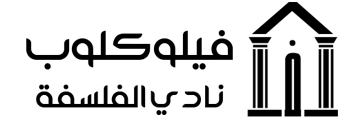إشكالية السعادة في أخلاق أرسطو
مقدمة.

كانت السعادة عروسة الفكر الفلسفي ولا زالت من أمهات المشاكل الأخلاقية التي تسم المتون الفلسفية ضمن مجال فلسفة الأخلاق منذ أن بزغت الحكمة في مهدها الإغريقي القديم. لذلك نود الاشارة في البداية أننا بصدد موضوع فلسفي من المواضيع الكبرى و المتشعبة مما يحول دون الإحاطة بكل ما قيل فيها و أنتج حولها، و يكفي أن ندل على ذلك من خلال حجم مؤلف أرسطو الذي يشكل بيت القصيد من هذا البحث، وهو ” الأخلاق إلى نيقوماخوس” ، هذا الكتاب الذي لم يهتم فقط بتشريع المبادئ الصالحة لفرد بعينه و إنما وسع من مجال شموليته ليكون بمنزلة دستور تهتدي بهديه المدينة الدولة لما يخطط له من واجبات مدنية و بيان لحلول و كيفيات تنظيم المواطنين في سبيل حياة الرفاهية و الرضى النفسي.
لا تكاد تجد مؤلف في هذا المجال إلى و أشار لهذه القضية الجوهرية من قريب أو من بعيد باعتبارها، أي السعادة منال الطموحات عند بني الإنسان الذي ينزع نحو تملك هذا المقام المنشود وفق معطيات تكلمت فيها الفلسفة قديما و حديثا محاولة دسترة بنود هذا المبلغ النبيل مما حرك عقول الفلاسفة اللذين أنتجوا أبحاث تميزت بالاختلاف و التلون بالرغم من احتفاظها بمركزية و سيادة مفهوم السعادة على أنه محور العجلة و نبراس التربية، بحيث مهما طال الاختلاف و التلون الفروع يظل الأصل ثابتا، بمعنى آخر رغم تعدد الرؤى حول تصورات السعادة التي تتمثل عند الناس حسب شعورهم و تجاربهم كل حسب وضعه تبقى هاجس أبدي و شريف كما دعاها المعلم الأول أرسطو الذي سيج الفكر الإنساني حسب ما اكتنزه من تجذير و ترسيم لمعالم الفكر الانساني الذي ما انفكت تجري فيه جل العقول رغم يناعتها لتنحصر داخل أطر سبق أن تكلم فيها هذا الفيلسوف اليوناني الذي أحببنا السباحة ضمن شواطئه الأخلاقية من خلال دراسة و تحليل و تلخيص كتابه الكبير ” الأخلاق إلى نيقوماخوس” الذي شكل مرجعا رئيسيا في الفن الأخلاقي، والذي يجسد نوعية الحياة الفاضلة كما كان يتصورها الفكر الفلسفي اليوناني القديم.
قبل تفصيل الحديث في هذا الكتاب و قبل التلميح على مضمونه و تصوره لإشكالية السعادة كما عالجها أرسطو نود إلقاء نظرة و لو سريعة على طبيعة الأخلاق اليونانية لا سيما تلك الأطروحات التي تناولت قضية السعادة و التي حاولت أن تجيب على كيفية تحديد خطوات تمكن الإنسان في حياته من الرضى على الوضع، و تقبل العيش،و التي سادت قبل أو قبيل أرسطو لما في ذلك من أهمية.
هذه الأهمية تتجلى خاصة في كون أرسطو جاء ليقول عكس ما قيل قبله في هذا الموضوع، و بصيغة أخرى جاء للرد على من سبقوه ليدشن الطريق لمن يعاصرهم و يعيشون بعده حسب الثقة الواثقة التي ضمنها عمله الأخلاقي و حسب طبيعة رسمه و تشريعه لهياكل ما أسماه الخير الأكمل، غير أنه ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أن لا سعادة يمكن تحقيقها ما لم يتم تحقيق الفضيلة، كون هذه الأخيرة تمثل القنطرة الحقة التي يبقى عبورها مفروضا و يشكل درجة أساسية في طريق حيازة و بلوغ السعادة، بحيث لا يمكن مع أرسطو أن يكون المرء سعيدا ما دامت تعوزه الفضيلة التي ترافق السعادة جنبا إلى جنب و التي تتضح وقت وقوفنا على تشريح هذا الإرث الأرسطي، فكيف نظر السابقون لأرسطو خاصة المدرستين الأبيقورية و الرواقية إلى الفضيلة؟ و في ماذا يتجلى لهم الخير الأسمى الذي ربطه أرسطو بالسعادة؟ وكيف تسنى لهم أن يجعلوا من اللذة هما شاغلا؟
ليس من قبيل الصدفة أن ارتأينا العودة إلى ما قبل أرسطو للحديث و لو بصورة مختصرة أن أهم التصورات الكبرى في ميدان الأخلاق و مبادئه الأساسية؛ و إنما في ذلك كما يقول البعض أن العودة إلى الوراء فضيلة، بحيث نكون هنا بصدد معرفة ما هي أهم وجهات النظر التي يخالفها أرسطو أو يتقاطع معها أحيانا مفترضين أن أرقى ما وصله العقل اليوناني أنذاك في تحكيم الفلسفة في الحياة الحكيمة كان مع أرسطو الذي ناقش مجمل الميادين و قال كلمته فيها.
و لإبراز طبيعة الفكر الأخلاقي الموسومة في الغالب بنقاشات غزيرة حول اللذة قبل أرسطو نقف وقفة وجيزة لبيان هذا الغرض، لقد ورد في كتاب عنوانه”أبيقور” لمؤلفه” بيار بويانسكي، أن سقراط نفسه درس طبيعة اللذة، و قيمتها، مما أثر في تلميذه أرستبوس الذي تلقى من أستاذه أن التفكير العملي يجب أن يهتم في فكر الحكيم باللذة، بكون سقراط قام بنوع من حسابه للذة و الألم، على ضوء اجتناب اللذة المؤدية للألم، و أرستبوس يعتبر اللذة مرتبطة باللحظة الحاضرة مما يجب معه الحفاظ عليها، دون البحث عنها في مكان آخر، وفي ذلك تأكيد على استعمال اللذة، دون الانسياق معها، هذا ما نص عليه حرفيا بقوله” أنا أملكها، و ليست هي التي تملكني”.
أما أفلاطون فقد أكثر التأمل في اللذة في محاورة فيليب معتبرا إياها مثل أرستبوس كحركة يجب على الحكيم أن ينصرف كليا تقريبا لمشكلة اللذات و المشقات، وأن ينظم طرق البحث عنها أو الهرب منها، و ذلك منذ الطفولة الأولى، هذه المشكلة أساسية للتربية بالمدينة، ينبغي دراستها كحركة منتظمة و معتدلة حسب أرستبوس، لأن الالم حركة عنيفة.
عارض أرسطو فكرة حركة اللذة، إذ رأى في هذه الأخيرة كما في الالم، حالة ثابتة و محددة، بيد أن ابيقور يشير إلى شمولية البحث عن اللذة عند كل الكائنات الحية، بما فيها بني البشر، وهذا ما اشار إليه حين جعل اللذة محرك طبيعة الاشياء ، باعتبارها النهاية السوية التي تحبها الطبيعة لنشاطنا ، لأن السعادة تبقى محالة في غياب امتلاك و تجميع اللذات، فاللذة بداية و غاية الحياة السعيدة.
غير ان المدرسة الرواقية قد أعطت الحكم للعقل بكون اللذة تجر صوب الهلاك، مما يجب معه ضرورة الوعي بأضرار الملذات و التعامل معها بحكمة، مما يوضح لنا المقولة الشهيرة للرواقية التي تجعل الإنسان مقياس كل شيء، ذلك بفضل ما له من إدراك و تعقل يوجه حياته السعيدة.
أما الآن نعود إلى ” الاخلاق إلى نيقوماخوس”، هذا الكتاب الذي انتظمت داخله عشرة مقالات أو كتب، في المقالة الاولى يتحدث أرسطو عن السعادة في شكلها المبعثر ما بين العامة و الخاصة، مركزا على ما ينبغي ان يكون لتحصيل سعادة حقة، و منتقدا في الوقت نفسه ما قيل حولها محاولا تعزيز الصواب و تعديل الخطإ، بعد هذه المقالة الاولى يغوص أرسطو في بحثه ضمن الفضائل الاخلاقية و العقلية التي كلفته ثماني مقالات كاملة مركزا دوما على اعتبار السعادة موضوعه الجوهري، رغم انسياقه تارة إلى البحث في شؤون الدولة من طب و علم و فنون لكن هو إن ذكر كل ذلك لا ينسى بأن السعادة تتطلب التوسع في الحياة كونها لازمة و شاملة بحيث تظل حاظرة في كل مكان و مقال، أما في المقالة العاشرة و الاخيرة فهنا يريد أرسطو أن يحصد ما زرع إن جاز لنا التعبير، أي يقف حول السعادة في بنائها الكامل كما أراده، و عليه يمكن القول أن أرسطو جعل الفضيلة قضية جوهرية ضمن بحثه للسعادة، و يمكن القول أن مؤلفه يجوز أن نقول عنه أنه قابل للتصنيف إلى محورين كبيرين بغض النظر عن المواضيع الجزئية وإن كانت تبدو مهمة، و بهذا التفصيل نسمح لأنفسنا بتوضيح الطريق أمامنا، آخذين بعين الاعتبار لزوم الفضيلة للسعادة مع أرسطو، و نصوغ هذا الإشكال؟ ما هي الفضيلة؟ و ما انواعها؟ وما دورها في بلوغ السعادة؟ كيف حاول أرسطو تفنيد التصورات الرائجة حول مبدأ السعادة؟ و بماذا عوضها؟ و هل هناك ما يفوق السعادة قيمة أم تخلد هي بالذات غاية الغايات؟
الفضيلة العقلية عند أرسطو
ليس من قبيل الصدفة أن بدأنا بتحديد الفضيلة عند أرسطو و أخرنا الحديث عن السعادة، كما فعل هو في كتابه” الاخلاق إلى نيقوماخوس”، الذي انطلق من السعادة في البداية ليمر من الفضيلة و ينتهي أخيرا عند السعادة من جديد، و إنما نرى في هذا التعديل توضيحا نبرز من خلاله التسلسل المنطقي الذي من خلاله نستطيع فهم موقف المعلم الأول خاصة أن الفضيلة على الرغم من أهميتها العظمى التي تتميز بها إلا أنها تبقى و سيلة من أجل السعادة التي اتخذت مع فيلسوفنا مقاما يعلى و لا يعلى عليه.
في الحقيقة يربط أرسطو السعادة بالفضيلة ارتباطا وثيقا إلى درجة الخلط بينهما، و يقسم الفضيلة إلى نوعين : فضيلة أخلاقية ندرسها في المحور الثاني من هذا الفصل، وفضيلة عقلية تمثل هذا المحور الذي نحن بصدده، يقول أرسطو” و الفضيلة صنفان: منها فكرية و منها خلقية. فالفكرية كونها و تزيدها في أكثر الأمر يكون بالتعليم، و لذلك تحتاج إلى دربة و مدة من الزمان. “[1].
تبدو الفضيلة العقلية مرتبطة بالعقل لذلك سميت بهذا الاسم، و هي تتكون وتنمو بواسطة التعلم و التهذيب لهذا تتطلب منا الوقت و التجربة، و من هذا المنطلق تحضر الحاجة للبحث في العقل لتحديد فضائله، و لهذه المهمة أخذ فيلسوفنا على عاتقه تقسيم النفس إلى جزأين لمعرفة كنه الفضيلة العقلية لأنه يرى” في النفس جزأين هما: الجزء العقلي، و الجزء اللا عقلي. وعلينا الآن أن نقر، بالنسبة للجزء العقلي قسمة من نفس النوع. و لنجعل أساس المناقشة أن الأجزاء العقلية عدتها اثنان، أحدهما نتأمل به هذه الأنواع من الكائنات التي لا يمكن مبادئها أن تكون بخلاف ما هي كائنة، و الثاني به نعرف الأمور الممكنة”[2].
من خلال هذا القول نستطيع تحديد الجزء العاقل من النفس الذي ينطوي هو أيضا على جانبين ينصرف الجانب الأول لتأمل الموجودات الكائنة بالضرورة الطبيعية، أي مواضيع العلم كما كانت تعتبر مع اليونان بكونها لا دخل لنا في تغييرها مما يجب معه حب الطبيعة و احترامها، و هذا الجزء يسمى العلمي أو النظري، و الجانب الثاني و يسمى العملي و يدعوه أر سطو التقديري مما يجعلنا أمام موضوعين مختلفين لكل واحد منهما جزء من النفس يتلاءم معها، و لما كان الجزء العملي لا يتعلق إلا بالأمور الجزئية و المتغيرة، فإنه يقع في درجة أدنى من الجزء النظري الذي من واجبه الاهتمام بالكليات و الصور الثابتة، و في سبيل تحديد فضيلة كل جزء الخاصة به، يعتقد صاحبنا أن بداخل النفس ثلاثة عناصر رئيسية تبرز نوع الفعل و الحقيقة وهي :
الحس و العقل والشهوة، فيبعد الحس لكونه يخلو من المبادئ الأخلاقية بدليل أن الحيوانات لديها الإحساس و تفتقر لفضيلة الأخلاق، أما العنصرين الباقين، الشهوة والعقل فهناك علاقة بينهما حيث إن الاشياء التي يثبتها العقل أو ينفيها، إما تحبذها الشهوة أو تنبذها، وفي هذا الأمر ما يسمح بالقول أنه لما كانت الفضيلة قدرة على الاختيار الشهواني بناء على طاعة العقل ، فانطلاقا من اختيار الشهوة للأشياء الطبيعية و تقريرها بواسطة العقل، يؤلف هذا الفيلسوف ما يسمى بالسعادة أو الحياة العملية باعتبارها فضيلة الجزء التقديري من النفس أي العقل العملي، أما بخصوص الجزء العلمي أو النظري فالفكر التأملي لا يتعلق بالأمور الجزئية، وصلاحيته لا تتجاوز الحكم عن الصدق و الكذب، له فضيلة هي الحكمة النظرية، أما صلاحية العقل العملي فهي ترتبط بالحقيقة الملازمة للشهوة و يكون المبدأ الأخلاقي تحت توجيه و تحكيم ملكة العقل لأن” العقل مأخوذا في ذاته لا يحرك شيئا. و لكن الذي يحرك في الواقع إنما هو ذلك العقل الذي يتصدى غرض خاص و ينقلب عمليا. فهو حينئذ الذي يأمر ذلك الجزء الآخر من العقل الذي ينفذ”[3].
يتضح انطلاقا من هذا القول أن العلاقة الموجودة بين العقل العملي و العقل التأملي، أن الأول مصدر الأفعال الأخلاقية و منبعها و هو يتوجه لطلب الأغراض الخاصة، بينما الثاني يتجلى دوره في تنفيذ الأفعال و السلوكات الطيبة و الحسنة، و هنا يعتقد المعلم الأول أن العقل يلعب دور الموجه نحو غاية مبدئها الشهوة التي تسعى لحياة فاضلة و سعيدة، لكن إذا كان حقا العقل النظري يتميز بفضائل، سوف تكون فضائل فكرية أو عقلية، و إذا كان ذلك كذلك، فما هي هذه الفضائل؟ و أين تتجلى؟
يذهب الفيلسوف أرسطو إلى حصر الفضائل العقلية في خمسة فضائل أساسية و هي:
1- العلم:
يعتبر العلم فضيلة عقلية يتم بفضلها إدراك الأشياء الموجودة في الكون، خاصة الأشياء الثابتة و الدائمة في الوجود، لأن الأشياء المتغيرة ليست من مجال العلم و وجودها غير ثابت، ” فموضوع العلم إذن بالضرورة، و هو تبعا لذلك سرمدي، لأن الكائنات الموجودة وجودا ضروريا مطلقا كلها سرمدية، و الموجودات السرمدية ليست كائنة و لا فاسدة”[4].
تبين هذه الفكرة أن موضوع العلم يتميز بالسرمدية و الوجود المطلق الذي لا ينتابه الفساد و التغير، و منهج العلم هو الاستقرار كمبدأ ينطلق من الجزئيات لإدراك الكليات و البرهنة عليها، ويمكن تعلم العلم لأن التعليم يصدر عما هو موجود بذاته على شكل مضبوط.
2- الفن:
يكمن مبدأ الفن في صاحبه، أي في الفنان أو الصانع، و لا يوجد بالضرورة على شكل ثابت، و هذه المهارة متضمنة في ذات الصانع كمعرفة غير قابلة للدرس مثل موضوع العلم، أضف أن الفن يطبعه التغير من فنان إلى آخر مما يؤدي إلى منتجات مختلفة و ممكنة الوجود، فالفن لا منطلق له من الطبيعة المستقلة عن تدخل الإنسان باعتباره الفاعل التقني، و هنا يبرز الاختلاف بين العلم والفن، لما كان الفن يرتبط بما نستطيع إنجازه فإنه يشمل حتى الفعل، لكن الفعل يختلف عن الإنتاج، لكون هذا الأخير يبقى قاعدة ذهنية، عكس الفعل الذي يؤدي نحو الإحداث و التغير الملموس.
3- التدبير:
من الطرق التي يرى أرسطو أنها تسمح لنا بفهم التدبير هي النظر في من هم الناس المدبرين القادرين على التدبر السليم بخصوص الخير و المنفعة بشكل عام مثل الاهتمام بما يحقق السعادة، لا بشكل خاص كالاقتصار على ما يفيد الصحة لوحدها، وعل كل حال فالتدبير يدل على التقدير و الرؤية من أجل غاية ما، لكن الرؤية غير ممكنة في الأمور الموجودة بالضرورة و الخارجة عن الفعل البشري ، وتبعا لذلك، إذا صح أن العلم يقوم على البرهان، و أن الفن يكمن في الأشياء غير الموجودة بالضرورة سيختلف التدبير عن العلم والفن” فإن الفطنة لا يمكن أن تكون علما و لا صناعة: علما، لأن موضوع الفعل يمكن أن يكون بخلاف ما هو؛ صناعة، لأن جنس الفعل هو بخلاف جنس الإنتاج”[5].
و من ثمة يظهر الاختلاف بوضوح بين التدبير و هو ما تدل عليه هنا كلمة فطنة، و بين العلم و الفن و هو ما تدل علية لفظة صناعة، لأن التدبير مجاله الفعل أما العلم فلا، و لأن الفعل و الإنتاج يختلفان باختلاف الجنس، أما معنى التدبير فهو استعداد قادر على الفعل في ميدان الخير والشر و امتلاك القدرة على إدراك صلاح العموم، و نقدم إشارة على أن التدبير سوف يعني الحكمة العملية فيما بعد لهذا لا ينبغي أن نستغرب.
-4 العقل العياني:
يقوم العلم على الحكم المتعلق بالكليات و الموجودات الضرورية و يبرهن على الحقائق الصادرة عن المبادئ، ” فينتج عن هذا أن مبدأ ما يعرفه العلم لا يمكن أ ن يكون هو نفسه موضوعا لعلم، و لا لصناعة، و لا لفطنة: ذلك أن موضوع العلم قابل للبرهنة عليه، ثم إن الصناعة والفطنة ذوات علاقة بالأشياء التي لا يمكن أن تكون بخلاف ما هي”[6].
ليس إذن مبدأ العلم هو موضوعه، لأن الموضوع العلمي يمكن البرهان عليه، و لا يعتبر العلم أيضا موضوعا لأن الموضوع العلمي يمكن البرهان عليه، و لا يعتبر العلم أيضا موضوعا للصناعة أو الفن و الفطنة او الذكاء او بالأحرى الحكمة العملية، إذ أنهما متعلقان بما من شأنه التحول و النسبية، كما أن الحكمة لا تتخذ من المبادئ موضوعا لاعتبار أن الحكيم عليه ان يبرهن، و أخيرا لما كانت الاستعدادات التي توفر الحقيقة و تتنحى الخطأ في الكائنات الثابتة أو المتغيرة في أنطلوجيتها هي العلم و الفطنة و الحكمة و العقل، و لما كنا لا نستطيع بواسطة العلم والحكمة و الفطنة إدراك المبادئ ” فيبقى أن العقل هو الذي يدركها”[7].
-5الحكمة النظرية:
هي أتم أشكال المعرفة، قد تدل على الماهرين في الصناعة: كالنحت و صناع التماثيل، أو عن أمور خاصة من هذا القبيل، لكن بما أن الحكمة معرفة تامة، يجب”إذن أن يعرف الحكيم ليس فقط النتائج الصادرة عن المبادئ، بل وأن يملك أيضا الحقيقة عن المبادئ”[8].
هذا يجعل الحكمة عقلا عيانيا بإدراكها للمبادئ، و يجعلها علما عند إدراكها لحقيقة المبادئ ونتائجها، و الحكمة في معناها الصحيح لا علاقة لها بمعرفة المصالح الخاصة، لأنه بهذا المنطق يصبح من الحكمة أنواع كثيرة كل واحدة منها تختص بمجال معين، وعليه يتضح لنا أن الفرق الواضح بين الحكمة وبين السياسة.
من خلال الـتأمل في هذه الفضائل العقلية الخمسة، يتضح أن فضيلتي التدبير أي الحكمة العملية و الحكمة النظرية هما اللتان لهما علاقة بالأخلاق عند أرسطو ، و قد تبدو الفضائل الثلاثة الاخرى لا فائدة منها هنا أي العلم و العقل العياني و الفن أو التقنية بالمفهوم المعاصر للكلمة، لكن رغم ذلك فهي نافعة لتجويد فهم الفضيلتين الأساسيتين، أعني الحكمة النظرية و الحكمة العملية اللتان تبقيان في مقدمة الفضائل العقلية، لكن ما فائدتهما؟ و ماهي العلاقة الكامنة بينهما؟
مما لاشك فيه أن فائدة الحكمة النظرية لا تتجلى في إسعاد الناس بنفس الدرجة الذي تساهم بها الحكمة العملية، ذلك نظرا لأن لعدم اهتمام الحكمة النظرية بأحوال التغير، و تركيز اهتمامها بدراسة الكون في نظامه الأبدي المتناغم الذي لا يعتريه التفاوت و النقصان، أي و ظيفة الـتأمل الحر، وهنا تتمثل الفائدة من الحكمة النظرية، أما الحكمة العملية فدورها هو أن تهتم بما يحتاجه الإنسان من أمور جميلة، وعادلة و خيرة باعتبارها مسائل عملية بإمكانها الاستغناء عن المعرفة النظرية، إذا ما تحققت الفضيلة و أصبحت عادة راسخة. أما من حيث العلاقة بين الحكمتين فلعلها تتضح من خلال قول أرسطو التالي”أنه قد يبدو غريبا، أن تكون للفطنة، و إن كانت أدنى مرتبة من الحكمة النظرية، سلطة أعلى من سلطة الحكمة النظرية، لأن الصناعة التي تنتج شيئا ما تحكم و تهيمن على ما يتعلق بهذا الشيء”[9].
انطلاقا من هذا القول نستشف ان الحكمة العملية بالرغم من دنو مرتبتها أمام الحكمة النظرية فهي تحتل قوة التحكم في هذه الأخيرة، و الدليل أن ما ينتج عن شيئا فهو يملك في حد ذاته سلطة التحكم فيما أنتجه و تعلق به، و بصيغة أكثر وضوح فالحياة الأخلاقية بناء على هذا المعنى تسخر الحياة العقلية لغاية السعادة، لكن يظهر لحد الآن أننا لم نقف بعد عن السعادة التي ينشدها أرسطو، إذ كل ما تطرقنا إليه هو فقط بيان الخصائص التي تتميز بها، أو التي ينبغي توفرها من أجل التمكن من السعادة، كما رأينا الفضائل الأخلاقية التي تسعى إلى تنظيم الحياة السياسية و تحصيل الخير في الدولة، لأن الإنسان كائن سياسي بطبيعته، يسعى لغاية أسمى تتطلب ضرورة أن يكون فاضلا، إلى جانب الدور الذي تلعبه الحياة العقلية في تيسير أمور الحياة بشكل عام بتجنب الوقوع في مزالق العيش، فما هي الفضيلة الأخلاقية؟ و ما الفرق بينها و بين الفضيل العقلية؟
الإحالات والهوامش
[2] – أرسطو، “المصدر السابق”، المقالة السادسة، الفقرة الثانية، ص 208.
[3] – المصدر السابق، ترجمة أحمد لطفي السيد، الجزء الثاني، الكتاب السادس،الباب الأول، الفقرة الثانية عشرة، ص 117.
[4] – المصدر السابق، ترجمة إسحاق بن حنين، المقالة السادسة، الفقرة الثالثة، ص211.
[5] – المصدر السابق، المقالة السادسة، الفقرة الخامسة، ص 214.
[6] – المصدر السابق، ص ص2015-2016.
[7] – نفس المصدر، ص 2016.
[8] – المصدر نفسه، الفقرة السابعة، ص 217.
[9] – المصدر السابق، المقالة السادسة، الفقرة الثالثة عشرة، ص226.